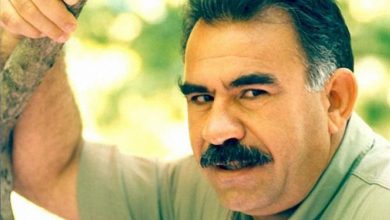السلطة و الادارة و الدولة – نظرية و اصطلاحا


تمهيد
من الصعبِ صياغةُ تفسيراتٍ مفعمةٍ بالمعاني في علمِ الاجتماع، من دونِ تعريفِ المصطلحاتِ والنظرياتِ الأساسية المستخدَمة فيه. علماً أنه لَم يتمّ الإجماعُ بعدُ على تعريفٍ لعلمِ الاجتماعِ ذاتِه. ولن يكونَ معقولاً بذلُ الجهودِ والبحثُ عن الجزمِ في حقلِ علمِ الاجتماع، في الحين الذي تعاني فيه العلومُ بجميعِ حقولِها من الأزمة. ما يَلزمُ أساساً هو التعريفُ السليمُ للظاهرةِ الاجتماعية. فأنشطةُ معرفةِ المجتمعِ تتميزُ بإرثٍ زهيدٍ أكثر مما يُظَنُّ في حقلِ المعنى. حيث نواجِهُ مفارقةً من قبيلِ الغَوصِ في مزيدٍ من الجهالةِ كلما زادَت المساعي لتعريفِ المجتمع. فبقدرِ ما يلعبُ المجتمعُ دوراً مصيرياً في تطوُّرِ الفردِ الإنسان، فهو يُعَدُّ بالمِثل حجرَ عثرةٍ على دربِ تطوُّرِه أيضاً. هذه هي المفارقةُ الاجتماعية. فالفردُ الذي يُزعَمُ أنّه حرٌّ في ظلِّ الليبراليةِ المُعَزِّزةِ للفردية، والفردُ الذي كَبَّلَته الجماعيةُ بقيودٍ وثيقة، هما فردان مُشَوَّهان بمعايير متماثلة، ومَقصِيّان من الحياةِ بصفتِهما منفردَين بذاتِهما. ومن غيرِ الممكنِ تعريفُ المجتمعِ اعتماداً على هكذا أفرادٍ مَرضى. كم هو مؤسفٌ حقاً أنّ البشريةَ لَم تتخلصْ حتى يومِنا الحاليّ من تأثيرِ هاتَين الحالتَين. من هنا، فمدى القدرةِ على سلوكِ العلمِ وإنتاجِه بهذه المفارقةِ الاجتماعية، موضوعُ جدالٍ وسجالٍ إلى آخرِ درجة. ذلك أنّ الذكاءَ الذي يُعَدُّ شرطاً أولياً للتمكنِ من مزاولةِ العلم، لن يستطيعَ تحقيقَ قفزتِه، إلا بالتعبيرِ عنه من خلالِ المجتمع. إلا أنه يتمُّ قطعُ طريقِه بَعد خطوِ خطوةٍ إلى الأمامِ على يدِ هذا الكيانِ الاجتماعيّ. بالتالي، تبقى ظاهرةُ الحقيقةِ نِسبيةً إلى آخرِ حد. وفي هذه النقطةِ بالذات، فإنّ الإنسانَ ذا الذكاء الغائص في العقائدِ أو الأفكار الأكثر تصَلُّباً، يغدو مخلوقاً بليداً وذا وعيٍ خاطئٍ لدرجةٍ تَفُوقُ ما هي عليه أكثرُ الكائناتِ الحيةِ تخلفاً. ولدى التفكيرِ بمدى استفحالِ المجتمعِ الدوغمائيّ، فإنّ نسبيةَ العلمِ تفرضُ وجودَها بدرجةٍ ملحوظة.
إلى جانبِ استحالةِ تجاوُزِ هذه المفارقةِ الاجتماعيةِ كلياً، فمن الممكن تخَطّيها ولو بحدود، والوصولُ بذلك إلى مستوى المعرفة. وفي هذه الحال، فقد يَكُونُ الوصول إلى أقصى درجاتِ المعرفةِ بصددِ الحياةِ نفسِها أمراً ممكناً. فالحياةُ من حيث هي طبيعةٌ مُدرِكةٌ لذاتِها، قد تَجعلُ الموتَ بلا معنى. ولدى تساؤلِنا “متى يتوقفُ أو ينتهي صراعُ التوالدِ والمَأكلِ والمَأمنِ لدى الكائناتِ الحية؟”، فالجوابُ الأكثر حِكمةً يتجسدُ في إشارتِنا إلى أنّ ذلك يكمنُ في الإنسانِ باعتبارِه “الطبيعةَ المُدرِكةَ لذاتِها”. وبإمكانِنا تسميةُ ذلك بالكونيةِ النهائية. بالرغمِ من الاعتقادِ بوقوعي في ذاتيةٍ مُفرطة، إلا أنه يُمكنني القولُ أنّ كلَّ ما يُرى ويُدرَكُ ويُحَسُّ هو محدودٌ بالإنسانِ باعتبارِه كياناً متسماً بالنسبية. بالتالي، فمدى نجاحِ الطبيعةِ المدرِكةِ لنفسِها على هذا النحو في تمثيلِ الكونية، هو موضوعُ جَدَلٍ إلى حدٍّ ما. ولكنّ وجودَ كونيةٍ خارجَ نطاقِ “الإنسانِ بوصفِه طبيعةً مدرِكةً لذاتِها” هو أيضاً موضوعُ سِجالٍ محتدم. وبالإمكانِ القولُ إنّنا وَقَعنا مرةً أخرى في مفارقةٍ بالقولِ أنه: بقدرِ ما يَكُونُ الكونُ الكامنُ خارجَ حدودِ عقلِ الإنسانِ –الذي يُعتَبَرُ اختصاراً لجميعِ كائناتِ العالَمِ– موضوعَ جَدَل، فإنّ مدى تمثيلِ عقلِ الإنسانِ للكونِ أيضاً هو موضوعُ جَدَل. لكنّ كاملَ نطاقِ الحقيقةِ مُؤَطَّرٌ ومُحاطٌ بهذه المفارقة. النتيجةُ التي يجبُ استخلاصُها هنا، هي الطابعُ النسبيُّ للمعرفة، وعلاقتُه الوثيقةُ بالطبيعةِ الاجتماعية. بناءً عليه، لا يُمكن تجاوز الأزمةِ المستفحلةِ في عالَمِ العلم، إلا بالتركيزِ على الطبيعةِ الاجتماعية، وبعقدِ أواصرِها مع الطبيعتَين الأولى والثالثةِ بنحوٍ صحيحٍ وأخلاقيٍّ وجماليّ، وبمنوالٍ نسبيٍّ أيضاً.
المدنية:
غالباً ما يُعَرَّفُ مجتمعُ الثقافةِ العامة، الذي تَشَكّلَت فيه الطبقةُ والمدينةُ والدولة، بأنه مجتمعُ المدنية. ذلك أنّ الطبقةَ والمدينةَ والدولةَ هي تصنيفاتٌ أوليةٌ لمجتمعِ المدنية. أي أنّ المجتمعَ هنا هو مجتمعٌ متمايزٌ طبقياً ومتمدنٌ ومتدول. وبمنوالٍ ملموسٍ وتاريخيٍّ للتطور، فإنّ ظاهرةَ التمايُزِ الطبقيِّ البارزةَ في المجتمعِ الكلانيِّ والقَبَلِيِّ المُفعَمِ بالمساواة، وظاهرةَ التمدنِ المتأسسةَ على خلفيةِ مجتمعِ الزراعةِ – القرية، وظاهرةَ التدولِ المنبثقةَ من أحشاءِ المجتمعِ الهرميّ؛ جميعُها تَقومُ بتوصيفِ المدنية. ويتجلّى مجتمعُ المدنيةِ بشكلٍ ملموسٍ كلما تطوَّرَت علاقةُ التحكمِ الأحاديِّ الجانب ضمن الطبيعةِ الاجتماعية، وكلما اتَّخَذَت حالةَ تناقضٍ محتدمٍ طردياً جنباً إلى جَنبٍ مع العلاقةِ التكافليةِ المبنيةِ على المجتمعِ–الطبيعة. وهكذا تُطَوِّرُ المدنيةُ كينوناتٍ بُنيويةً ومعانٍ وأحاسيسَ خُلُقِيةً وجماليةً مغايرة في المجتمع. هل المدنيةُ تطورٌ إيجابيٌّ أم سلبيٌّ بالنسبةِ للمجتمع؟ إنه موضوعُ سجالٍ مفتوح. فعلى صعيدِ مُشَيِّدي التاريخِ من وجهةِ نظرِ الشرائحِ المهيمنةِ والمستعمِرة، تُعَدُّ المدنيةُ تطوراً تاريخياً عظيماً، بل هي التاريخ بعَينِه. في حين أنها تُعَدُّ كارثةً مُفجِعةً وفقداناً ليوتوبيا الجنةِ من جهةِ الذين يُعَرِّفون أنفسَهم بالشرائحِ المُعَرَّضة للقمعِ والاستغلال. وهذا هو الصحيح. من هنا، فمن دواعي الطبيعةِ الاجتماعية أنْ يظهرَ التبايُنُ في الفكرِ والخُلُقِ والعواطفِ الجماليةِ في مجتمعٍ يُعاني هذا التناقضَ في الصميم. كما أنّ نشوءَ عالَمِ المؤسساتِ والمعاني المتجزئة والمتناقضةِ هو من دواعي المدنية. وغالبا ما تشيرُ الحروبُ إلى هذه الحقيقة. في حين أنّ وجودَ ممارساتٍ اجتماعيةٍ يُعاشُ فيها الإفناءُ الجسديُّ بكثافة كالحربِ مثلاً، لا يُمكِنُ إلا أنْ يُعَبِّرَ عن مجتمعٍ متجزئٍ حتى أعماقِه. أما تَجَزُّؤُ المعنى، فَيُعَبِّرُ عن الحربِ الأيديولوجية، التي تُفيدُ بدورِها بحربِ هيمنةٍ تؤثرُ (بأقلِّ تقدير) بما يُعادِلُ الحربَ الجسديةَ المُعاشةَ بكثافةٍ ضمن مجتمعِ المدنية. وبينما يَبسطُ الطرفان المتصارعان في مجتمعِ المدنيةِ فوارقَهما التي تُمَيِّزُهما عن بعضِهما بعضاً عن طريقِ الحروبِ الأيديولوجيةِ والجسديةِ والمؤسساتيةِ من جهة، فإنّ كِلَيهما لا يتوانيان من الجهةِ الثانيةِ عن التعبيرِ عن الذات ككُلٍّ متكاملٍ من البنى والمعاني الأساسيةِ التي تقتضي بدورِها الهيمنةَ والسيرورة. بل ويَزعَمُ كلٌّ منهما أنّ المجتمعَ الحقيقيَّ يتكونُ منه هو، وأنّ المجتمعَ يُصَيِّرُ نفسَه وجوداً بهذه الشاكلة. وتظلُّ الحقيقةُ الرئيسيةُ للمدنيةِ على هذا المنوال، مهما تَسَتَّرَت في دواخِلها بمراحل مختلفة، ومهما تجسدَت في مؤسساتٍ مختلفةٍ أو تقمَّصَت معانيَ متغايرة.
الظاهرةُ الأساسيةُ التي تُلاحَظُ أثناء تصاعُدِ مجتمعِ المدنية، هي ابتلاعُه طردياً للمجتمعِ الذي تنامى بين طواياه، وصَهرُه إياه داخلَ أجهزةِ العنفِ والاستغلال، وقيامُه تأسيساً على هذه الظاهرةِ بتفكيكِ وتدميرِ العلاقةِ الأيكولوجيةِ التكافليةِ القائمةِ مع الطبيعةِ الأولى مُحَوِّلاً المجتمعَ إلى مَصدرٍ للموارد، واستثمارُه تدريجياً حتى النهاية. التساؤلُ المطروحُ في هذه الحالة هو: “هل سيتبعثرُ المجتمعُ بالتناقضاتِ الداخليةِ أم بالتناقضاتِ الأيكولوجية؟”. وقد باتَ هذا سؤالاً مرحليّاً قائماً. والصحيحُ هو أنه لا يُمكنُ للطبيعتَين الأولى والثانيةِ أنْ تتَجَنّبا معاناةَ الكوارثِ الكبرى في ظلّ هيمنةِ التناقضَين معاً، في حالِ عدمِ حصولِ تحوُّلٍ إيجابيٍّ جذريٍّ في المدنية. أما التقييماتُ التي تَذهبُ إلى القولِ باستحالةِ عيشِ المجتمعاتِ بلا مدنية، والتي تَنظرُ إلى المجتمعاتِ المتحضرةِ على أنها مجتمعاتٌ ثريةٌ ومنيعة؛ فهي تقييماتٌ أيديولوجية، وغالباً ما تَعكسُ براديغما النخبةِ الاحتكاريةِ التَّحَكُّميةِ الاستعمارية. فكافةُ الأوساطِ العلميةِ ذات السيادةِ تُقَيِّمُ المستوى الذي بَلَغَه التمايُزُ الطبقيُّ والتمدنُ والتدول على أنه سرطانٌ اجتماعيّ (السرطانُ الجسديُّ متعلقٌ بهذه الواقعة). وثمة مؤشراتٌ جمّةٌ في هذا الشأن. فالتسلحُ النووي، ودمارُ البيئة، البطالةُ البنيوية، المجتمعُ الاستهلاكيّ، التضخمُ السكانيُّ المفرط، السرطانُ البيولوجيّ، الأمراضُ الجنسية، والإباداتُ المتزايدةُ هي بضعةُ مؤشراتٍ أولية. بناءً عليه، فالحضارةُ أو العصرانيةُ الديمقراطيةُ تُصبحُ مع الزمنِ بديلاً كسبيلٍ للنفاذ، نظراً لإخراجِها المدنيةَ المتناقضةَ والسرطانيةَ السائدةَ من طابعِها التسلطيِّ والاستعماريّ، ولإطرائِها التحولَ عليها. بالتالي، وعوضاً عن تقييمِ انهيارِ المدنيةِ القديمةِ على أنه انهيارٌ للبشريةِ قاطبة، فإنّ الصحيحَ هو النظرُ إلى ذلك على أنه تصاعُدٌ للحضارةِ الديمقراطيةِ كي تأخذ المنزلةَ الرئيسية. ومن الأهميةِ بمكانٍ الإدراكُ في هذه الحالةِ بأنّ الثقافاتِ الاجتماعيةَ أكثرُ رسوخاً وسيرورة، وأنها تملكُ القدرةَ على إحداثِ التبايُنِ والتطورِ في المدنيات وإطراءِ التحولاتِ الجذريةِ عليها. من هنا، فدعكَ من تقييمِ انهيارِ المدنيةِ في مجتمعٍ ما كخسارةٍ جذرية، بل ينبغي الحكمُ عليه كتطورٍ إيجابيٍّ إلى آخرِ حدّ، فيما إذا فتحَ المجالَ أمام تطوُّرِ الثقافةِ بنيةً ومعنىً. ولَئِنْ مَهَّدَ الطريقَ أمام تحوُّلِ المدنية، فبإمكاننا تفسيرُ هذا التطورِ على أنه تحررٌ جذريٌّ وبلوغٌ إلى الحياةِ الحرة.
السلطة:
يتصدرُ مصطلحُ السلطةِ لائحةَ المصطلحاتِ المتضاربة، والمؤديةِ إلى الأخطاء، والمتسببةِ بأكثرِ المشقاتِ لدى تحليلِ الواقعِ الاجتماعيّ؛ وكأنه يُعانِدُ صياغةَ تعريفٍ واضحٍ له شكلاً ومضموناً. ويَنعكِسُ ذلك على تعريفِ الحاكميةِ الكامنةِ في طبيعتِه، ويُعانِدُ صياغةَ تعريفٍ واقعيٍّ له، فلا يُبرِزُ ذاتَه بوضوح. إذ يَبدو وكأنه ظاهرةٌ حياديّةٌ ولكنْ لا يُمكنُ الاستغناءُ عنها. كما يُعَمِّمُ ذاتَه، ويُصَيِّرُها مُطلقةً بحيث تكادُ تصبحُ إلهية. من هنا، فالأصحُّ هو تعريفُ السلطةِ الاجتماعيةِ بكونِها استغلالاً اقتصادياً مُرَكَّزاً وإمكانيةَ قوةٍ مُكَثَّفة (طاقة كامنة). وهكذا فإنّ السلطةَ التي أصبحَت وكأنها ذات طابعٍ جينيٍّ في كلِّ البؤرِ البنيويةِ والعقليةِ للمجتمع، تُقدّم الإمكانياتِ للاستغلالِ والقوةِ المتراكمَين. في حين إنّ القوى الاجتماعيةَ المستوليةَ على آليةِ هذه السلطةِ تُشَكِّلُ الدولةَ التاريخيةَ العينيةَ ونُخَبَها الاستغلاليةَ وطبقاتِها. لذا، من عظيمِ الأهميةِ إضفاءُ المعنى على السلطةِ من حيث كونِها طاقةً احتياطيةً كامنةً لكياناتِ الطبقةِ والدولة. أما السلطةُ التي تتجسدُ طاقتُها الكامنةُ بشكلٍ ملموس، فإنها تُشَكِّلُ دولةً ما بطبقتِها الاستغلاليةِ الاجتماعيةِ التي ترتكزُ إليها نُخَبُها الحاكمة (العبودية، الإقطاعية، البورجوازية وما شابه). كما وبالإمكانِ التفكيرُ في السلطةِ من حيث هي طاقةٌ كامنةٌ لقوةٍ جسديةٍ وفكرية. الدافعُ المهم الآخرُ لفرضِ السلطةِ نفسَها على المجتمعِ وكأنها ضرورةٌ حتميةٌ ولازمةٌ باستمرار، يتمثلُ في المطابقةِ بين وجودِها وبين الحاجةِ إلى الإدارةِ المجتمعيةِ الطبيعية. أي أنّه يغدو لا غنى عن السلطةِ لمطابقتِها ذاتَها مع ظاهرةِ الإدارة. في حين سيُرى أنّ السلطةَ تتسللُ إلى البنيةِ الاجتماعيةِ كوَرَمٍ سرطانيّ، إذ ما تمَّ تمييزُها عن قيادةِ المجتمعِ الطبيعيّ.
من الأهميةِ أيضاً ملاحظةُ الفارقِ بين السلطةِ والدولة. فرغمَ انتشارِ السلطةِ في المجتمعِ وتغلغُلِها في كافةِ مساماتِه بدرجةٍ أكبر، إلا أنّ الدولةَ تُعَبِّرُ عن هويةِ السلطة الأكثر ضيقاً وذاتِ ضوابط ملموسة. بمعنى آخر، فالدولةُ شكلٌ من أشكالِ السلطةِ الخاضعةِ لرقابةٍ أكبر، والمرتبطةِ بالقواعد، والمتحولةِ إلى قانون، والتي تُبدي عنايةً فائقةً لشرعنةِ ذاتِها. وبينما تُقَيَّمُ السلطةُ كحالةِ نفوذٍ عامّ، فإنه بالمستطاعِ الحكمُ على اللاسلطةِ كحالةِ عبوديةٍ عامة. واختلافُ أشكالِ السلطةِ والعبوديةِ متعلقٌ بالمزايا العامةِ للدولة، إذ تنتهلُ غَيضَها من فَيضِها. لذا، بالوِسعِ الحكمُ عليها أيضاً بأنها مضادةٌ للحرية. فبقدرِ تواجُدِ كُمونِ السلطةِ في المجتمع، فإنّ غيابَ الحريةِ يَسُودُ بالمِثل. وبقدرِ التقليلِ من السلطة، فإنّ وضعَ الحريةِ يُحقِّقُ التطورَ بالمِثل. لذا، ينبغي الانتباه جيداً للحنينِ إلى السلطةِ بين صفوفِ المجتمع. فبقدرِ استفحالِه يتكاثرُ المستبِدّون الاجتماعيون الصغارُ بالمِثل. وهذا ما يؤولُ إلى استهلاكِ الديمقراطيةِ تماماً. ولا مناصّ من تحوُّلِ الاستبداديةِ التي هي مَرَضٌ سلطويٌّ إلى عملاقٍ مارد، في حالِ تَمَلُّصِها من الرقابةِ وتحرُّرِها من قيودِها، مثلما لوحِظَ في مثالِ هتلر. إنّ الاستبداديةَ البارزةَ تاريخياً في هيئةِ حُكمٍ مِزاجيّ، والتي تَسودُ كأورامٍ اجتماعيةٍ فاشية؛ تتضخمُ بسرعةٍ في سياقاتِ السلطةِ الرأسمالية، مستشريةً في جميعِ المساماتِ الاجتماعية، ومتجسدةً في حُكمِ قوةٍ توتاليتاريةٍ ضمن المجتمع. أما شكلُ السلطةِ من طرازِ الدولةِ القومية، فله أواصرُه مع النظامِ الرأسماليِّ–الفاشيّ، مُعَبِّراً بذلك عن وضعِه الأولويّ.
الإدارة:
التعريفُ الصحيحُ لظاهرةِ الإدارةِ مهمٌّ على صعيدِ تلافي السلبياتِ وقِصَرِ النظرِ الناجمِ من ظاهرةِ السلطة. الإدارةُ أيضاً كما الثقافة، ظاهرةٌ مستداماً كما الثقافة، ظاهرةٌ مستمراقضة ةٌ في المجتمع. وإذا عَمَّمنا أكثر، فهي تُعادِلُ الرقيَّ الدماغيَّ على المستوى الكونيّ، وتَرَكُّزَ الحالةِ العصبيةِ ضمن الكونِ البيولوجيِّ بصورةٍ خاصة. وتُعبِّر الإدارةُ عن حالةِ الانتظامِ في الكونِ وعن حالةِ الهربِ من الفوضى. والوضعُ الراقي لطبيعةِ المعنى ذاتِ الذكاءِ المرنِ في المجتمع، يقتضي بدورِه رقيَّ القدرةِ على الإدارة. من الممكنِ تسميةُ الإدارة على أنها “العقل المجتمعيّ”. ومن المهمِّ في هذه الحالةِ تحليلُ مصطلحَي الإدارةِ الذاتيةِ والإدارةِ الدخيلة. فبينما تَقومُ الإدارةُ الذاتيةُ بتنظيمِ القُدُراتِ الكائنةِ في طبيعتِها الاجتماعيةِ ومراقبتِها، وتُؤَمِّنُ بالتالي سيرورةَ المجتمع، وتَضمَنُ مَأكلَه ومَأمَنَه؛ فإنّ الإدارةَ الدخيلةَ “تُشَرعِنُ نفسَها” كسلطة، وتعملُ على إغواءِ المجتمعِ المُسَلَّطةِ عليه (تحاولُ نثر دماغه)، لتَقدِرَ بالتالي على حُكمِه بعدَ تحويلِه إلى مستعمَرة. من هنا، فالإدارةُ الذاتيةُ تتمتعُ بأهميةٍ مصيريةٍ بالنسبةِ لمجتمعٍ ما. وكيفما يستحيلُ على مجتمعٍ يفتقرُ إلى الإدارةِ الذاتيةِ أنْ يتجنبَ التحولَ إلى مستعمَرة، فلا مفرَّ من فنائِه وزوالِه ضمن سياقِ الصهرِ والإبادةِ كمَآلٍ طبيعيّ.
تُمَثِّلُ الإداراتُ الدخيلةُ على جوهرِ المجتمعِ أكثرَ أشكالِ السلطةِ طغياناً واستعماراً. بناءً عليه، فالمَهَمَةُّ الأخلاقيةُ والعلميةُ والجماليةُ المصيريةُ والأهمّ على الإطلاقِ بالنسبةِ لمجتمعٍ ما، هي بلوغُه قوةَ الإدارةِ الذاتية. ومثلما لا يُمكنُ لمجتمعٍ قاصرٍ عن النجاحِ في هذه المَهَمَّةِ أنْ يتطورَ أخلاقياً وعلمياً وجمالياً، فإنّ تطورَه وطابعه المؤسساتيّ السياسيَّ والاقتصاديَّ أيضاً يَزول. المهمُّ هنا هو منعُ كفاءةِ الإدارةِ من الانتقالِ بذاتِها نحو شكلِ السلطةِ من جانب، وتَصَدّيها حتى آخرِ رمقٍ تجاه اللاإدارةِ من الجانبِ الآخر. وبقدرِ أهميةِ عدمِ تحويلِ الإدارةِ إلى سلطة، فإنّ انتزاع امتيازاتِ الإدارةِ من يدِ السلطةِ أيضاً يتحلى بأهميةٍ كبيرة. وبقدرِ ما تُعَدُّ السلطةُ مناهِضةً للمجتمعية، فإنّ الإدارةَ كفاءةٌ وقوةٌ مجتمعيةٌ بالمِثل. ومن دونِ القوةِ الاجتماعية، لن يحصلَ التطورُ الأخلاقيُّ والجماليّ والعلميّ. هكذا، وفي حالِ غيابِ التطورِ الثقافيِّ بمعناه الضيق، فلن يحصلَ التطورُ الاقتصاديُّ والسياسيُّ أيضاً بالمعنى الواسع. وما سيُعاشُ في هذه الحالة، هو الفناءُ نتيجةَ الاستعمارِ والصهرِ والإبادة.
بقدرِ ما يَكُونُ حُكمُ السلطةِ مناهِضاً للديمقراطيةِ في المجتمع، فإنّ الإدارةَ الذاتيةَ مرتبطةٌ بالدرجةِ نفسِها بالإدارةِ الديمقراطية. وبقدرِ ما تُعَبِّرُ أشكالُ حُكمِ السلطةِ المَحضِ عن التضادِّ مع الديمقراطيةِ وعن إقصاءِ المجتمعِ عن الإدارة، فإنّ الإداراتِ الذاتيةَ تدلُّ على التحولِ الديمقراطيِّ بقدرِ إشراكِ المجتمعِ في الإدارة. وفي هذه الحال، يمكنُ تعريفُ الديمقراطيةِ على أنها الإدارةُ الذاتيةُ التي يُشارِكُ فيها المجتمع. ونظراً لاهتمامِ الإداراتِ الذاتيةِ بالمجتمعِ دوماً، فإنّ الديمقراطيةَ موجودةٌ في طبيعتِها، بحُكمِ استحالةِ التفكيرِ في عدمِ مشاركةِ المجتمعِ فيها. وبينما يتمُّ تصوُّرُ الديمقراطيةِ بالأغلبِ على أنها مصطلحٌ معنيٌّ بالمجتمعاتِ الكبرى كالشعوبِ والأمم، فإنّ الإداراتِ الذاتيةَ تشيرُ إلى الكفاءةِ أو القوةِ المستدامةِ التي تنتشرُ من أصغرِ المجتمعاتِ الكلانيةِ إلى أوسعِ المجتمعاتِ الوطنية. ويأتي عجزُ علمِ الاجتماعِ عن تحليلِ الخلطِ بين السلطةِ والإدارةِ في مقدمةِ الأزماتِ أو الإشكالياتِ المهمةِ جداً التي يعاني منها. وهذا ما أبقى بدورِه على جميعِ التحليلاتِ البنيويةِ والعقليةِ والمواقفِ التاريخيةِ تتخبطُ في الفوضى، مُطيلاً بذلك من عُمرِ الأزمة. والنتيجةُ هي ابتلاعُ السلطةِ لكلِّ المجتمعِ والبيئة، وإفراغُها الديمقراطيةَ من جوهرِها مختزلةً إياها إلى قِشرةٍ جوفاء، واختزالُ ذاتِها إلى شكلٍ صُوريٍّ متكررٍ بلا جدوى. لذا، لا يُمكنُ تخطّي أزمةِ الحقلِ العلميِّ وبالتالي الأزمةِ الاجتماعيةِ بوصفِها كينونةً بنيويةً وكينونةَ معنى؛ ما لَم يَقُمْ علمُ الاجتماعِ بتحليلِ مصطلحَي السلطةِ والإدارةِ الديمقراطيةِ بعدَ وضعِهما في مِحورِ اهتماماتِه، وما لَم يَقُمْ ارتباطاً بذلك بتعميمِ الحلِّ على التاريخِ والعلومِ الأخرى.
السلطة المهيمنة المركزية:
ينبغي وجودُ تعريفٍ نظريٍّ للسلطةِ المهيمنةِ المركزية، كونَها مصيريّةً بالنسبةِ لموضوعِنا المِحوريّ. فالنظريةُ الرئيسيةُ القادرةُ على تنويرِ كيفيةِ استدراجِ شعبٍ إلى حافةِ الإبادةِ العِرقية، هي نظريةُ السلطةِ المهيمنةِ المركزية. ونظراً لتعريفِ مصطلحِ السلطةِ كفايةً، فمن الأهميةِ بمكان تبيانُ كيف تقوم السلطةُ بإقحامِ المجتمعِ بين فكَّيها خلال التطورِ التاريخيّ. يجب أولاً تبيان الطابعِ المهيمنِ للسلطةِ بشكلٍ جيد. فبُؤَرُ السلطةِ مُرغَمةٌ بالضرورةِ ومنذ ولادتِها على الدخولِ في تنافسٍ عتيدٍ فيما بينها، ليتحولَ ذلك مع الزمنِ إلى حروبٍ ضارية. في البدايةِ ترمي السلطاتُ من شنِّ الحروبِ إلى إفناءِ بعضِها بعضاً للتحولِ إلى مَنْليثيةٍ[1] عملاقة. ولدى الإدراكِ بعد فترةٍ أنّ هذا محالٌ ولا فائدة تُرجى منه، تُجمِعُ مراكزُ السلطاتِ الأخرى على أنّ الانضواءَ تحت سيادةِ مركزِ السلطةِ الأقوى هو أهوَنُ الشرَّين. فضلاً عن أنّ الحركاتِ المناهِضةَ للسلطة، والتي تنبثقُ دوماً من القاعِ والخارج، تَجعلُ التحالُفَ أمراً لا بدَّ منه بين أصحابِ السلطةِ الشركاء في ظلِّ سلطةٍ مهيمنةٍ واحدة (متحكم، قائد رئيسيّ). السلطاتُ المحضةُ استثنائيةٌ في التاريخ. أما القاعدة، فهي الطابعُ المهيمنُ للسلطة. والسلطةُ المركزيةُ يجب إتمامُها بالمركزِ الاقتصاديِّ بكلِّ تأكيد. ذلك أنّ تكاثُفَ السلطةِ المركزيةِ على عُرىً وثيقةٍ مع المركزِ الذي يَسُودُه التكاثفُ الاقتصاديُّ الرئيسيّ. ولدى قيامِ الاقتصادِ المركزيِّ بترسيخِ نظامِه عبر التوسعِ نحو الأطرافِ على موجاتٍ متتالية، فمن الضروريِّ أنْ يَنقلَ ذلك بالتداخُلِ مع توسعِ السلطةِ المركزية. وبحُكمِ كونِ السلطةِ المركزيةِ بذاتِ نفسِها بنيةً اقتصاديةً مُرَكَّزةً وطاقةً اقتصاديةً كامنةً هي الأقوى على الإطلاق، فإنها تَقومُ بتنشيطِ الاقتصادِ مرحلياً، ناشرةً إياه من المركزِ صوب الأطراف. ويُبَدِّلُ المركزُ والأطرافُ مكانَيهما ببعضِهما بعضاً على الدوام، حسبَ التكونِ الأعظميِّ للمَكسَبِ ولتراكُمِ رأسِ المال. وهذا الوضعُ بدورِه يجعلُ من المراحلِ المسماةِ بالأزماتِ أمراً لا مهرب منه.
إذن، والحالُ هذه، فالأطرافُ والأزمةُ بمثابةِ السماتِ الأوليةِ التي لا غنى للسلطةِ والاقتصادِ المركزيَّين عنها. إذ لا داعي لتغييرِ المركز، ما دام النظامُ مُثمِرٌ في عملِه. لكن، ومثلما شوهِدَ في التاريخِ بالأغلب، فإنّ قوةً منتجةً من المحيطِ تَقومُ بانطلاقتِها بالاستفادةِ من تداعياتِ الأزمةِ الناجمةِ عن التَطَفُّلِ المتزايدِ للمركزِ مع مُضِيِّ الزمن. وتُحقِّقُ وثبتَها هذه بإنجاحِ اقتصادِها أكثر من خلالِ تطبيقِ تكنولوجيةٍ حديثة. والتكنولوجيا الحديثةُ تعني تقنيةً عسكريةً جديدة. وتَبَدُّلُ أماكنِ السلطةِ في هكذا فتراتٍ تاريخيةٍ حاسمة، ينتهي بتكوُّنِ مراكز وأطرافٍ جديدة. وتتأسسُ هيمنةُ السلطةِ مُجدَّداً. ولَطالما يُصادَفُ تَكَوُّناتٌ سلطويةٌ مهيمنةٌ كهذه في التاريخ، تتصاعدُ بطليعةِ قومٍ جديدٍ أو سلالةٍ جديدة. والفصلُ بين الاقتصادِ والسلطةِ من حيث التأثيرِ الحاسمِ والمُعَيِّن، أمرٌ ليس ذا معنى هنا. ذلك أنه، وكيفما يستحيلُ على أيةِ سلطةٍ مهيمنةٍ العملُ من دون مركزٍ اقتصاديّ، كذا يستحيلُ على أيِّ مركزٍ اقتصاديٍّ أنْ يُعَزِّزَ نفسَه على المدى الطويلِ أو بنحوٍ دائمٍ، دون التوجهِ صوب إنشاءِ سلطةٍ مهيمنةٍ مركزية.
الظاهرةُ الأخرى المهمةُ جداً على الصعيدِ التاريخيِّ ارتباطاً بالسلطةِ المهيمنةِ المركزية، هي أنّ هذا النظامَ يرتبطُ تسلسلياً بالنظامِ السلطويّ الذي يسبقه، ويتمتعُ بخاصيةٍ لا تَحتملُ الفراغَ أبداً، وأنه يجري كحلقاتِ السلسلة، لا كمجموعاتٍ منفصلةٍ زماناً ومكاناً. أي أنّ طبيعةَ السلطةِ المهيمنةِ لا تَقبَلُ أيِّ فراغٍ زماناً ومكاناً. بل ما هو قائمٌ هو الامتلاءُ الأعظم. أي أنّ الحلقاتِ متداخلةٌ ومتماسكةٌ بمتانة. ولَئنْ ما حصلَ فراغٌ أو انقطاع، تتبدى في الأفقِ احتمالاتُ انهيارِ المركز. وإذا لم تُعَمَّرْ أو تُملأْ الثغرةُ في زمانِها، يغدو لا ملاذ من الانهيارِ وتبديلِ المكان. هذا ويجب عدم التفكيرِ في السلطةِ المهيمنةِ المركزيةِ على أنها وضعٌ خاصٌّ بالإمبراطورياتِ الكبرى وحسب. حيث تدورُ المساعي لربطِ المجتمعِ بأكملِه بعلاقاتِ السلطةِ المهيمنة. وبدءاً من مركزِ أكبرِ الإمبراطوريات، وصولاً إلى وحدةِ الأسرةِ التي يَتبعُ لها؛ فالقواعدُ المهيمنةُ المماثلةُ تَسري عليها جميعاً. فما يَكُونُه الإمبراطورُ في روما، هو نفسُه ما يَكُونُه الآغا في القريةِ والزوجُ في الأسرة. من هنا، محالٌ فهمُ المجتمعِ التاريخيّ، في حالِ غضِّ الطَّرْفِ عن أنه منسوجٌ بهكذا عُرىً وروابط مهيمنة. قد يتواجدُ كمٌّ معرفيٌّ لدينا حينذاك، ولكن، لن يتحققَ الإدراكُ الدياليكتيكيُّ قطعياً.
لا تَقتصرُ السلطةُ المهيمنةُ المركزيةُ على الاقتصادِ فحسب، بل هي مُرغَمةٌ أيضاً على إكمالِ ذاتِها بالهيمنةِ الأيديولوجيةِ التي تُعادِلُ الاقتصادَ أهميةً بأقلِّ تقدير. إذ لا نفوذ لسلطةٍ تفتقرُ إلى الهيمنةِ الأيديولوجية. ونخصُّ بالذِّكرِ هنا الانطلاقاتِ الميثولوجيةَ والدينيةَ الأساسيةَ البارزةَ في سياقِ المدنية. فإما أنها مناهِضةٌ للهيمنة، أو أنْ يندمجَ جناحٌ منها على الأقلِّ مع السلطة، متحولاً بسرعةٍ إلى هيمنةٍ في غضونِ فترةٍ وجيزة. وتصاعُدُ الأديانِ التوحيديةِ خصيصاً بالتداخُلِ مع الهيمنةِ المركزية، أمرٌ مفيدٌ وتعليميٌّ إلى حدٍّ بعيد. فانطلاقاتُها على صِلةٍ مع الهيمنةِ المطلقة. فإما أنْ يَكُونَ مصطلحُ الربِّ أو اللهِ بديلاً للهيمنةِ الرئيسية، فيَغدو الدينُ في هذه الحالةِ معارِضاً ومقاوِماً؛ أو أنْ يصبحَ تقديساً وتأليهاً للهيمنةِ عينِها، ليغدوَ الدينُ في هذه الحالةِ انعكاساً للنظامِ المهيمنِ المركزيّ. هذا ويَسُودُ وضعٌ كثيفٌ جداً من الحياةِ والحربِ فيما بينهما، من حيث التجاذباتِ والتناقضات. لن نستطيعَ فهمَ تاريخِ الأديانِ التوحيدية، إلا بالنبشِ والتدقيقِ في تاريخِ السلطةِ المهيمنةِ المركزيةِ أيضاً. ولا يُمكنُ فهمُ تاريخِ الأديانِ بشكلٍ آخر. ذلك أنّ تاريخَ الأديانِ المنفصلَ عن السلطةِ والبنيةِ الاقتصادية، ليس إلا سفسطةً كبيرة. والعلاقةُ الكامنةُ بين الدين، الإله، الهيمنة، السلطة، والاقتصاد؛ أكثرُ كثافةً مما يُظَنّ. فكما أنّ السلطةَ المهيمنةَ تحيطُ بالزمانِ والمكانِ تسلسلياً، فالتاريخُ الحقُّ أيضاً مُحاطٌ بالدينِ والإلهِ والهيمنةِ والسلطةِ والاقتصادِ بمنوالٍ متداخل. والمجتمعُ التاريخيُّ يَصِلُ يومَنا الراهنَ متبدياً في هيئةِ هكذا إحاطاتٍ وحلقات.
بشكلٍ ملموس، وكما هو معروف، فهذا السياقُ الذي يبدأُ بالمَلِكِ الأكاديِّ سارغون كأولِ مهيمن، ويمتدُّ على شكلِ حلقاتٍ متسلسلة، ويستمرُّ في راهننا مع الولاياتِ المتحدةِ الأمريكيةِ التي هي مهيمنٌ مشابِهٌ لإمبراطوريةِ سارغون؛ هذا السياقُ هو أَشبَهُ بتدفُّقِ نهرٍ أُمٍّ على صعيدِ نظامِ المدنيةِ المركزية. يتكونُ النهرُ الأُمُّ من هيمناتِ سومر، أكاد، بابل، آشور، الحثيين، الميتانيين، أورارتو، ميديا، البَرسيين، الإسكندر، روما، الساسانيين، البيزنطة، الإسلام العربيّ، المغول الأتراك، العثمانيين، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية. في حين أنّ إمبراطورياتِ مصر، عيلام، هارابا، الصين، الهند، روسيا، الفرنجة، والجرمان هي بمثابةِ الفروعِ الجانبيةِ للنهرِ الأُمّ. من هنا، سوف يُستَوعَبُ المجتمعُ التاريخيُّ بنحوٍ واقعيٍّ أكثر، فيما إذا رُمِّزَ عينياً بالنهرِ الأمِّ وفروعِه الجانبيةِ الممتدةِ على طولِ تاريخِ المدنيةِ المركزية. لا ريب أنه لهذا النهرِ الأمّ ولفروعِه الجانبيةِ أنهارٌ أصغر تُشَكِّلُ فروعاً سفليةً وتعبِّرُ كلُّ واحدةٍ منها عن ثقافةٍ وحضارةٍ ما. المهمُّ هو الإدراكُ أنّ التطورَ التاريخيَّ ليس متقطعاً، وأنّ الهيمنةَ المركزيةَ كَوَّنَت عالَمنا الراهنَ بتعزيزِ وجودِها على الدوام، فيما عدا فتراتِ الانتقالاتِ البَينية. ما من شكٍّ في أنّ هذا التكوينَ ليس أحاديَّ الجانب. ففي الجانبِ الآخرِ أَنشَأت القوى المناهِضةُ للهيمنةِ وجودَها المستمرَّ منذ بدءِ انطلاقتِها ضد نظامِ المدنيةِ المركزيةِ وقواه المهيمنة، حاملةً القطبَ الآخرَ من العالَم، أي ناقلةً عالَمَ الحضارةِ الديمقراطيةِ إلى يومِنا الراهن. لذا، ما لا يَقبلُ الجدلَ هو أنّ الجوهرَ الأساسيَّ لهذا العالَمِ هو جوهرٌ ديمقراطيٌّ وأخلاقيٌّ وسياسيٌّ يُعَزِّزُ ويَستَحدثُ نفسَه باستمرار عن طريقِ الكونفدرالياتِ الديمقراطيةِ التي لا تنضب، وأنّ القوى المناهِضةَ للهيمنةِ تُنشِئُ عوالِمَها الأيديولوجيةَ في طوايا مذاهبِ الأديانِ عموماً والأديانِ التوحيديةِ خصوصاً، وأنها هي الصاحبُ الحقيقيُّ المنتِجُ للاقتصاد.
إنّ التاريخَ الانفراديَّ للدولِ القومية، والذي تَعمَلُ الحداثةُ الرأسماليةُ على بسطِه، عاجزٌ عن تغييرِ الحقيقةِ الكونيةِ للتطورِ العالميِّ التاريخيِّ المهيمنِ المركزيّ، مهما عمِلَت على قمعِه وطمسِه. ذلك أنه لا وجود للتاريخِ الانفراديّ من دونِ التاريخِ الكونيّ. أو بالأحرى، يتطورُ التاريخُ بتغذيةِ الانفراديِّ والكونيِّ بعضَهما بعضاً. ومن غيرِ المُستَطاعِ فهمُ تواريخِ الأممِ أو الطبقاتِ أو السلالاتِ الانفرادية، أو فهمُ التواريخِ الشخصية، دون مَوضَعَتِها ضمن روابطِها العالمية. أما الحداثةُ الرأسمالية، فبإعلانِها تاريخَها الليبراليَّ على أنه “نهايةُ التاريخ”، تَجهدُ لتكرارِ حيلةٍ تمّ اللجوءُ إليها في كلِّ عصورِ الهيمنةِ الكلاسيكيّة. إذ تُعلنُ كلُّ قوةٍ مهيمنةٍ عن نفسِها بأنها الأخيرة. لكنّ التاريخَ يستمر. لذا، لَربما أنّ المنتهيَ هو الحداثةُ الرأسماليةُ بذاتِها. حيث أنّ هذا النظامَ بات من حيث المضمونِ بلا معنى، نظراً لعدمِ بقاءِ أيِّ رابطٍ عينيٍّ له مع التاريخِ والمجتمعِ تزامُناً مع عصرِ رأسِ المالِ الماليِّ العالميّ. كما ويتحققُ تشرذُمُه من حيث الشكلِ أيضاً يوماً بعد يوم. وربما هي المرةُ الأولى في التاريخِ يَستهلكُ فيها النظامُ المهيمنُ المركزيُّ كلَّ قواه الاحتياطية، ليُصابَ بالتصدُّعِ البطيء، ويَدنوَ من نهايتِه وهو يتخبطُ في الأزماتِ دون انقطاع. لقد تمّ تخطيه جوهرياً في العديدِ من مناحيه. ويَسُودُ الفضولُ بشأنِ مدى صونِه نفسَه بالتحصنِ بقوالب مُدَرَّعة. أما الموضوعُ الخَليقُ بالبحثِ وباكتشافِ حقيقتِه؛ فهو التساؤل: هل يُخَلِّدُ هذا النظامُ وجودَه شكلياً بعدمِ الاعترافِ بالزمانِ والمكان، أم أنه يعيشُ مرحلةَ نفاذِه واضمحلالِه؟
السلطة والإدارة الديمقراطية:
يتحلى التمييزُ بين الشكلِ السلطويِّ وشكلِ شبهِ الاستقلالِ الديمقراطيِّ في ظاهرةِ الإدارةِ المجتمعيةِ بأهميةٍ مصيريةٍ أثناء تحليلِ القضايا الاجتماعيةِ الأولية. إذ لا مهربَ من عدمِ فاعليةِ كافةِ الحلولِ المُصاغة، في حالِ عدمِ التمييزِ والجزمِ بالفوارقِ الجذريةِ الكائنةِ بين براديغما النموذجَين الإداريَّين. وإذا لُم تُعَيَّن الإدارةُ المجتمعيةُ بحرية، فستتسمرُ كافةُ القضايا الأخرى في خضمِّ العُقمِ الإداريِّ لتُفرَغَ من فحواها في آخرِ المآل، بل وسيؤدي ذلك إلى ازديادِ وطأةِ القضايا. وإذا استدعى الأمرُ إعطاءَ مثالٍ تاريخيّ، فإنّ المقاربةَ الديكتاتوريّةَ السلطويّةَ من ظاهرةِ الحُكمِ قد أدت دورَها المُعَيِّنَ في إفلاسِ التجربةِ السوفييتية. وتتوارى الظاهرةُ عينُها في خلفيةِ الثوراتِ الفاشلةِ أيضاً. فحصيلةَ عجزِ رُوّادِها عن الانقطاعِ بأيِّ شكلٍ من الأشكال عن مفهومِ الحُكمِ السلطويّ، فإما أنّ تلك الثورات تَسَنَّمَت السلطةَ ففَسُدَت، أو أنها دَحَضَت ظاهرةَ الحُكمِ والإدارةِ كلياً، فانزلَقت صوبَ الفوضويةِ الفردية، لتُصَيِّرَ الهزيمةَ مآلاً لا مفرَّ منه. تنبعُ القضيةُ الاجتماعيةُ من اعتداءِ السلطةِ الهرميةِ والدولتيةِ على ظاهرةِ الإدارة. ذلك أنه، ومن دونِ تَعَرُّضِ الأخيرةِ للاعتداء والتحريفِ والتشويه؛ لا يُمكِنُ للإدارةِ الذاتية أنْ تتحقق في المجتمع. وحتى لو تحققت، فلن تتخلصَ من أنْ تَكُونَ مؤقتة؛ نظراً لعدمِ التَّمَكُّنِ من مَأسَسَةِ القمعِ والاستغلال. بمعنى آخر، تتأسسُ آلياتُ القمعِ والاستغلالِ الشاملَين على المجتمعات، بالتناسُبِ طرداً مع مدى تَحَقُّقِ اغتصابِ الإدارةِ والتعدي عليها. وهكذا تختنقُ جميعُ الظواهرِ الاجتماعيةِ في مستنقعِ القضايا الإشكاليةِ بما يُشبهُ فتحَ صندوقِ باندورا.
كان نظامُ المجتمعِ الطبيعيِّ الذي تَشَرذَمَ بالحُكمِ الهرميّ سيُواجِهُ القضايا الاجتماعيةَ الداخليةَ أيضاً، فضلاً عن القضايا التي تتسببُ بها الطبيعة. وكانت ستزدادُ وطأةُ القضايا طردياً في ثنايا الثقافةِ الماديةِ والمعنويةِ للمجتمع. فالنزاعاتُ المحتدمةُ بين الكلاناتِ والعشائر تُشيرُ إلى البُنيةِ الإشكالية. وما الأفكارُ الميثولوجيةُ والمصطلحاتُ الإلهيةُ المتنافرةُ في العالَمِ الذهنيِّ في مضمونِها سوى تعبيرٌ عن القضايا الاجتماعيةِ المتزايدة. بمقدورِنا رصدُ كلِّ هذه الظواهرِ في المجتمعِ السومريِّ بنحوٍ لافت. فالحربُ بين الآلهةِ ليست في حقيقةِ الأمرِ سوى إشارةٌ إلى تنافُرِ وصِدامِ المصالحِ بين السلالاتِ الهرميةِ المتصاعدةِ وحُكّامِ دولةِ المدينة. أما الاحتكاراتُ الاستغلالية لصراعاتِ السلطة، والتي برزَت خلالَ أعوام 5000–3000 ق.م في ميزوبوتاميا السفلى، والتي كانت ستَشهَدُها جميعُ مجتمعاتِ المدنية المتكونةِ لاحقاً؛ فكانت تُشَكِّلُ النماذجَ البِدئيةَ المصغَّرةَ للقضايا الاجتماعيةِ ولصراعاتِها الجذريةِ الكائنةِ وراء التناقضاتِ الطبقيةِ الناشبة بين المدينةِ والريف (البرابرة). وكانت ستُجَرَّبُ هنا أولى الأمثلةِ التي ستَظهرُ فيما بعد من جميع أشكالِ الصراعِ والوفاقِ الاجتماعيَّين، الصراعات الدولتية والطبقية، النزاعات الناشبة داخل وخارج المدينة، ومبادرات السلام.
إلى جانبِ أنّ الإدارةَ السلطويةَ هي التي خَرجَت فائزةً من ذاك السياق، إلا أنّ المجتمعَ لَم يتخلَّ قط عن رغبتِه في الإدارةِ الذاتية، بل صَعَّدَ دوماً من مطالبِه في الإدارةِ الذاتيةِ في وجهِ الحُكمِ السلطويّ. علماً أنّ العشائرَ والقبائل، التي هي أكثرُ أشكالِ المجتمعِ انتشاراً في التاريخ، قد عاشَت في جوهرِها الإدارةَ الذاتية، وفَضَّلَت أنْ تَكُونَ مجتمعاً رَحّالاً يَتجولُ دوماً في الجبالِ والبوادي والسهوب، على أنْ تذعنَ وتخنعَ للحُكّامِ السلطويين الغرباء. لقد وَضعَت التعرضَ للإبادةِ حتى النهاية نُصبَ العين، ولكنها لم تتراجعْ عن حقِّها في الإدارةِ الذاتيةِ كحاجةٍ أوليةٍ للطبيعةِ الاجتماعية. كانت العشائرُ والقبائلُ تعيشُ مُعَبَّأةً بالوعيِ العميقِ المُنتبهِ إلى أنّ التخليَ عن الإدارةِ الذاتيةِ يعني الأسرَ وفقدانَ الهوية. وما الظاهرةُ المسماةُ بمقاومةِ البرابرةِ ضد المدنِ في مضمونِها سوى حربُ المجتمعِ القَبَلِيِّ في سبيلِ صونِ هويتِه وعدمِ التخلي عن إدارتِه الذاتية. هذا وبالمستطاعِ ملاحظةُ هذه الظاهرةِ بنحوٍ واسعِ النطاقِ حتى يومِنا الحاليّ. فالمقاوماتُ والهجماتُ التي واجَهَها المجتمعُ السومريُّ على يدِ الآراميين الذين هم قبائلٌ صحراوية (القبائل العربية البدئية) غرباً، وقبائلِ الهوريين (الكرد الأوائل) شمالاً وشرقاً، يَرِدُ ذِكرُها في اللوحاتِ السومريةِ على شكلِ ملاحم ذات تعابير لافتة للنظر.
تتجسدُ قضيةُ الإدارةِ الذاتيةِ للمجموعاتِ العشائريةِ والقبائليةِ في هيئةِ قضيةِ الديمقراطية (وتعني في اليونانية “إدارة الشعبِ نفسَه بنفسِه”) خلال مراحلِ التحولِ إلى قومٍ أو مِلّةٍ أو شعب. يتوجب تعريفُ الديمقراطيةِ بصفتَين مهمتَين: أولاهما؛ احتواؤُها على التضادِّ مع مؤسساتيةِ وتدوُّلِ السلطةِ المسلَّطةِ على الشعب. ثانيتُهما؛ إضفاؤُها المزيدَ من التشاركيةِ على الإدارةِ الذاتيةِ المتبقيةِ من المجتمعِ التقليديّ، ومَأسَسَتُها لثقافةِ النقاشِ والاجتماعاتِ مُعَزِّزَةً إياها بتأسيسِ نموذجٍ مُصَغَّرٍ من البرلمان. تُحَقِّقُ الإدارةُ الذاتيةُ مشاركةَ جميعِ الوحداتِ المجتمعيةِ المعنيةِ بوصفِها شبهَ استقلاليةٍ ديمقراطيّة، وتُؤَمِّنُ مؤسساتيتها. هذا ونَعثُرُ في ديمقراطيةِ أثينا على المثالِ التاريخيِّ الملفتِ للنظرِ في هذا المضمارِ أيضاً باقتفاءِ أثَرِ الوثائقِ المدونة. لا تُعتَبَرُ ديمقراطيةُ أثينا تامة، كونَها لم تتخطَّ العبودية. لكنها لا تُعَدُّ دولةً أيضاً، كونَها لَم تَقبَل التدوُّلَ الذي في نموذجِ إسبارطة. هذا المثالُ اللافتُ للأنظارِ على صعيدِ الانتقالِ من الديمقراطيةِ التامةِ نحو الدولة، يَمُدُّنا بالعديدِ من العِبَرِ التي تَسري على يومِنا أيضاً بشأنِ الديمقراطيةِ الحقة. فالديمقراطيةُ المباشرة، أي انتخابُ الإدارةِ بالانتخاباتِ السنوية، وعدمُ امتلاكِ المنتَخَبين أيةَ امتيازاتِ تَفَوُّقٍ على الحَول، وظاهرةُ الإدارةِ المؤتمِرةِ بالديمقراطية، وثقافةُ الاجتماعاتِ التي تُؤَمِّنُ مشاركةَ المواطنين في النقاشاتِ السياسية، وبالتالي تُحَقِّقُ تعبئتَهم بالتدريب؛ كلُّ ذلك قِيَمٌ متبقيةٌ من إرثِ ديمقراطيةِ أثينا إلى راهننا. ولا ريب في وجودِ ثقافاتٍ ديمقراطيةٍ مثيلةٍ شَهِدَتها المجموعاتُ الأخرى، ولكنها لَم تُسكَبْ على الورق.
تَبسطُ التجاربُ التاريخيةُ التي سعَينا إلى دعمِها بالأمثلةِ الموجزة فوارقَ ظاهرةِ الإدارةِ الذاتيةِ والديمقراطية، ومدى انتشارِها. حيث تُعَرِّفُ الديمقراطيةُ نفسَها كشكلٍ إداريٍّ لا يتحولُ إلى سلطة، وبالتالي لا يُمهِّدُ السبيلَ أمام القضايا الاجتماعية، ولا يفتحُ المجالَ أمام ولادةِ القمعِ والاستغلال. من هنا، يتسمُ إضفاءُ الشفافيةِ دوماً على تلك المزايا الأساسيةِ للديمقراطيةِ أو شبهِ الاستقلاليةِ الديمقراطيّة، وعدمُ التخلي عنها تجاه فسادِ ورعونةِ الحُكمِ السلطويِّ بعظيمِ الأهمية. فتصيير الديمقراطيةِ قناعاً لشرعنةِ السلطةِ أو الدولة، هو أفظعُ سيئةٍ ستُرتَكَبُ بحقِّها. إذ ينبغي عدم مطابَقةِ الديمقراطياتِ قطعياً مع السلطةِ أو الدولةِ. فخَلطٌ من هذا القبيلِ يعني استفحالَ القضايا الاجتماعيةِ لدرجةِ العجزِ عن إيجادِ الحلِّ بأيِّ حالٍ من الأحوال. إنّ الديمقراطياتِ التي تُحافظُ دوماً على حيويةِ الوعيِ السياسيِّ واليقظةِ الأخلاقيةِ لدى المجتمعات، هي ساحةُ الحلِّ الحقيقيِّ للقضايا النابعةِ من السلطةِ والدولة. حيث لَم نَشهَدْ بتاتاً نُظُماً أخرى أَبدَت قُدرتَها على حلِّ القضايا الاجتماعيةِ دون اللجوءِ إلى الحرب، بقدرِ ما هي الديمقراطية. أما عندما تتعرضُ سلامةُ المجتمعِ وأمنُه لخطرٍ قاتلٍ على يدِ السلطةِ والدولة، فحينها تَخوضُ الديمقراطيةُ الحربَ بحماس، ولا تَخسَرُ فيها بسهولة.
يأتي الخطرُ الأكبرُ الذي يُهدِّدُ الديمقراطياتِ والإداراتِ شبهَ المستقلةِ في عصرِ الحداثةِ الرأسمالية من السلطاتِ الدولتيةِ القومية. فالكثيرُ من الدولِ القوميةِ التي تُمَوِّهُ نفسَها بسِتارِ الديمقراطية، تُرَسِّخُ المركزيةَ الأكثرَ صرامة، قاضيةً بذلك كلياً على حقِّ المجتمعِ في الإدارةِ الذاتية. وتَعملُ الهيمنةُ الأيديولوجيةُ الليبراليةُ على إقناعِ الغَيرِ بأنّ مزيةَ الدولةِ القوميةِ في التضادِّ مع الديمقراطيةِ هي خاصيةُ “عصرِ الديمقراطية”، وتُسَمّي تفنيدَ الديمقراطيةِ من قِبَلِ الدولةِ القوميةِ بأنه “نصرُ النظامِ الديمقراطيّ”. لذا، فالقضيةُ الحقيقيةُ للديمقراطياتِ إزاءَ الحداثةِ الرأسمالية، هي عرضُها فوارقَها التي تُمَيِّزُها، وعدم التخلي عن خصائصِها التي تتطلبُ المشارَكةَ والسيرورة. ما من قضيةٍ اجتماعيةٍ لا تقدرُ الديمقراطياتُ على حلِّها، ما دامَ ليس هناك فرضٌ لهيمنةِ السلطةِ والدولة.
يكمنُ الدافعُ الأساسيُّ وراء إفلاسِ الاشتراكيةِ المشيدةِ في شروعِها بحلِّ قضيةِ السلطةِ والدولةِ عن طريقِ إنشاءِ سلطةٍ ودولةٍ مضادَّتَين. حيث لَم تَحسبْ حسابَ أنّ الدولةَ والسلطةَ رأسُ مالٍ متراكم، وأنَّهما ستَؤُولان إلى رأسِ المالِ والرأسماليةِ كلما ازدادتا فعالية؛ بل عانت عمىً نظرياً جاداً في هذا الشأن. وبينما ظَنَّت الاشتراكيةُ المشيدةُ أنها ستَبلغُ الشيوعيةَ بتضخيمِ الدولتيةِ القوميةِ المركزيةِ بما يَزيدُ أضعافاً مضاعَفة عن نماذجِ الدولةِ الليبراليةِ الكلاسيكية، فقد باتت وجهاً لوجهٍ أمام أكثر الكياناتِ الرأسمالية وحشيةً وترويعاً. من هنا، فتجاربُ الاشتراكية المشيدةِ غدت من أهمِّ النتائجِ التي تدلُّ على استحالةِ تحقيقِ الاشتراكيةِ من دونِ ديمقراطية. فقضايا المجتمعِ المدنيِّ والإداراتِ المحليةِ وحقوقِ الإنسانِ وحقوقِ الأقليات، وكذلك جميعُ القضايا القوميةِ الكلاسيكيةِ الرائجةِ في راهننا؛ إنما تنبعُ من قمعِ الدولةِ القوميةِ المركزيةِ للديمقراطيةِ والإداراتِ الذاتية. بالتالي، فولوجُ هذه القضايا على دربِ الحلِّ غيرُ ممكنٍ إلا بالتغلبِ على أرضيةِ اغتصابِ الحقوق، والتي رَصَفَتها الدولةُ القومية. وما الطابعُ الفيدراليُّ للولاياتِ المتحدةِ الأمريكيةِ من جهة، وتطويرُ الاتحادِ الأوروبيِّ لنفسِه من الجهةِ الثانيةِ تأسيساً على إعادةِ القِيَمِ الديمقراطيةِ المَسلوبةِ ونَقلِها شيئاً فشيئاً إلى المجتمعِ المدنيِّ والأفرادِ والأقلياتِ والإداراتِ المحلية؛ ما ذلك سوى إشارةٌ إلى أنها تخلَّت عن النظرياتِ والتكتيكاتِ الدولتيةِ القوميةِ التي دامَت ثلاثةَ قرون، والتي تسبَّبَت بحروبٍ ونهبٍ وسلبٍ واستعمارٍ وإباداتٍ وعملياتِ صهرٍ لا نظيرَ لها في أيةِ مرحلةٍ من التاريخ. من هنا، فمثالُ الاتحادِ الأوروبيِّ خطوةٌ تاريخيةٌ على دربِ العودةِ إلى الديمقراطيةِ ولو بحدود. ومثلما لوحِظَ في مثالِ الدولةِ القومية، فإنه من المرجَّحِ أنْ تتشاطرَ دولُ العالَمِ وشعوبُه رويداً رويداً هذا النموذجَ المنفتحَ على الديمقراطية. ولكن، يَبدو وكأنّ الديمقراطيةَ الراديكاليةَ ستتنامى أساساً في القاراتِ الأخرى من العالَم. فتجربةُ أمريكا اللاتينية، مقارباتُ بلدانِ الاشتراكيةِ المشيدةِ القديمة، واقعُ الهند، بل وحتى واقعُ أفريقيا؛ كلُّ ذلك يَبسطُ يوماً بعدَ يوم أهميةَ الدمقرطةِ بنحوٍ متزايد، ويَدفعُ بعجلةِ التطورِ في هذا الاتجاه.
تُظهِرُ الفوضى العارمةُ المُستشريةُ في البلدانِ والمناطقِ الأُمِّ للمدنيةِ المركزيةِ حقيقةَ إفلاسِ الدولتيةِ القوميةِ وتشاطُرِ السلطةِ بكلِّ نواحيها وبكلِّ سطوعِها. فهذه الفوضى قد أَسقَطَت كافةَ أقنعةِ الدولتياتِ القوميةِ في فلسطين–إسرائيل والعراق وأفغانستان وأقنعةِ السلطويةِ التي ترتكزُ بجذورِها إلى أرقى أنواعِ الهرميات؛ وجَزَمَت بكونِهما تُشَكِّلان المصدرَ الأوليَّ للقضايا، وبَسَطَت للمَلأِ ومن جميعِ النواحي أنّ العنفَ والإرهابَ والحروبَ والمجازرَ التي لا تَعرفُ حدوداً تتغذى على هذا المصدر. لقد بُرهِنَ كفايةً أنّ الدولتيةَ القوميةَ ومشاطَرةَ السلطةِ لا تمتلكان سوى كفاءة ضربِ صاحبِهما ونَحرِه كما آلةُ البَمْرَنْغ.
في هذه الأجواءِ تَظهرُ قوةُ الحلِّ لدى الديمقراطيةِ الراديكاليةِ والكونفدراليةِ الديمقراطية. أي أنّ أراضيَ كردستان، التي كانت مَهداً لبزوغِ فجرِ الحضارةِ ماضياً، تَغدو هذه المَرّةَ مَهداً لبزوغِ فجرِ الكونفدراليةِ الديمقراطيةِ والديمقراطيةِ الراديكاليةِ الحقيقية. ثمة قاعدةٌ في الطبيعةِ مفادُها: كلُّ شيءٍ ينمو مجدَّداً على جذرِه. ويَلوحُ أنّ الديمقراطيةَ أيضاً ستُحَقِّقُ ولادتَها كاملةً وبنجاحٍ على جذورِها المخفيةِ في الثورةِ النيوليتية. كما ويَبدو أنّ بمقدورِ هذا المَهد، الذي لا تَبرَحُ ضرباتُ المدنياتِ المهيمنةِ المركزيةِ جمعاء تَلحقُ به، أنْ يَعتَنيَ بمَولودتِه الديمقراطية. أي أنّ هذه الأراضيَ والجبال، التي فَقدَت منذ أَمَدٍ غابرٍ قوتَها في الإدارةِ الذاتيةِ ومهارَتَها في كينونةِ المجتمعِ السياسيِّ والأخلاقيّ، قد تَكُونُ شاهداً على نهوضِ “الكورتيين” من المَهدِ وبِدئِهم بالمسيرِ مرةً ثانية. كلُّ شيءٍ في ثقافةِ الشرقِ الأوسطِ مرتبطٌ ببعضِه بعضاً مثلما الأوعيةُ المتلاصقة. فالحقيقةُ الاجتماعيةُ التي أَثبَتَت جدارتَها في ميدانٍ ما، تتسمُ بميزةِ الانتشارِ السريع في الميادينِ الأخرى أيضاً. لقد غدا الإسلامُ نظاماً عالمياً في غضونِ فترةٍ تُقارِبُ الثلاثين عاماً لا غير. وقضيةٌ صغيرةٌ كفلسطين وكأنها تَأسِرُ المنطقةَ برِمّتِها سنواتٍ عديدة. أما الديمقراطيةُ الحقة، وشبهُ الاستقلالِ الديمقراطيّ، والكونفدراليةُ الديمقراطية، والعصرانيةُ الديمقراطيةُ التي هي تعبيرٌ ممَنهَجٌ عن جميعِ هذه الظواهرِ التي بَلغَت مرتبةً تُؤَهِّلُها للتعاظُمِ ولتحقيقِ انطلاقتِها في مَهدِ الحضارةِ وأثناءَ بزوغِ فجرِ كردستان؛ فقد باشَرَت أداءَ دورِها بوصفِها بديلاً منيعاً في وجهِ الحداثةِ الرأسمالية. ذلك أنّ العصرانيةَ الديمقراطيةَ بمثابةِ نجمٍ يزدادُ عُلُوّاً وتألُّقاً تجاه ذاك النظامِ الذي يُثبِتُ إفلاسَه يوماً بعدَ يومٍ بدروسٍ مليئةٍ بالعِبَر.
تتعلقُ المشكلةُ الأساسية، التي ينبغي حلُّها في العلاقاتِ بين السلطةِ والدولةِ وشبهِ الاستقلاليةِ الديمقراطية، بقدرةِ كلٍّ منها في الحفاظِ على الفوارقِ التي تُمَيِّزُها وترتيبِها حسبَ الأولويات. وبمعنى آخر، فهي تتعلقُ بكيفيةِ قدرتِها على حلِّ قضيةِ السلامِ المجتمعيّ. إذ نَرصدُ من خلالِ الأمثلةِ التاريخيةِ والراهنةِ أنّ مقارباتِ إفناءِ بعضِها البعضِ تؤدي فقط إلى تحوُّلِ سلطةِ الدولةِ إلى وحشٍ (لوياثانٍ) اجتماعيّ، وتفضي إلى استمرارِ الفوضى العارمةِ وتجذُّرِها طردياً. وكلُّ تجربةٍ في الحلِّ ضمن هذا الإطار تَكتمُ أنفاسَ المجتمعِ وتَستهلكُه أكثر. وهكذا، لَم يتبقَّ من العُقمِ السقيمِ سوى بشريةٌ منحصرةٌ في قوالبِ الاستهلاك، ومُتَنَمِّلةٌ تحت ظلِّ النفوذِ المطلقِ للدولة. وقد تَكَوَّنَ هذا الواقعُ تماشياً مع الهجومِ الشاملِ الذي شَنَّته الحداثةُ الرأسماليةُ ضد المجتمع. أما نقاطُ ضعفِ الثوريةِ الخياليةِ القاصرةِ عن تجاوُزِ السلطوية، فقد تَسَبَّبَت في تعزيزِ الحداثةِ الرأسماليةِ أكثر فأكثر.
بمقدورِ حلِّ شبهِ الاستقلالِ الديمقراطيِّ بصفتِه قوةَ الحل، أنْ يتغلبَ على هذه البنى المتضخمةِ بأسلوبَين: الأسلوبُ الثوريُّ والأسلوبُ الإصلاحيّ. وقد تجسدَت التجربةُ التاريخيةُ للأسلوبِ الثوريِّ المرتكزِ إلى الهدمِ الكليِّ لبُنى الحداثةِ الرأسماليةِ عموماً وبنى السلطةِ الدولتيةِ القوميةِ خصوصاً، في المزيدِ من ترسيخِ الدولتيةِ القوميةِ السلطوية، وعجزَت عن النجاحِ في خلقِ بُنى المجتمعِ المناديةِ بالديمقراطيةِ والحريةِ والمساواة. بينما عجزَت الديمقراطيةُ الإصلاحيةُ أيضاً عن الخلاصِ من الانحلالِ في بوتقةِ الحداثةِ المهيمنة. النتيجةُ التي ينبغي استنباطها هنا، أياً كان الأسلوبُ المُتَّبَع؛ هي أنّ صُلبَ الأمرِ يتمثلُ في المواظبةِ على وضعِ الخَياراتِ المؤسساتيةِ والذهنيةِ التي ستُطَوِّرُ نظامَ العصرانيةِ الديمقراطيةِ في الأجندة، وفي تطبيقِها ميدانياً. هذا ويَطغى احتمالُ الجَزمِ بأنْ يُضطرَّ نظاما كِلتا الحداثتَين على العيشِ سويةً ربما لمئاتٍ من السنين، وعلى تطويرِ الحلولِ الدستوريةِ الديمقراطية، سواءٌ ضمن بنيةِ الدولةِ القوميةِ الانفرادية، أم في ثنايا النظامِ العالَميِّ العابِرِ للقوميات؛ وذلك كي يتمكنَ كِلا النظامَين من تذليلِ التناقضاتِ وتعزيزِ العلاقاتِ فيما بينهما. وتطوُّرٌ في هذه الوِجهةِ قد يتمكنُ من تجاوُزِ الماضيِ السلبيِّ والاتجاه به نحو مستقبلٍ إيجابيّ.
[1] المَنليث: حجر ضخم مفرد عادةً على شكل عمود أو مِسَلّة. والمقصود هو التحول إلى كيان ضخم ومفرد (المترجِمة).