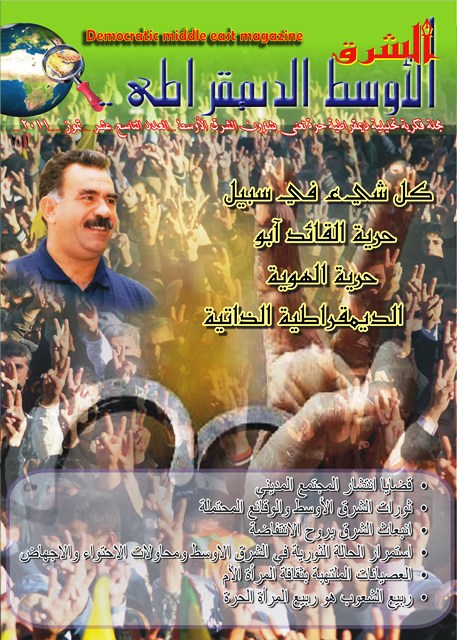الصراع الدّينيّ في الشّرق الأوسط ودور حركات الإسلام السّياسيّ
جميل رشيد

جميل رشيد

يُعَدُّ الخوض في قضيّة الدّين والصراع الدينيّ في الشّرق الأوسط وتفرّعاته المتعدّدة، من أعقد القضايا التي واجهتها المنطقة تاريخيّاً – ولا تزال – بحكم كينونتها كعقيدة زرعت في الوجدان واللا وعي الجمعيّ لشعوبها. إلّا أنّ تحوّلها إلى سلطة يحكم دولاً عديدة، بعد بروز ظاهرة الإسلام السّياسيّ وتأطيرها ضمن حركات وقوى سياسيّة، مكّنتها من ليِّ عنق العقيدة وإعادة تكوينها لتصبح إيديولوجيا، مثلها مثل باقي الإيديولوجيّات السّياسيّة، لكنّها تختلف عنها بالأدوات والأساليب، وهو جعلها مثار انتقادات عديدة لجهة مناكفاتها وسجالاتها العقيمة مع معظم القوى التي وجّهت لها سهام النقد. فاعتمدت على توظيف النّصوص الدّينيّة المقدّسة في خدمة مشاريعها الدُّنيويّة، ليظهر معها مفهوم إسلام “الدّين والدُّنيا”، والتي أظهرت كمّاً هائلاً من التّناقضات بينهما، وهي – أي قوى الإسلام السّياسيّ – في النهاية لم تنتج سوى أسوأ أنواع الاستبداد والدّيكتاتوريّات، رغم أنّها في بعض البلدان لم تتطوّر من حالتها الجنينيّة، إلا أنّ إرهاصاتها تجلّت بأشكال جعلت المؤمنين بالخط السّياسيّ الإسلاميّ يرتدُّون إلى الوراء.
يُرجع العديد من الباحثين في الشأن الدينيّ أسباب التّناحر بين التّيارات الإسلاميّة وأنظمة بلدان الشّرق الأوسط إلى صراع على السُّلطة والنّفوذ والمكاسب، وليس لإرساء العدل والمساواة وإحقاق الحقوق، أو تطبيق الشّريعة الإسلاميّة وتشكيل دولة إسلاميّة، حسب زعمهم.
التّسلسل التّدريجيّ والتّاريخيّ لظهور السُّلطة الدّينيّة مُمثّلة بالخلفاء والأمراء والشّيوخ والأئمة وعلماء الدّين والوعّاظ والمُريدين، وإلى ما هنالك من فئات وطبقات تشكّلت عبر الزّمن في كنف الحكم الإسلاميّ، جميعها أسهمت في ترسيخ ذهنيّة التبعيّة المُطلقة للحاكم، الذي في أغلب الأحيان كان يشغل وظيفتين، حاكم ورجل دين. فجمع جميع الوُلاة في الدّولة الإسلاميّة على مرّ التّاريخ بين إدارة الدّولة؛ أي وظيفة سياسيّة، وبين وظيفة رجل الدّين كمرجعيّة دينيّة، ليغدو أيَّ تمرّدٍ عليه أو خروج عن طاعته، إنّما خروج عن طاعة الله والدّين، وبالتّالي يستوجب إنزال أقسى العقوبات بحقّ كلّ من يخرج عليه، لأنّه يَستمدُّ شرعيّته من الدّين وطبقة العلماء المحيطين به.
إنّ دراسة الصراع بين القوى الدّينيّة والسُّلطات الحاكمة، المتولّد في المراحل المختلفة من تاريخ الشّرق الأوسط، وكذلك تجيير الحكام الدّين لخدمة مصالحهم وبقائهم في السُّلطة، تعتريها العديد من الإشكالات والمنغّصات، نظراً لتشابك العلاقات بين ما هو دينيّ وسياسيّ، وأحياناً تختلط الأمور بحيث لا يستطيع المرء الفصل بينها. فمنذ ظهور الدّيانات السّماويّة الثّلاث في جغرافيّة الشّرق الأوسط “اليهوديّة، المسيحيّة، والإسلاميّة”، لا يزال الصراع قائماً بين أنظمة الحكم ورجال الدّين، وفي مراحل عديدة دخل الدّين في خدمة السُّلطات بشكل كامل واندمجت معها حتّى غدت دين السُّلطة وجزءاً لا يتجزّأ منها، ومعها بتنا أمام إشكال فكريّ، يحمل وجهين متناقضين عبر طرح السؤال التالي: هل نحن أمام دولة الدّين، أم دين الدّولة. وظلّت هذه القضيّة تشغل حيّزاً كبيراً لدى الباحثين في شؤون الدّين، ولم تشذُّ أي دولة من دول الشّرق الأوسط عن هذه القاعدة، ومنذ تشكّلها في الفترات المتعاقبة مع بداية ظهور الأديان الثّلاثة.
ففي روما اعتمد القيصر قسطنطين المسيحيّة ديناً رسميّاً للإمبراطوريّة الرّومانيّة، لتتحوّل فيما بعد إلى دولة دينيّة يتحكّم فيها الإكليروس أو الكهنوت، بعد أن استأثر بكلّ مفاصل الحكم وأخضعها لعقيدته وإيديولوجيّته الدّينيّة المتزمّتة. فحتّى الحروب؛ خاضَتْها الإمبراطوريّة باسم الدّين. الأمر ذاته كان في الدّين الإسلاميّ أيضاً، حيث خاضت القبائل العربيّة التي انضمّت إلى الإسلام معاركها في الاستيلاء على القوافل التّجاريّة وقطع الطرق، والسيطرة على مدن الجوار تحت اسم “الفتوحات الإسلاميّة”. ففي الإمبراطوريّة الرّومانيّة كانت “السُّلطة الدّينيّة صاحبة الصوت الأعلى وكان البابا يمتلك سلطة لا يمتلكها الملوك، وكانت له القدرة على خلعهم أو نزع الشَّرعيّة عنهم، لكنّ النتيجة كانت واحدة، إذ سيطر البابا على الدّين والدُّنيا في أوروبا، وسيطر الخليفة على الدّين والدُّنيا في العالم الإسلاميّ، مع فارق أنّ المعركة في أوروبا كانت ضدّ استغلال الدّين في السّياسة والمعركة في العالم الإسلاميّ كانت ضدّ استغلال السّياسة في الدّين، وتحويل الدّين إلى قوّة قمع في يد الحاكم”.
ما يمكن قوله من خلال التّجارب المريرة التي مرّت بها شعوب المنطقة؛ أنّ الخلط بين السُّلطتين الدّينيّة والسّياسيّة خطأ قاتل يشعل الفتن والحرائق المذهبيّة، ويُغلق العقل ويُقيّد الفكر وحُرّيّة النّاس، ويفرض تنميطاً معيّناً على الأفراد والمجتمعات التي تغدو مع الزّمن خارج إطار التّاريخ والحياة والتّفاعل والتطوّر.
ظلّت الحركات الإسلاميّة تدور ضمن حلقة مُفرَغة من الوهم، بإعادة شعوب المنطقة إلى القبول بالعيش وفق شروط أوّل دولة إسلاميّة تأسّست في التّاريخ، أو كما أطلق عليها تنظيم “داعش” اسم “دولة خلافة على منهاج النبوّة”، وهو ما يتعارض كليّاً مع حقائق عصرنا، وهذا لا يعني نَفيَ الدّين، وإنّما إبقائه بعيداً عن السّياسة.
سنحاول في دراستنا المُقتضبة هذه أنّ نبحث في ماهيّة العلاقة بين الدّين والسّياسة، وانعكاسها على المجتمعات الشّرق أوسطيّة، وكذلك جنوح بعض تيّارات الإسلام السّياسيّ إلى تركيز جهده الأساسيّ في الوثوب على السُّلطة، وبأيّ ثمن كان، عبر توظيف العقيدة لصالح أهدافها السّياسيّة والابتعاد عن جوهر العقيدة التي هي في الأساس علاقة بين الإنسان والإله.
كما سنعرج على بعض تجارب حركات الإسلام السّياسيّ في الحكم وإدارة البلاد، وما آلت إليه، خاصّة في تجربة الرّبيع العربيّ في كلّ من مصر وتونس، وكذلك الصراع الدّامي الذي خاضته حركة الإخوان المسلمين في ثمانينات القرن الماضي في سوريّا ضدّ السُّلطة، وعودتها إلى ذات المسار بعد انطلاق الثّورة السوريّة، والبراغماتيّة التي اتّخذتها منهجاً لها في سلوكيّاتها، وابتعادها، بل وتخلّيها، عن الفكرة الوطنيّة، والانسياق وراء أوهامها في إنشاء خلافة إسلاميّة، بلبوس مدنيّ، والعمل على مبدأ التقيّة الدّينيّة.
ولعلّ استعراض سريع بعض التّجارب التي مرّت بها أوروبا خلال عصور سيادة الكنيسة على مقاليد الحكم فيها، ومن ثمّ بدء عصر النّهضة والتنوير فيها، وانحسار دور الكنيسة في العبادات الفردية، دون التدخّل في شؤون الإدارة والمجتمعات، وانطلاق مبدأ علمانيّة الدّولة وظهور أفكار التحرّر من الفكر الدّينيّ المتشدّد، إلى جانب ولادة الحركات الدّينيّة الإصلاحيّة التي ظهرت في المسيحيّة مثل حركة مارتن لوثر، وغيره، قد تسهّل فهم طبيعة الصراع الدّينيّ في الشّرق الأوسط أيضاً. وربّما إبقاء مقاربات إيجابيّة منها قد تفيدنا في معرفة الدّور الذي تلعبه المدارس الدّينيّة الإسلاميّة المتخلفة، وكذلك فهم أدوار رجال الدّين ومشايخها، في التأثير على مجرى الحياة، وبالتّالي يمكّننا من صياغة مشروع نهضويّ شرق أوسطيّ، كما طرحه المفكّر والفيلسوف عبد الله أوجلان، عبر إخضاع تاريخ المنطقة لعمليّة نقدية صارمة، تنتج مشروعاً حضاريّاً يتجاوز البُنى المتهالكة التي تعيشها.
هل تشكّلت دولة إسلاميّة في التّاريخ..؟
إنّ الإجابة على هذا السؤال، دون مواربة أو إبداء نوع من التعصّب الدّينيّ، يستدعي الغوص في تفاصيل المراحل التي مرّ بها الإسلام، وصولاً إلى يومنا هذا. ولكنّنا سنقتصر على التطرّق إلى أهمّ التحوّلات التي طرأت على الإسلام في العصور الرّاشديّة والأمويّة والعبّاسيّة، ومن ثمّ العثمانيّة، لنصل إلى مرحلة ظهور حركات الإسلام السّياسيّ المعاصرة.
لا شكّ أنّ هجرة النبيّ (محمّد) من مكّة إلى المدينة، كانت بدواعي نشر دعوته وزيادة عدد أنصاره، بعدما عارضته قريش القبيلة الحاكمة في مكّة. وبعد استقام لها المقام في “يثرب/ المدينة المنوّرة لاحقاً”، انبرى إلى دعوة كافّة القبائل والأديان (اليهود والمسيحيّين) للدّخول في الإسلام. وتمكّن خلال فترة زمنيّة قصيرة نسبيّاً من حشد عدد كبير منها إلى جانبه، ليطرح بعدها دستوراً يُنظّم العلاقات بين القبائل والأديان ويحفظ حقوقها، سُمّي باسم “دستور المدينة”. يمكن القول بأنّه أوّل دستور لدولة إسلاميّة وضع في شبه الجزيرة العربيّة، حيث كانت تسود فيها قبلها التقاليد العشائريّة والقبليّة المتناثرة والمتصارعة على الماء والكلأ. وهذا يؤكّد أنّ بذرة الدّولة كانت تدور في خلد النبيّ (محمّد)، وأنّه تأثّر بما رآه بعينيه من تنظيم الإدارة وشؤون الدّولة والجيش في الدّولة الرّومانيّة/ البيزنطيّة التي تعرّف عليها خلال رحلاته التّجاريّة إلى بلاد الشّام قبل البدء بدعوته.
ويعتبر الكاتب “محمّد المحمود” في مقالة له بعنوان “الدّين والسّياسة في الشّرق الأوسط” نشر على موقع “الحرة”: “حتّى عرب ما قبل الإسلام الذين عاشوا في صحرائهم/ جزيرتهم قبائلَ متناثرة تفتقد للحدود الدُّنيا من الوحدة السّياسيّة (باستثناء الجنوب الغربيّ، وتمدّده الظرفيّ/ الاستثنائيّ، والمستعمرات الفارسيّة والبيزنطيّة على تخوم الصحراء العربيّة)، كانت شبكة العلاقات/ الولاءات التي تنظّم حياتهم مُؤَسَّسةً على شبكة تقاليد/ أعراف متناغمة إلى حدّ كبير، ينتظم فيها السّياسيّ والاقتصاديّ بالدّينيّ. وما احتلال مكّة مركزاً دينيّاً، هو – في الوقت نفسه – مركز اقتصاديّ (وسيصبح لاحقاً: سياسيّاً = المشروعيّة القُرشيّة للحكم، المؤسّسة على مقولة: “إنّ العرب لا تَدِين إلّا لهذا الحيّ من قريش”) إلا دليلاً على أنّ نظام الوعي لم يكن يتصوّر إمكانيّة الحدث السّياسيّ بمعزل عن التصوّر الدّينيّ، والعكس ليس بعيداً؛ حتّى وإن كان مُضمَراً، أو مسكوتاً عنه، في أغلب الأحوال”.
ويذهب الكاتب بعيداً في قراءته للتّاريخ الإسلاميّ، إذ يقول: “مع الإسلام، لم يكن الدّين إلا سياسة، ولم تكن السّياسيّة إلا ديناً. وعندما أقول: “مع الإسلام”، فلا أقصد نصوصه المقدّسة ولا وقائعه الأولى/ المُؤسّسة، وإنّما أقصد بالإسلام هنا: صيرورة التّاريخ الإسلاميّ في تفاعل المقدّس المتعالي مع الواقعيّ، سواءً على يد رجاله الأوائل من ذوي القداسة، الذي كانوا يؤكّدون على هذا الارتباط عن قناعة يفرضها تأويل دينيّ يمتلك حدّاً مقبولاً من الاتّساق النّظريّ، أو على يد أولئك المتوسّلين به من غير قناعة؛ بُغية تحقيق الغاية السّياسيّة من أقصر وأوثق طريق، أي عن طريق ربط الحياتيّ الآنيّ بالمقدّس المتعالي”.
إنّ مُجمل الفعّاليّات والنّشاطات الدّينيّة في عصر النبيّ (محمّد)، وكذلك العلاقات التي أسّسها مع الجوار، إنّما عبّرت بكلّ جلاء عن دولة لها مقوّماتها الدّينيّة والسّياسيّة. فالرّسائل التي أرسلها إلى ملوك وأمراء الرّوم والحبشة (النّجاشي) كُتِبَت بلغة دينيّة ومضمون سياسيّ، ربّما لا تختلف عن رسائل الزُّعماء السّياسيّين في وقتنا الرّاهن إلا من حيث الصياغة، وتضمّنت دبلوماسيّة مشهودٌ له فيها حينها.
كذلك مسألة تداول السُّلطة بعد وفاة (محمّد) والخلافات التي ظهرت حينها، دارت حول مسألة واحدة فقط، الاستئثار بالسُّلطة/ الخِلافة، وتركت الحبل على غاربها في أمور الدّين، لتتكرّس هذه في عقل ووجدان المسلمين، وتتحوّل مسألة الخلافة مع مرور الزّمن إلى وراثة، وليس كما أمر الدّين (وأمرهم شورى بينهم).
إنّ دلالة الآية القرآنيّة تشير بكلّ وضوح إلى حثِّ النبيّ (محمّد) لتأسيس دولة إسلاميّة تمتلك القوّة العسكريّة والاقتصاديّة.
فكلّ ادّعاء أنّ الإسلام تاريخيّاً لم يسعَ إلى تأسيس دولة يعتبر باطلاً لا معنى له، فكان ديدن الوُلاة والخلفاء والأمراء التحكّم بالدّولة وتوسيع جغرافيّتها، وعلى أساسها انطلقت حروب “الفتوحات” تحت شعارات وعناوين دينيّة فضفاضة، نظراً لأنّ الدّين حينها كان يرسم ملامح الحياة المجتمعيّة ويحدّد كلّ تفصيل فيها ويخضعها لقوانينه الشّرعيّة، ليُعدّ المعيار الأوّل والأساسيّ في أيّ حِراك سياسيّ واقتصاديّ واجتماعي وثقافيّ، وليعتبر كلّ ما عداه كُفراً أو ارتداداً عن الدّين، ما يستوجب الحكم عليها بموجب الأحكام والتّشريعات الدّينيّة السّائدة حينها.
ففي زمن الخلافة الرّاشديّة، تبلورت أكثر فكرة الدّولة الإسلاميّة وشكلها، لتغدو بنياناً سياسيّاً قائماً على مؤسّسات إداريّة، فتأسّست دواوين كالجُند والخراج (الماليّة/ ديوان الزّكاة) وغيرها من المؤسّسات الكفيلة بإدارة الدّولة التي أصبحت مترامية الأطراف، بعد الحروب/ الفتوحات التي خاضتها تحت اسم نشر الدّين الإسلاميّ.
حتّى في العصر الأمويّ، حيث طُرِحَت لأوّل مرة فكرة الوراثة، يحكم الابن بعد وفاة والده، تكرّست فكرة الدّولة مع اشتداد الصراع بين الأمويّين وعلي بن أبي طالب، لا لشيء، فقط، للصراع على الخلافة، أي الحكم. وشهدت تلك الفترة حروباً مختلفة قاد معظمها صحابة النبيّ. فحرب “الجمل وصفّين ونهاوند” وغيرها من الحروب التي نشبت بين المسلمين أنفسهم وكذلك مع الفرس والرّوم، لا يمكن بأيّ حالٍ من الأحوال النّظر إليها إلا من زاوية الصراع على السُّلطة. فحرب/ موقعة “الجمل” التي قادتها “عائشة” زوجة النبيّ، لم يكن هدفها سوى نزع الخلافة من “علي بن أبي طالب” ونقلها إلى المدينة المنوّرة، بعد أن نقلها “علي” إلى الكوفة. وكذلك حرب/ موقعة “صفّين”، لم تحمل أيّ اختلاف حول مفاهيم دينيّة، بل جوهرها صراع حول أمور “دنيويّة” أي الخلافة والسُّلطة. تلك الحروب خلّفت وراءها مآسيَ وكوارث فكريّة وسياسيّة ترسّخت في وجدان المسلمين، وكرّست واقع الانقسامات داخل الدّين الواحد، فولدت المذاهب الدّينيّة، وهي في جوهرها مذاهب سياسيّة، لكنّها كانت تصدر قراراتها “بفتاوى” شيوخ وعلماء الدّين، وهي الطبقة السّياسيّة والدّينيّة الحاكمة، ولتعزّز معها مبدأ الوراثة في الحكم، دون أن تعير أيَّ اهتمام للمؤهّلات الدّينيّة والسّياسيّة لإدارة البلاد والعباد وفق الشّريعة الإسلاميّة.
إلّا أنّ المرحلة الأكثر إثارة للجدل في التّاريخ الإسلاميّ، كانت مرحلة ولادة الدّولة العبّاسيّة، بعد قضائها بشكل نهائيّ على الدّولة الأموية، والصراع الذي راح ضحيّته عشرات آلاف الضحايا في سبيل نقل السُّلطة/ الخلافة إلى “آل عبّاس”، بعد دكِّ عاصمة الأمويّين “دمشق” ونقل مركز الخلافة إلى الكوفة ومن ثمّ بغداد وسامراء، لتبتعد الدّولة شيئاً فشيئاً عن جوهر الدّين وتدخل في إشكالات الدّولة وتظهر الأمراض السُّلطويّة بشكل فجٍّ في معظم مراحل حكم العبّاسيّين، من خلال الصراعات الدّاخليّة بين الأخوة الخلفاء، عبر تصفيات جسديّة بشعة، كما حدث بين “الأمين” و”المأمون” أولاد “هارون الرّشيد”، وقبلها حينما شرع الخليفة العبّاسيّ الثّاني “أبو جعفر المنصور” بعد “أبو العبّاس السفّاح” إلى تصفية مؤسّس الدّولة العبّاسيّة الحقيقيّ “أبو مُسلم الخُراسانيّ” خوفاً من انقلابه عليه.
شهدت الدّولة العبّاسيّة في طوري الازدهار والضعف والانحطاط العديد من الصراعات الدّاخليّة والخارجيّة، بسبب تغلغل المُعادين لها من السّلاجقة والأقوام الأخرى التي ناصبت العداء لها، وابتعاد الخلفاء عن العمل وفق ما تُمليه عليهم الشّريعة الإسلاميّة، فكان ديدنهم الحفاظ على حكمهم وتصفية معارضيهم حتّى وإن كانوا من الأقرباء. كذلك برزت ظاهرة قتل وتصفية العلماء والمحدّثين والمجدّدين في الدّين، حيث تعرّض العديد من العلماء إلى القتل والتصفية، وبأبشع الأشكال، مثل جماعة المعتزلة والسهروردي وأبو منصور الحلّاج، وغيرهم من العلماء في الطبّ والهندسة والكيمياء والفلك وباقي العلوم. كما اندلعت ثورات عديدة ضدّ الدّولة العبّاسيّة، أهمّها “القرامطة، الزِّنج، البابكيّة”، التي طالبت بإجراء إصلاحات شاملة في بنية الدّولة، ومنح الحقوق لكلّ مكوّناتها التي تعيش بين ظهراني الدّولة، فضلاً عن إعادة بناء مؤسّسات الدّولة وتنظيمها.
ما أتينا عليه في هذه العُجالة هو من باب الذّكر، وليس لدراسة كلّ مرحلة حكمت فيها الدّولة الإسلاميّة، أو إخضاعها لسكّين النّقد، وإنّما استعرضنا تلك المراحل لنؤكّد بأن الدّولة الإسلاميّة ظهرت للوجود منذ اليوم الأوّل لإعلان النبيّ (محمّد) عن رسالته، إلا أنّها مرّت بأطوار الصعود والهبوط. ومنذ اليوم الأوّل لبنائها؛ انكفأت على السّياسة وغابت العقيدة الإسلاميّة عن معظم قراراتها وبنيانها السّياسيّ والاقتصادي والإداريّ وحتّى الاجتماعيّ، بل ظلّ الدّين حبيس المساجد ودور العبادة والتكيّات والمدارس الدّينيّة.
في جميع العصور التالية بعد انهيار الدّولة العبّاسيّة وقيام دول متعدّدة في المنطقة التي كان يحكمها العبّاسيون باسم الإسلام، سادت ثقافة الحكم والسُّلطة في أوساط الطبقات الحاكمة، بدءاً من الدّولة الفاطميّة في مصر ومن ثمّ المماليك وحتّى بدء الاحتلال العثمانيّ للمشرق في بداية القرن السّادس عشر، ما فتح الأبواب أمام صراع دامٍ وطويلٍ للاستحواذ على السُّلطة السّياسيّة والدّينيّة، بعد أن أصبح الدّين أداة من أدوات الحكم.
لم يخفِ السَّلاطين العثمانيّين طموحهم نحو بناء إمبراطوريّة مترامية الأطراف على أنقاض انهيار دولة المماليك في الشّرق. حيث استأثروا بكلّ مقدّرات تلك البلاد وسخّروها لصالح إمبراطوريّتهم الفتيّة، بدءاً من الدّين ومروراً بالمقدّسات الإسلاميّة، حتّى أنّ سليم الأوّل وبعد أن احتلّ بلاد الشّام في معركة مرج دابق عام 1516، وهزم سلطان المماليك قانصوه الغوري في حلب، وخلفه طومان باي في معركة الرّيدانيّة عام 1517، خطف الخليفة العبّاسيّ الأخير “المتوكّل بالله الثّالث” إلى عاصمته “أستانه” إلى أن توفّي في عام 1524، فآلت الخلافة إلى دولة بني عثمان.
هذا الصراع استمرّ بشكل أو بآخر حتّى انهيار الإمبراطوريّة العثمانية ونشوء دول قوميّة متعدّدة في منطقة الشّرق الأوسط، حيث اعتمدت بعض السّلالات الحاكمة الدّين أساساً في بنية وتشكيل دولهم، مثل السّعوديّة التي اتّخذت من المذهب الوهّابيّ مرجعيّة سياسيّة ودينيّة لدولتهم. فرغم أنّ المرحلة التي سبقت انهيار الإمبراطوريّة العثمانيّة ونشوء دول قوميّة في المنطقة شهدت ولادة أفكار تحرّريّة نادت بالإصلاح الدينيّ وبضرورة إبداء مقاربات إيجابيّة من قضايا بناء الدّولة الوطنيّة، أمثال محمّد عبده والكواكبي والعشرات من المفكّرين، إلا أنّ مصيرهم لم يكن أفضل من مصير الحلّاج والسّهروردي وابن رشد وغيره من الفلاسفة والمفكّرين والعلماء.
مرّت المنطقة بحالة من السّبات السّياسيّ، مع تسيّد الحركات القومويّة المشهد السّياسيّ، قابلتها حالة إسلاميّة كمونيّة، انقسمت ما بين الإسلام الشّعبويّ والمنظّم الطامح للسُّلطة. ظلّت المنطقة في حالة الستاتيك السياسيّ هذه، إلى أن هبّت رياح التغيّير مع بدء ثورات ربيع الشّعوب، في حين يطلق عليه آخرون اسم “ثورات الرّبيع العربيّ”، لتدخل المنطقة معها في مرحلة تغييرات شاملة، توحي بتغيير خرائط الدّول التي رسمتها مسطرة سايكس – بيكو في بدايات القرن المنصرم. اللّافت في هذه الثّورات أنّ التيّارات والقوى الإسلاميّة كان لها حضورها القوي، وسعت – ولا تزال – كلّ ما في وسعها إلى إعادة تأسيس دولها على أسس دينيّة صرفة.
تداخل الدّين والسّياسة عبر التّاريخ الإسلاميّ:
أكّد “ابن خلدون” قبل أكثر من ستّة قرون على دور الدّين في تاريخ السّياسة في منطقة الشّرق الأوسط وفي بنية الأنظمة الدّينيّة المتعاقبة، وهو ما أكّد عليه المستشرق المعني بالشّرق الأوسط “برنارد لويس”، عندما أشار إلى أنّ “جميع الثّورات منذ عهود الإسلام الأولى كانت تأخذ طابعاً دينيّاً صريحاً”. وهذه حقيقة تاريخيّة لا يمكن تجاهلها، في حين أنّ جميع الأنظمة الحاكمة في الشّرق الأوسط والتي وصلت إلى السُّلطة، إنّما أقامت مشروعيّتها على الدّين، فكلا الطرفين؛ الثّائر والمستهدَف، يتوسّلان إلى الله ليتوّج عمله بالنّصر، ويستمدّ قوّته المعنويّة من الشّعارات الدّينيّة ويبني قناعاته ودعايته بين جماهيره على الدّين والنّصوص المقدّسة.
حتّى الأحزاب العلمانيّة والقوميّة التي نشأت في غمرة النّضال الوطنيّ التحرّريّ في المنطقة بعد وقوعها تحت الانتداب والاحتلال، استندت في جزء غير قليل من بنائها النّظريّ والسّياسيّ إلى الأفكار الدّينيّة، على اعتبار أنّ الحاضنة الشّعبيّة تحمل أفكاراً دينيّة، ولا يمكن بسهولة إبعادها عن قناعاتها المتشكّلة عبر الزّمن والتي حملتها معها كمُورّثة لا يمكن الاستغناء عنها. فجمعت تلك الحركات والأحزاب العلمانيّة ما بين القوميّ والدّينيّ في دساتيرها التي حكمت بها بلادها، لتنتج حالة هجينة من الشّطط الفكريّ وحالة هلاميّة، أنتجت ديكتاتوريّات استبداديّة، انحصر تفكيرها في الاستئثار بالسُّلطة وحدها، رغم أنّها ضمّنت في قوانينها وتشريعاتها جزءاً لا بأس به من التّشريعات الدّينيّة، غير أنّها كانت بَعيدة كلّ البُعد عن الدّين ومفاهيمه ونصوصه.
فالتجربة البعثيّة في كلّ من العراق وسوريّا، هما أكبر مثالين صارخين حول حقن السّياسة بالدّين لأغراض التحكّم بالسُّلطة. فعندما كتب “صدام حسين” كلمة “الله أكبر” على العلم العراقيّ، كان الهدف منه استمالة الشّرائح الدّينيّة الإسلاميّة في العراق، ووضعها في خدمة نظامه. كذلك الطبقة الدّينيّة المؤلّفة من شيوخ وكبار علماء الدّين، استخدمهم نظام حافظ الأسد في ثمانينات القرن الماضي لنزع المشروعيّة الدّينيّة عن جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك فعلها بشّار الأسد، من خلال تصريحات الأئّمة والشّيوخ حول عدم جواز قتال الحكومة السّوريّة دينيّاً، لأنّها تحكم بالشّرع الإسلاميّ، أي أنّها أضفت عليها المشروعيّة الدّينيّة. ما يؤكّد على أنّ الدّين وظّف في خدمة السّياسة والنّظام. وبالتّالي لا يمكن الفصل بين ما هو دينيّ وما هو سياسيّ، حيث أنّ لكلّ نظام في الشّرق الأوسط دينه الذي تَدين به، وتُغلّف نفسها به وتستمدّ مشروعيّتها منه، لا من شعوبها.
وفي التجربتين الإيرانيّة والتركيّة، ثمّة بعد آخر لتطويع الدّين في خدمة السّياسة العامّة للدّولة وللطبقات الحاكمة باسم الدّين. فرغم علمانيّة النظام البهلويّ في إيران؛ فإنّ ولادة الحركة الدّينيّة الشّيعيّة التي قادها الخُميني وأطاحت بنظام الشّاه عام 1979، وطرحت نفسها بديلاً في الحكم، لم تقل استبداداً عن نظام الشّاه، بل تجاوزته، لتحكم المجتمع الإيرانيّ بالحديد والنار، وهذه المرّة باسم الدّين. وما تعرّضَ له الشّعب الكُرديّ في روجهلات/ شرق كردستان الواقعة تحت الاحتلال الإيرانيّ، كان وصمة عار لنظام الملالي، حيث نكثوا بكلّ عهودهم ووعودهم في منح الشّعب الكُرديّ حقوقه، فطرحوا شعار “إنّما المؤمنون أخوة”، “ولا فرق بين عربيّ وأعجميّ إلا بالتّقوى”، وعلى أساس هذه القاعدة الشرعيّة؛ تمَّ إهدار دماء آلاف الكُرد الأبرياء وكذلك الإيرانيّين ممّن عارضوا النّظام الدّينيّ في إيران، ولا زال النّظام مستمرّاً على نهجه إلى يومنا هذا.
وفي تركيا التي أرسى فيها كمال أتاتورك أسس النّظام العلمانيّ، حتّى أنّه منع رفع الأذان باللّغة العربيّة، عادت موجة التَديُّن لتسيطر على قطاعات وشرائح واسعة من المجتمع التركيّ، متناغمةً مع الشّعور القوميّ العنصريّ المتطرّف، لتنتج شكلاً جديداً من التوليفة الدّينيّة – القوميّة وحالة عائمة لا استقرار فيها. وتبنّى حزب العدالة والتنمية الحاكم الآن هذا النّموذج، ليؤجّج مشاعر التطرّف الدّينيّ – القوميّ التي باتت تشكّل خطراً على الدّولة التركية ومجتمعها، بعد أن سيطرت على مؤسّسات وإدارات الدّولة، ليهدّد شكل الدّولة وكيانها.
استخدمت أنظمة الشّرق الأوسط الدّين الإسلاميّ “فزّاعة” ضدّ شعوبها، وتثير مخاوفها من وصول الإسلاميّين إلى الحكم. وقد تمكّنت من إنتاج إيديولوجيّتها الخاصّة بها والمبنيّة على رفض كلّ ما هو دينيّ، فأنشأت دينها الخاص بها، وكذلك فقهاءها وشيوخها الذين يسبّحون بحمدها، ويصدرون الفتاوى التي تسبغ الشّرعيّة على حكمها. ويصف الكاتب السّوريّ “محمّد ديبو” في دراسة له بعنوان “الدّين والسّياسة: أيُّ علاقة؟” حيث نشرت هذه الدراسة على موقع صحيفة “العربي الجديد”، توضّح كيفيّة استغلال السُّلطة للدّين ورجال الدّين في خدمة ترسيخ نظامه واستمراره، فيقول: “تبيّن لنا أنّ السُّلطات المستبدّة تعمل دائماً على صناعة “أديانها” وأساطيرها في سبيل البقاء، فتصنع بذلك رجال دين على مقاسها، ليصنع هؤلاء بدورهم “فتاوى” و”نصوصاً مقدّسة” هدفها الوحيد هو الترويج لما تريده السُّلطة، أي أنّ الدّين هنا مجرّد “متحوّل تابع” لمتحوّل مستقلّ بذاته هو السُّلطة”.
ويقارن الكاتب السّوريّ “ياسين الحاج صالح” في دراسة له بعنوان ” تأمّلات في السُّلطة الدّينيّة والسُّلطة السّياسيّة ومعنى العلمنة في عالم الإسلام السُنّي” نشرت في موقع “الحوار المتمدّن”، بين دور الكنيسة في أوروبا مع دور المساجد ودور العبادة الإسلاميّة في الشّرق “لقد عاشت أوربا الغربيّة قروناً تقارب ألف سنة من تناثر السُّلطة السّياسيّة ووحدة السُّلطة الدّينيّة (الاستثناء الأبرز إمبراطوريّة شارلمان الكارولنجيّة في القرن التّاسع)، تماماً عكس العالم الإسلاميّ حيث التّناثر من نصيب السُّلطة الدّينيّة والوحدة من نصيب السُّلطة السّياسيّة. وما يقال عن التناثر الإقطاعيّ الأوربيّ ونزاعات الأمراء مع المؤسّسة البابويّة أو تبعيّتهم لها، يمكن أن يُقال مثله لدينا عن تناثر السُّلطة الدّينيّة الإسلاميّة”.
وأحد أوجه الصراع الدينيّ المتمظهر في الشّرق الأوسط، يتمثّل في تصارع مشاريع ظاهرها دينيّ وباطنها قوميّ صرف. فالدّولة الإيرانيّة التي تقود مشروعاً توسعيّاً في المنطقة، مدفوعة بالفكرة المذهبيّة الشّيعيّة، تحاول النّفاذ من الفراغات – والتي ما أكثرها – في المنطقة، عبر نشر فكرة التشيّع وبناء حركات وأحزاب سياسيّة تدين لولاية الفقيه، وتعتبرها مرجعيّة لها في كلّ حراكها السّياسيّ والعسكريّ والاقتصاديّ.
بالمقابل؛ تتحرّك تركيّا بوحي من تاريخها في قيادة المعسكر السُنّي، إلى التمدّد في المنطقة، مستغلّةً اشتعال بلدان الشّرق بثوراتها، لتحقّق مشروعها الطورانيّ “الميثاق الملّي”، مستندةً إلى العلاقة التّاريخيّة التي ربطتها بشعوب المنطقة ضمن إطار الجامعة الإسلاميّة السُنيّة، لتشعل حرائق إضافيّة في المنطقة، ولتصل حدّ التّصادم مع رغبات وطموحات الشّعوب.
فيما المشروع الصهيونيّ المستند إلى مقولة “أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل”، يسعى إلى بناء دولة يهوديّة دينيّة مترامية الأطراف، لتتصارع مع محيطها الإسلاميّ، وتكون أحد الأسباب الرّئيسية في ديمومة الحروب الدّينيّة في المنطقة.
ويشرح الكاتب السوريّ “جاد الكريم الجباعي” في مقالة له بعنوان ” وجهات نظر.. هل الدّين سلطة في ذاته؟” ماهيّة العلاقة بين السُّلطة الدّينيّة والسّياسيّة أو عدم وجود سلطة دينيّة بالأساس، وحاجة الأوّل إلى إجراء إصلاح دينيّ ليتوافق مع شروط العصر، عبر مأسسة “الدّين”، ما يساعد مجتمعاتنا للانتقال إلى “الديمقراطية”، فيقول: “يذهب كثيرون إلى الاعتقاد بعدم وجود “سلطة دينيّة” أو “كهنوت” في الإسلام، بوجه عام، ويميل آخرون إلى الاعتقاد بعدم وجود مثل هذه السُّلطة في الإسلام السُنّي خاصّة. لكن بعضهم، يرى أنّ ثمّة سُلطة دينيّة في عالم الإسلام السُنّي، لكنّها “متناثرة بشدّة؛ وأنّ “الإصلاح الدّينيّ” الإسلاميّ المحتمل مشروط بتوحيدها ومركزتها ومأسستها؛ (ما) يساعد مجتمعاتنا على التشكّل والتّوازن، ويسهل عمليّة الدمقرطة، وهو بعدُ “لحظة” في عمليّة علمنة لا نرى مجالاً للقفز فوقها”. ويرى، من ثم، “أنّ ضعف السُّلطة الدّينيّة وتبعثرها، لا قوّتها أو وحدتها، هو العقبة الكؤود دون عقلنة حياتنا الاجتماعيّة والسّياسيّة والدّينيّة وترتيب العلاقة بين الدّينيّ والسّياسيّ في بلداننا على الفصل والاستقلال، أي دون العلمنة”.
ويؤكد الكاتب أنّه “من المسلّم به أنّ ثمّة سلطة مستمدّة من الدّين، في كلّ زمان ومكان؛ و”عالم الإسلام السُنّي” ليس استثناءً؛ لأنّ الدّين مصدر من مصادر السُّلطة، بوجه عام، ومن مصادر السُّلطة السّياسيّة، بوجه خاص، شأنه شأن الكتابة والمعرفة والثّقافة والعلم والقوّة والمال والمُلكيّة الخاصّة”. ويمضي في تفصيل مقوّمات ورجالات الدّولة الدّينيّة، حسب توصيف “عبد الرّحمن الكواكبي” لها، ليصفها بالقول: “تمارس هذه السُّلطة مؤسّسة راسخة نميل إلى تسميتها مؤسّسة “الدّين الوضعيّ”، التي ينضوي في إطارها “العلماء” والشّيوخ والأئّمة والفقهاء والمجتهدون والمفتون ووعّاظ السَّلاطين و”المتمجّدون” بمجد المستبِدِّين، بتعبير عبد الرّحمن الكواكبي، فضلاً عن مؤسّسة الإفتاء ومؤسّسة الأوقاف وغيرهما”.
والاعتقاد السائد في الأوساط السّياسيّة وبين النُّخب الثّقافيّة، أنّ الدّين الإسلاميّ، وبعد تحوّله إلى أيديولوجيا مترافقةً مع ولادة حركات الإسلام السّياسيّ في العصر الحديث، ابتعد عن مضامين العقيدة بوصفها علاقة بين الفرد والإله، وتركّزت جهود حركات الإسلام السّياسيّ على وضع العقيدة والإيديولوجيا في خدمة أهدافها في الوصول إلى السُّلطة. فأصبح مفهوم “سُلطة الدّين” و”دين السُّلطة” ملازماً لكلّ مرحلة من مراحل الدّولة الشّرق أوسطيّة ولأنظمتها التي وضعت الدّين في خدمة إحكام قبضتها على السُّلطة واستمراريّتها.
من هذا المنظور السّياسيّ وكذلك السوسيولوجيّ؛ لا بُدَّ من تحرير الدّولة من “دينها” الذي كوّنته عبر عمليّات التحوير والتزوير وبما يناسب الأنظمة الحاكمة، بالمثل؛ أثبت التّاريخ أنّ الأخذ بمُسلّمات العقيدة الدّينيّة في تكوين الدّول على أسس دينيّة، أي بناء الدّول الدّينيّة، دون إبداء أيّ مقاربة لها مع الكمِّ الهائل من التطوّرات العصريّة في كافّة المجالات، لم تَعُد تفي بأغراض التطوّر العلميّ والفكريّ للبشريّة، فلا بُدَّ من تجاوز هذه الأفكار الدّاعية إلى أنّ “الإسلام هو الحلّ” وأنّ “دولة الشّرع الإسلاميّ” هي الخلاص للمجتمعات من الاستبداد.
فحتّى الأنظمة الاستبداديّة التي سعّرت من الخطاب الدّينيّ متعدد الأوجه، استغلّت سعي الحركات الدّينيّة للوثوب على السُّلطة، واستخدمته سلاحاً فتّاكاً في محاربة شعوبها، ما رفع سويّة العنف المجتمعيّ وعمّق انقسام المجتمع على أسس دينيّة وطائفيّة ومذهبيّة مقيتة، وخير دليل على ذلك ما تشهده سوريّا من حرب منفلتة من كلّ الضوابط الأخلاقيّة والدّينيّة.
لقد بات من الصعوبة بمكان فصل تاريخ “السُّلطة الدّينيّة” عن الاستبداد السّائد في الدّول الإسلاميّة، فكان الاستبداد وتحوّل الدّين إلى “سلطة” ركيزةً أساسيّة في بناء وتكوين الدّولة الإسلاميّة في جميع مراحلها، وهو ما تجلّى أكثر فأكثر في النّصف الثاني من العصر الرّاشديّ والأموي والعبّاسيّ، وصولاً إلى الإمبراطوريّة العثمانية والدّول القومويّة التي تشكّلت على أنقاضها.
لقد ابتعد القائمون على الدّين عن المضامين الأخلاقيّة للدّين، بمجرّد تحوّلهم إلى رجال سُلطة أو خدم في جيش السُّلطات، وتحوّلَ قسم كبير منهم إلى مستبدّين تفوّقوا على استبداد الأنظمة التي كانوا يعارضونها قبل وصولهم إلى السُّلطة. والتجربة السّوريّة في هذا الصدد برهان ساطع على ذلك. لكن السّؤال: هل الدّين يحمل في بذوره وعقائده الاستبداد من خلال ممارسة طقوسه وشعائره، وهل الإسلام يُقرُّ بقطع الرّؤوس والتمثيل بجثث القتلى من معارضيه؟ هل هذه هي الثّقافة التي توارثها المسلمون من “السّلف الصالح”، أم أنّ الأنظمة الاستبداديّة قد أنتجت معارضة إسلاميّة من صنوِها وعلى شاكلتها لتوافقها في التوجّهات والممارسات؟
إنّ الإجابة على هذا السّؤال تحمل في طيّاتها الكثير من المآسي التي حلّت بشعوب الشّرق الأوسط تحت مقولة “دين الدّولة” أو “دولة الدّين”، والتجربة أثبتت أنّ الحركات الإسلاميّة لم تتمكّن من إجراء مراجعات فكريّة ونقديّة لتاريخها الطويل الحافل بالكوارث الفكريّة والعقديّة التي صاغتها وفق أهواء السُّلطة، بل أعادت إنتاج نماذج استبداد الدّولة الإسلاميّة، واستخدمت آخر ما توصّلت إليه البشريّة من تطوّر تكنولوجيّ وفكريّ واجتماعيّ بمكر بالغ لصالح تمرير مشاريعها القروسطيّة، لا لشيء، فقط لإحكام قبضتها على المجتمع والدّولة. ففي حين تنظيم “داعش” الإرهابيّ وكذلك الحركات التّابعة لجماعة الإخوان المسلمين تحرّم التّلفاز والهاتف المحمول؛ فإنّها في الوقت نفسه كانت تصوّر عمليّات تصفيتها لمعارضيها عبر استخدام التقنيّات التي حرّمتها على مجتمعاتها وتنشرها على الملأ.
فيما يرى بعض أتباع الحركات الإسلامويّة والمتشدّدين منهم، أنّ الأنظمة الاستبداديّة تمكّنت من تدجين “السُّلطة الدّينيّة” المتمثّلة بالمؤسّسات الدّينيّة، بدءاً من المساجد والأوقاف الدّينيّة وغيرها، لتتحوّل إلى أبواق للسُّلطة وتبتعد عن جوهر الدّين والعقيدة. أصحاب هذا الرأي وصل بهم الحدّ إلى تكفير الدّولة كنظام قائم على المؤسّسات الخدميّة والإدارية، وكفّرت كلَّ من يتعامل معها، ولذلك شهدنا في ثورات الرّبيع العربيّ إقدام الحركات الإسلاميّة المعتدلة منها والمتشدّدة إلى إصدار الفتاوى الدّينيّة التي تُحرّم التّعامل مع مؤسّسات الدّولة وتعتبر كلّ من يعمل فيها “كافراً” يستحقُّ القتل، ولم يكن هذا الأمر مقتصراً عل تنظيم “داعش”، بل العديد من الهيئات والمجالس الإسلاميّة أصدرت هكذا فتاوى، مثل “المجلس الإسلاميّ السّوريّ” الذي أصدر فتاوى أحلّ فيها ممتلكات أهالي عفرين إبّان الغزو التركي لها، واعتبرته “غنيمة” للمسلمين في “جهاد” ضدّ من وصفتهم بالكفّار.
ثورات الرّبيع العربيّ والدّولة الدّينيّة:
منذ انطلاقة ثورات ربيع الشّعوب في تونس وامتدادها إلى كلّ من ليبيا ومصر واليمن وسوريّا؛ والتي حملت شعارات المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان وحُرّيّة الرأي والتعبير، والحُرّيّة الثّقافيّة والدّينيّة، لم تتبلور رؤية واضحة لمآلاتها، بل غرقت في الفوضى الفكريّة والسّياسيّة والعسكريّة. إلا أنّ اللّافت أنّ جميع الثّورات هو صعود حركات الإسلام السّياسيّ، والتي ظلّت قبلها في حالة كمونيّة وتتّخذ من مبدأ التقيّة السّياسيّة منهجاً لعملها، خاصّة في سوريّا والجزائر التي شهدت أحداثاً وصراعاً دامياً بينها وبين السُّلطات الحاكمة في ثمانينات وتسعينيّات القرن الماضي.
لا شكَّ أن الدّين يلعب دوراً محوريّاً في سياسات الشّرق الأوسط، كما يؤثّر تأثيراً مباشراً في حياة الأفراد بشكل عام، وفي بعض البلدان يلعب الانتماء الدّينيّ أو الطائفي دوراً كبيراً في تحديد دور الأفراد في الحياة السّياسيّة والعامّة وحقوقهم وفرصهم في التّعليم والعمل، حيث أنّ العديد من الدّول تتّخذ من الشّريعة الإسلاميّة “دستوراً” لها، مثل السّعوديّة، تنظّم الدّولة والمجتمع وفقاً له.
إنّ صعود تيّارات الإسلام السّياسيّ وتصدّرها المشهد السّياسيّ في البلدان التي شهدت ثورات شعبيّة، إنّما مردّه فشل التيّارات العلمانيّة والديمقراطية في ملء الفراغ الذي تركته وراءه، وتقاعسها عن القيام بواجباتها الثّوريّة تجاه مطالب الجماهير الواسعة وانزوائها في مجابهة أنظمتها الاستبداديّة. والمقاربات التي أبدتها التيّارات الإسلاميّة منذ اليوم الأوّل لانطلاقة الثّورات، أظهرت كمّاً كبيراً من البراغماتيّة السّياسيّة المُفرطة، من خلال طرح شعارات تُعبّرُ عن أهدافها الحقيقيّة وراء حراكها في الشّارع السّياسيّ والشّعبيّ، محاولة استقطاب الجماهير نحو التعلّق بها والسير نحو تحقيق أهدافها المتناقضة مع مطالب المتظاهرين في الشّوارع والسّاحات. فلم تخفِ مشاريعها في الوصول إلى السُّلطة وإنشاء دولتها الدّينيّة.
ظلّت معظم الحركات الإسلاميّة قبل بدء ثورات الرّبيع العربيّ تعمل في إطار العمل الدّعوي لنشر الفكر الإسلاميّ، وتتحيّن الفرصة لتنقضَّ على السُّلطة لإعلان دولتها الإسلاميّة، وخير مثال في هذا الصدد حركة الإخوان المسلمين في مصر، وفرعها في تونس حركة النهضة الإسلاميّة.
غير أنّ تصاعد وتيرة العنف والصراع بين الحركات الإسلاميّة والأنظمة الحاكمة في بلدان المشرق، يوحي أنّنا على موعد مع حروب دينيّة – سياسيّة كتلك التي عرفتها أوروبا في القرن السّابع عشر، وإن بشكل أكثر اتّساعاً، بعد أن عادت الحركات الإسلاميّة تحمل السّلاح وتعتنقه كركن أساسيّ في “دينها”، ليخدم أهدافها السّياسيّة، ولتبرّره تحت اسم “الجهاد في سبيل الله”.
يعتبر “جيرمايا أوكيفي” المستشار السّابق لشؤون الشّرق الأوسط في البيت الأبيض “إلى أنّ “داعش” في أحد آخر تسجيلاته جاء ليبُثَّ ويروّج لبذور حرب دينيّة، عبر استخدام خريطة تظهر فيها روما وقد سقطت بيد التنظيم، وانتشار سيطرته في أوروبا وفي أمريكا، وكذلك شرقا نحو الصّين”، ويخلص إلى القول: “ما نحن أمامه هنا هو إعلان لحرب عالميّة، وهناك تركيز كبير على المسيحيّة، ممّا يعني أنّنا حتماً أمام حرب دينيّة الآن”.
في حين لا يعتقد العديد من المثّقفين والسّياسيّين أن ما يجري في الشّرق الأوسط هو حرب دينيّة، بل شكل من أشكال الصراع على السُّلطة، وفي هذا الصدد يرفض الكاردينال “بيترو بارولين” أمين سُرّ حاضرة الفاتيكان (رئيس الوزراء) أنّ ما يجري في الشّرق الأوسط وخاصّة في العراق صداماً بين الإسلام والمسيحيّة، بل هو صراع على السُّلطة.
إنّ الكراهية الدّينيّة ونبذ الآخر المختلف واعتبار كلّ من لا ينتمي إلى دينه هو كافر أو مرتدّ اعتماداً على مقولة “من ليس معنا، فهو ليس منّا وهو ضدّنا”، أحدث شروخاً اجتماعيّة واسعة في مجتمعات الشّرق الأوسط، وانتشارها في العالم يهدّد السّلم العالميّ برمّته. فالعمليّات التي نفّذها عناصر “داعش” و”تنظيم القاعدة” في البلدان الغربيّة، تندرج ضمن مفاهيم نشر الكراهية الدّينيّة. وهي تأتي في إطار التعصّب الدّينيّ، الذي قابله في الطرف الآخر ارتفاع حدّة التعصّب الدينيّ لدى جماعات متطرّفة من المسيحيّين أو النّازيّين الجدد، كحادثة الاعتداء على المسلمين في إحدى مساجد نيوزيلاندا.
إنّ ارتفاع نبرة الخطاب المعادي للأديان والمعتقدات الأخرى لدى المتطرّفين الإسلاميّين في الشّرق الأوسط، وانعكاسها على شكل تعويم الإرهاب، ينذر بالدّخول في “عصر الإرهاب الانتحاريّ”، حسب تعبير أحد الكتاب المصريين.
ويعتبر الكاتب والحقوقيّ اليمنيّ “حسين الوادعي” في مقالة له بعنوان “نحن وثنائيّة الاستبدادين الدّينيّ والسّياسيّ” نشرت على موقع “درج” الإلكترونيّ، أنّ خيارات شعوب المنطقة باتت محدودة، فيقول: “تكاد الخيارات تنحصر بين قوّتين رئيسيّتين؛ ورثتا السّاحة بعد أحداث الرّبيع العربيّ. القوّة الأولى هي البيروقراطيّات العسكريّة والمَلكيّة التي تداولت الحكم في العقود الستّة الماضية، والقوّة الثّانية هي جماعات الإسلام السّياسيّ السُنيّة والشّيعيّة التي انطلقت من صفوف المعارضة، لكنّها تحوّلت إلى سلطة جديدة بآليّات قمع وسيطرة مختلفة”.
ويمضي “الوادعي” ليؤكّد حقيقة ظهرت بجلاء في أحداث الرّبيع العربيّ “نعم.. ظنّ البعض أنّ الإسلاميّين قوّة من قِوى الثّورة، لكنَّ الأحداث التي تلت كشفت أنّهم “سلطة ثانية” تحتاج الشّعوب إلى مقاومتها كما قاومت السُّلطة الحاكمة”.
ويؤكّد “أنّه من الصعب إيجاد فصل قاطع بين السُّلطتين، بخاصّة أنّ السُّلطة السّياسيّة تستخدم الدّين لتبرير بقائها في الحكم، والسُّلطة الدّينيّة هي في جوهرها تديين للسّياسة، أكثر ممّا هي تسييس للدّين، إلا أنّ الفارق بينهما هو فارق جوهريّ في الأدوات. ففي حين تمارس الأنظمة الحاكمة السّياسة بمصطلحات السّياسة، فإنّ الحركات الإسلاميّة تمارس السّياسة بمصطلحات الدّين، وتحوّل الدّين إلى أيديولوجيا سياسيّة شموليّة قبل كلّ شيء”.
وحسب وجهة نظر “الوادعي” وتحليله للصراع الدّائر في المنطقة “أنّه لا يمكن إنكار دور الحركات الدّينيّة في إسقاط أنظمة المنطقة، إلا أنّه لا يمكن في الوقت ذاته، تبرير سعيهم إلى الانفراد بالسُّلطة وإقصاء شركاء الثّورة وتكوين طغيان جديد بلباس دينيّ”. ويعتبر “أنّ الصراع بعد السنة الأولى من أحداث الرّبيع العربيّ؛ تحوّل من صراع بين الشّعوب الثّائرة والأنظمة، إلى صراع بين الاستبداد الدّينيّ والاستبداد العسكريّ، وتراجعت قوى الثّورة المدنيّة الأخرى إلى الهامش”.
وفي تجربة مصر بعد وصول الإخوان المسلمين إلى السُّلطة عبر صناديق الانتخاب، تبيّن استئثارهم بالسُّلطة وتهميش باقي الفئات والقوى السّياسيّة والمجتمعيّة الأخرى، فضلاً عن جعل نفسها مركز جذب واستقطاب للقوى السّلفيّة والتكفيريّة في العالم، ما دفع الشّعب المصريّ إلى النّزول إلى الشّوارع والسّاحات، وإعلانه الشَّرعية الثّوريّة التي أطاحت بالشَّرعية الدُّستوريّة التي يتبجّح بها الإخوان. فيما لا تزال سوريّا تعاني آلام صراع الإخوان مع النظام للاستحواذ على السُّلطة.
ويسرد الكاتب “الوادعي” الأساليب التي يلجأ إليها كلّ من الاستبدادَين؛ الدّينيّ والسّياسيّ في صراعهما على السُّلطة “تخوض “السُّلطتان” الحرب اليوم بأسلحتهما النّاعمة والخشنة. فقد رفعت البيروقراطيّة العسكريّة والمَلكيّة شِعارَي “محاربة التطرّف وتجديد الخطاب الدّينيّ” لمواجهة الخصم الدّينيّ، في حين رفع الإسلاميّون شعارات “الحُرّيّة والدّولة المدنيّة” في مواجهة الأنظمة التسَّلُطيّة القائمة”.
ويؤكّد الكاتب أنّ تلك الشّعارات خادعة تخفي داخلها تقيّة دينيّة وسياسيّة مقيتة “لكنّها شعارات زائفة تخفي الحلول الحقيقيّة لمواجهة الاستبدادين. فالشّعار الحقيقيّ لمواجهة الاستبداد الدّينيّ هو “العلمانيّة” وليس تجديد الخطاب الدّينيّ أو محاربة الإرهاب. والشّعار الحقيقيّ لمواجهة الاستبداد السّياسيّ هو “الدّيمقراطيّة” وليس الحُرّيّة أو الدّولة المدنيّة، بخاصة أنّ الإسلاميّين يفهمون الدّولة المدنيّة بأنها الدّولة التي يحكمها “مدنيّون” ولو حتّى تحت شعار الدّولة الإسلاميّة وتطبيق الشريعة!”.
التيّارات السّياسيّة الإسلاميّة وتباين أشكال صراعها على السُّلطة:
ظهرت خلال الفترة الممتدّة من عصر النبيّ (محمّد) إلى يومنا هذا العديد من الحركات السّياسيّة الإسلاميّة، تباينت في أفكارها السّياسيّة وأهدافها، وكذلك الأساليب التي استخدمتها لإنجاز مشاريعها. فيما لم يذكر لنا التّاريخ أيَّ صراع حقيقيّ فكريّ بينها لجهة الأهداف والمعتقدات الأساسيّة التي تؤمن بها، سوى في فترات معيّنة، اتّسمت في ظاهرها بالاختلاف حول بعض الاجتهادات والأمور الفقهيّة، إلّا أنّ جوهرها عكس تنافساً ومن ثمّ صراعاً على السُّلطة. فالثّورات التي اندلعت ضدّ الدّولة العباسية لم تختلف حول ماهيّة وبُنية الدّولة، بقدر ما اختلفت على من يحكم الدّولة ويديرها. كذلك الأمر كان بالنسبة لما بعد ظهور التيّار الحداثيّ في الإسلام، أي في عصر النَّهضة أواخر القرن التّاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حيث ولدت حركات تدعو إلى إصلاح الدّين ليواكب العصر، ولم تتضمّن دعوات المحدّثين والمطالبين بالإصلاح أي إشارة إلى فصل الدّين عن الدّولة على غرار الحركات الإصلاحيّة في أوروبا إبّان عصر النهضة والتنوير، حيث طرح مارتن لوثر /95/ مطلباً على الكنيسة، وهي شكّلت انطلاقة جديدة لولادة حركات سياسيّة علمانيّة. أمّا في دول المشرق؛ فقد كانت ولادة حركة الإخوان المسلمين في أواخر العشريّة الثانية من القرن الماضي، لتضع حدّاً فاصلاً بينها وبين مُجمل الحركات الدّينيّة، ولتدشّنَ عصراً جديداً في تاريخ الإسلام السّياسيّ، عنوانه الرّئيس العودة إلى الخطاب الدّينيّ المتشدّد المتمحور حول شعار “الجهاد” لبناء الدّولة الإسلاميّة.
فيما يجد بعض الدّارسين لتاريخ الإسلام السّياسيّ أنّه – أي الإسلام السّياسيّ – لم يكن في يوم من الأيّام واحداً موحّداً، فهي داخلة في صراع بيني مرير ومديد وحاد جدّاً حول المفاهيم الأساسيّة في الإسلام والتي تتعلّق بالعقيدة ونظم الحكم والعديد من القضايا الجوهريّة التي باتت مثار خلافات عميقة، انعكست تشظّياً وانقساماً شديداً في السّاحة السّياسيّة الإسلاميّة، وبالتالي قسّمت معها أطيافاً واسعة من المجتمع معها أيضاً.
لقد قسّم المفكّر السّوريّ الدّكتور “صادق جلال العظم” الإسلام إلى ثلاثة أقسام، وحدّد لها مجالها السّياسيّ والحيويّ الذي تعمل فيه.
ففي مقالة للكاتب “يوسف حجازي” بعنوان “صادق جلال العظم يحسم أمره وينتقل إلى التنظير العلنيّ للسُّنة ولفكر ” الإسلام السّياسيّ البزنسي” نشرت في موقع “جدليات”.
بداية يُعرّف “العظم” الإسلام السّياسيّ على الشّكل التالي: “الإسلام السّياسيّ هو إيديولوجيّة تعبويّة شديدة التأثير مستمدّة ومُشكّلة، بصورة انتقائيّة وجزئيّة، من بعض نصوص الإسلام المقدّسة ومن عدد من مرجعيّاته التراثيّة ومن عدد من سوابقه التّاريخيّة، ومن حكاياته المتداولة أباً عن جدّ، ومن حاضر العجز الإسلاميّ المزمن، ومن هامشيّة العالم الإسلاميّ والعالم العربيّ في مجريات التّاريخ الحديث والمعاصر. ومن المهمّ جدّاً عدم الخلط أبداً بين الإسلام السّياسيّ، كما وصفته، وبين التديّن الشعبيّ التلقائيّ والعفويّ للمسلمين عامّة، وهو التديّن الذي يتمحور في جوهره حول العبادات والمعاملات لا أكثر”.
ويصنّف “العظم” أطراف الصراع في الشّرق، وخاصّة الإسلام السّياسيّ الدّاخلة في الصراع مع أنظمتها، على النّحو التّالي:
يعتبر “العظم” أن أولى التيّارات الإسلاميّة تمثّل تلك التي خلقتها الأنظمة السّياسيّة في المنطقة لنفسها تلائم سلطتها وهي “أنظمة سياسيّة وحكومات وأجهزة دولة ومؤسّسات دينيّة رسميّة تديرها نُخب من رجال الدّين، تعمل كلّها على الدّفاع عمّا يمكن تسميته هنا بـ”إسلام الدّولة الرّسميّ” وعلى صياغة تعاليمه وتوجّهاته صياغات مناسبة، وفقاً للظروف والأحوال المتبدّلة وعلى نشره وبثّه عبر الوسائل المتوفّرة للدّولة وأجهزتها. ونجد النموذج الأعلى لهذا النوع من الإسلام في إسلام البترودولار لدولتين مثل العربيّة السّعوديّة وإيران. وهو إسلام سياسيّ مدعوم جيّداً جدّاً ليس محلّيّاً وإقليميّاً فقط، بل ودوليّاً أيضاً وفي شتّى أنحاء العالم، مدعوم بجبروت الدّولة المعنيّة وبأس أجهزتها الأمنيّة المتنوّعة وبقوّة أموالها الوفيرة وإغراءاتها”.
ويعتقد “العظم” أنّ كلّ دولة من دول العالم الإسلاميّ؛ “طوّرت نسخة مناسبة وطبعة ملائمة من إسلام الدّولة السّياسيّ الرّسميّ لها، تستعملها في خدمة مصالحها الحيويّة وغير الحيويّة داخليّاً وخارجيّاً من ناحية أولى، وفي مناوأة وإحباط المصالح المشابهة لدول أخرى منافسة لها أو متخاصمة معها، من ناحية ثانية”.
ويطلق “العظم” على النّوع الثّاني من الإسلام السّياسيّ اسم إسلام “التكفير والتفجير”، ويعتبره بعيداً من إسلام الدّولة الرّسميّ. وهو الإسلام السّلفيّ الأصوليّ الذي يسعى إلى فرض حاكميّته على الدّولة والمجتمع. ويتميّز بأحكامه الجائرة والقاسية، المتضمّنة الزَّجر والمنع وتقييد الحُرّيّات وخاصّة على النساء. ويعتبر نفسه في عداء وصراع مع جميع التيّارات السّياسيّة العلمانيّة والدّينيّة الأخرى المخالفة له في التوجّه والرؤية. كما أنّه يهدّد بإرجاع ما يدّعيه “الأمّة” إلى عصر “السّلف الصالح” بكلّ السبل الممكنة، وأوّلها اعتماد العنف “الجهاد” وسيلة أساسيّة في تحقيق أهدافه وتصفية خصومه. ولا مجال للمهادنة مع هذا التيّار الذي يُعَدُّ إرهاباً معمّماً بلبوس إسلاميّ. ويستمدّ هذا التيار قوّته من الحاضنة الشّعبيّة التي كوّنها علماؤها وشيوخها عبر وسائل الإعلام والمدارس الدّينيّة، وهم بالأساس تمرّدوا على أنظمتهم التي كانت ترعاهم وأهّلتهم لتكون تيّاراً معارضاً ضمن الحدود التي رسمتها لهم، لضمان حاكميّتها وديمومتها. ويعتبر “العظم” أنّ هذا التيّار الإسلاميّ هو الذي “احتلّ الكعبة سنة 1979 بقيادة جهيمان العتيبي، واغتال الرّئيس أنور السّادات سنة 1981، وخاض معارك إرهابيّة دمويّة خاسرة في سوريّا ومصر والجزائر، وهو الإسلام الذي نفّذ ضربات 11 سبتمبر/ أيلول سنة 2001 داخل الولايات المتّحدة الأمريكيّة”.
فيما يصف “العظم” التيّار الإسلاميّ الثّالث والذي يبقى في ترقّب وتأمل لمؤدّى الصراع عن كثب، ليطرح نفسه بقوّة في المشهد السّياسيّ والاقتصاديّ، ويطلق عليهم اسم “إسلام الطبقات الوسطى والتّجاريّة، أو إسلام البازار والأسواق المحلّيّة والإقليميّة والمعولمة، إسلام غرف التّجارة والصناعة والزّراعة والمصارف وبيوتات المال، إسلام البيزنس/ إسلام الأعمال”، الباحثة عن فرص الاستثمار وتوظيف أموالها في بيئة آمنة. أي أنّها تشكّل “البورجوازيّة الإسلاميّة”، إن صحَّ التعبير.
ومعروف عن هذا التيّار هوسه بالمال والأعمال، وعدم انجراره خلف البروباغاندا التي ينشرها كلّ من التيّارين السّابقين حول مقولات “الإسلام هو الحلّ” أو إطلاق صفات “المشركين والكفّار والملحدين والمرتدّين والزنادقة والمنافقين والمجوس والرّوافض والنّواصب وأحفاد القردة والخنازير” وما إلى ذلك من التسميّات التي تطلقها على كلّ من يعارضها، بل تميل إلى إبداء الاعتدال في آرائها وأفكارها، وتبدي رغبة للعمل في أجواء الاستقرار السّياسيّ والسّلم المجتمعيّ والأمن.
وفي حوار لكاتب هذه السّطور مع أحد وجوه هذا التيّار في مدينة حلب، وهو من العائلات الحلبيّة العريقة المعروفة بتديّنها الوسطيّ، سألته: هل كان لحركة الإخوان المسلمين أيَّ امتداد داخلَ العوائل البورجوازيّة الحلبيّة، وبالتالي هل سخّرتها لأهدافها، أم العكس صحيح؟. فردَّ بالقول: “لقد استثمرت البورجوازيّة الحلبيّة المعتدلة في دينها تيّار الإخوان المسلمين، وخاصّة في الأحداث التي شهدتها سوريّا في فترة الثمانينات من القرن الماضي. ومن ثمّ انكفأت عنهم عندما كانت الغلبة للنّظام. فعوائل “صايم الدّهر، شبارق، قلعجي، فلاحة، وغيرها” لم تدخل في تحالفات مع الإخوان، بل استخدمتها أدواتَ ضغط على النّظام لتمرير مصالحها. غير أنّ المعادلة اختلفت مع الثّورة السوريّة التي تحوّلت لاحقاً إلى أزمة، حيث استهدفت هذه الطبقة من كلا الطرفين؛ النّظام والإخوان، رغم أنّها اتّخذت موقفاً محايداً منهما”.
ويعتبر عدد من الباحثين في حركات الإسلام السّياسيّ في منطقة الشّرق الأوسط، أنّ تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيّا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، رسّخت مفهوم “الإسلام المعتدل” والذي نجح في قيادة الدّولة التركيّة وإحراز تطوّر ملحوظ فيها على المستوى السّياسيّ والاقتصاديّ والمجتمعيّ، وأنّه يمكن اعتبارها نموذجاً للإسلام في دول المنطقة.
غير أنّ أحداث الرّبيع العربيّ، أكّدت أن لا إسلام معتدل على الإطلاق، وأنّ كلّ دعوة من هذا القبيل، إنّما تعد ترويجاً لفكرة استبدال استبداد سياسيّ باستبداد دينيّ – سياسيّ لا يَقُلُّ عنه ممارسة في كبت الحُرّيّات وقمع الشعوب.
لا ننطلق هنا من مُسلّمات وبديهيات وأحكام سياسيّة مُسبّقة، بل من وقائع أثبتت أنّ ما يُسمّونه “الإسلام المعتدل” هو عمقٌ إستراتيجيّ لـ”إسلام التكفير والتفجير”، والعكس صحيح أيضاً. فاحتضان تركيّا معظم تيّارات الإسلام السّياسيّ السَّلفي والمتطرّف والتكفيريّ، واعتبار نفسه المركز لتنظيم الإخوان المسلمين العالميّ، ودعمه اللا محدود لحركات الإسلام الإرهابيّ أمثال “داعش وجبهة النصرة”، إنّما يفنّد كلّ التكهّنات التي كانت تدور حول وجود إسلام معتدل في المنطقة. وانخراط تركيّا في عدّة ساحات ملتهبة في المنطقة، إنّما تؤكّد على حقيقة أنّ فكرة إقامة دولة على أسس دينيّة لا يمكن لها أن تنتج سوى استبداد شنيع يستند إلى فتاوى فقهاء التكفير والتحريم، التي تحلّل القتل والسَبي والغنائم تحت مُسمّيات مختلفة، وتدحض كلّ دعوى من قبيل “أنّ الإسلام هو الحلّ” و”دستورنا هو الإسلام”.
لا يمكن الجمع بين أفكار التيّارات الإسلاميّة السّياسيّة التي تدّعي إيمانها بـ”العلمانيّة” و”الدّولة المدنيّة”، فما أن تمتلك القوّة العسكريّة والاقتصاديّة الكافية، حتّى تسفر عن وجهها الحقيقيّ، لتعود بالمجتمعات إلى عهود السّيف والبرقع وجَزِّ الرّؤوس وأكل أكباد البشر والتنكيل بكلّ معارضيها. وما تلك الشعارات التي تطلقها، إلّا لخداع النّاس، وهي مجرّد مناورات سياسيّة للوثوب إلى السُّلطة، وتجربة سيطرة حركة “طالبان” المتطرّفة على أفغانستان بعد انسحاب القوّات الأمريكيّة إثبات على ما قلناه. كما أنّ ما يجري في الشّمال السّوريّ والواقعة تحت سيطرة التيّارات الإسلاميّة التكفيرية والاحتلال التركيّ من ممارسات وبرعاية من تركيّا، ومحاولة بناء إمارات إسلاميّة متطرّفة، إنّما تمثّل انعكاساً مباشراً للأفكار التي تعتنقها تلك التيّارات.
لقد أسفرت إيديولوجيّة الإسلام السّياسيّ عن حقيقتها بشكل سافر في كلّ من مصر وتونس، لتصادر حُرّيّات المجتمع وتلغي التعدّدية وتفرض النّمطيّة الإسلاميّة الواحدة كأسلوب وحيد، دون أن تترك خيارات أخرى أمام المجتمعات، وتشهر أحكامها القراقوشيّة تحت اسم الدّين، لتحارب كلّ من يعارضها أو ينتقد ممارساتها. ما دفع بغالبيّة فئات وشرائح لتتمرّد عليها وتنهي سلطتها بمثل ما جاءت بها أيضاً. ولم تعمد تلك الحركات – أي الإخوان في كلّ من مصر وتونس – إلى إجراء مراجعة نقديّة لمسيرتها خلال الرّبيع العربيّ، بل انحدرت نحو التطرّف أكثر واستخدمت سلاح الإرهاب والتّحالف مع القوى الأجنبيّة في تهديد استقرار بلدانها، واعتبار نفسها عابرة للحدود والجغرافيا الوطنيّة، لتفرّخ العديد من الحركات الإرهابيّة تحت مُسمّى “الجهاد”.
ففي تونس أعلن “راشد الغنّوشي” زعيم “حركة النّهضة الإسلاميّة – جناح الإخوان المسلمين في تونس” أنّ حركته “اختارت السّياسة وليس الإيديولوجيا في الحكم”. لكن عاد “الغنّوشي” بعد قرار الرّئيس التّونسيّ “قيس سعيِّد” حلّ الحكومة وتجميد عمل المجلس النّيابيّ، إلى تهديد الدّولة باللّجوء إلى العنف كوسيلة للتمسُّك بالسُّلطة.
ويُحدّد الدّكتور “صادق جلال العظم” مصير الإسلام السّياسيّ في كلّ من مصر وتونس بالقول: “واضح أنّ الإسلام السّياسيّ الإخوانيّ الذي طفا على السّطح في كلّ من مصر وتونس، يجد نفسه اليوم في وضع لا يُحسَد عليه من التخبّط والتعثّر والتّناقض والإخفاق والغضب الشّعبيّ المتصاعد، كما يواجه إحراجاً كبيراً في كيفيّة تعامله مع النّوعين الآخرين من الإسلام السّياسيّ ومع متطلّبات كلّ منهما المتناقضة، وأقصد إسلام البترودولار الرّسميّ بنموذجيه السّعوديّ والإيرانيّ من جهة، وإسلام التكفير والتفجير بنموذجه الجهاديّ الجوّال والعابر للحدود والمتمركز في المناطق النائية”. ويبدو أنّ الإسلام السّياسيّ في البلدين قد فضّل الخيار الثّاني، وهذا ديدنه والنّسغ الذي رضع منه منذ نشأته.
فيما يرى أنّ إسلام البيزنس، طبقات رجال الإعمال وأصحاب رؤوس الأموال والبورجوازيّة التّجاريّة، ستسود في فترة ما بعد إنهاء المقتلة السّوريّة والبدء بإعادة إعمار سوريّا، وستتصدّر المشهد السّياسيّ والاقتصاديّ، لتُزيح كلّ تنويعات الإسلام المتطرّف والسّلفيّ.
خاتمة:
إنّ الإسلام السّياسيّ في تعبيراته السّياسيّة والحالة الكمونيّة التي يحتفظ بها طيلة تاريخه الموغل في القدم، واستخدامه التقيّة السّياسيّة عقيدة أساسيّة له في معظم المراحل التي مرّ بها، وخاصّة في أوقات الانكفاء والعمل السُرّيّ، لجأت إلى تفخيخ المجتمع برمُته، وإبقائه في حالة من الرُّهبة والخوف من المستقبل، وابتعاده عن إبداء أيّ مقاربة إيجابيّة من المختلف معها بالفكر والتوجّه السّياسيّ، فدائماً تجده يوسمها بـ”الرّدة” و”الكفر”. فكان سلاحها الأمضى “التكفير والتفجير”، مشهّراً ضد الدّولة والمجتمع، على حدٍّ سواء، دون أن تفصل بين الأنظمة التي تحكم قبضتها على الدّولة والمجتمع. فدخلت في صراعات عميقة مع مختلف التيّارات السّياسيّة والفكريّة والثّقافيّة في المجتمع، ولتفتح جروحاً أخرى في جسد الشّرق الأوسط المُثقل بالطعنات، وتكون عوناً للأنظمة الاستبداديّة لتُطيل من أعمارها.
كما أنّ كلّ دعوة إلى إصلاح دينيّ لحركات الإسلام السّياسيّ لا تغدو كونها أكثر من مضيعة للوقت، فلا رجاء من تيّارات تؤمن بالعنف وحده وسيلة لإعادة المجتمعات إلى حظيرتها الدّينيّة ذات اللّون الواحد. فيما أيَّ طرح لتغيير الفكر الإسلامويّ نحو “العلمانيّة والدّولة المدنيّة”، هو مجرّد منح جرعة إضافيّة لتطرّفها، والتجربة السّوريّة مع “جبهة الخلاص الوطنيّ” وطرحها برنامجاً أقرب إلى العلمانيّة والدّولة المدنيّة، يُعَدُّ مثالاً صارخاً في هذا الصدد. فسرعان ما انقلبت حركة الإخوان المسلمين على برنامج الجبهة، واستخدمته وسيلة لإعادة ترتيب أوراقها، ولتعود حليمة إلى عادتها القديمة، وتؤسّس عشرات الحركات المسلّحة الإرهابيّة، لتعيث خراباً ودماراً في الجغرافيا السّوريّة.
الخلاصة أنّ الصراع في المنطقة صراع نفوذ سياسيّ بين دول وليس بين قوميّات أو طوائف، أو أديان وشعوب.
المراجع:
____________________
1 – مقالة الكاتب “محمّد المحمود” بعنوان “الدّين والسّياسة في الشّرق الأوسط” نشر على موقع “الحُرّة”.
2 – دراسة للكاتب السّوريّ “محمّد ديبو” بعنوان “الدّين والسّياسة: أيُّ علاقة؟” نشرت على موقع صحيفة “العربي الجديد”.
3 – دراسة للكاتب السّوريّ “ياسين الحاج صالح” بعنوان ” تأمّلات في السُّلطة الدّينيّة والسُّلطة السّياسيّة ومعنى العلمنة في عالم الإسلام السُنّي” نشرت في موقع “الحوار المتمدّن”.
4 – دراسة للكاتب السّوريّ “جاد الكريم الجباعي” بعنوان ” وجهات نظر.. هل الدّين سلطة في ذاته؟”.
5 – مقالة للكاتب والحقوقيّ اليمنيّ “حسين الوادعي” بعنوان “نحن وثنائيّة الاستبدادين الدّينيّ والسّياسيّ” نشرت على موقع “درج” الإلكترونيّ.
6 – مقالة للكاتب “يوسف حجازي” بعنوان “صادق جلال العظم يحسم أمره وينتقل إلى التنظير العلنيّ للسُّنة ولفكر “الإسلام السّياسيّ البزنسي” نشرت في موقع “جدليّات”.