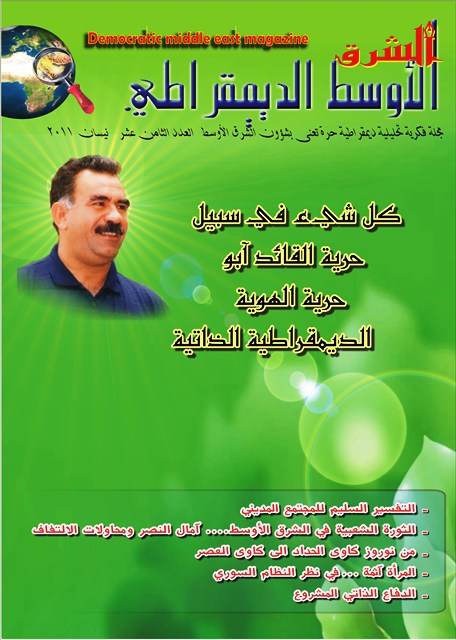مسارات صراع أمريكا مع روسيّا والصين في منطقة الشرق الأوسط
جميل رشيد

مسارات صراع أمريكا مع روسيّا والصين في منطقة الشرق الأوسط
جميل رشيد

تمهيد:
تشكّل العلاقات الرّوسيّة – الصّينيّة، وكذلك الصّينيّة – الأمريكيّة، عُقدة الحلّ والرَّبط والتكوين للعلاقات الدّوليّة في وقتنا الرّاهن، وهي تؤسّس بحكم ديناميّاتها مسارات دائمة ومتجدّدة في أشكال الاصطفافات والتّحالفات بين الدّول. لقد توضّحت الخطوط المحدّدة لنماذج جديدة في العلاقات الدّوليّة أكثر على وقع الصراع والتّنافس القائم بين القوى الثّلاث المتصدّرة للمشهد الدّوليّ، وعلى مستويات عدّة، وكان أهمّها الاقتصاديّ والعسكريّ والسّياسيّ، وتدور حول الفكرة الغائيّة المتمثّلة بالاستحواذ على مناطق نفوذ في مختلف مناطق العالم. ففيما تسعى الولايات المتّحدة الأمريكيّة جاهدةً للاحتفاظ بمكانتها وتصدّرها المشهد الدّوليّ، كقوّة مستفردة بالسيطرة المباشرة وغير المباشرة على عالمنا الرّاهن، فإنّه في الوقت نفسه، تنذر بأفول شمس القطبيّة الأحاديّة التي تحكّمت فيها الولايات المتّحدة الأمريكيّة بهندسة العلاقات الدّوليّة بما يتوافق مع مصالحها كدولة عظمى، من حيث امتلاكها القدرات والمؤهّلات التي يجعل لها حضوراً قويّاً ومباشراً في معظم الملفّات السّاخنة والحيويّة في العالم.
أظهرت كلٌّ من روسيّا والصّين فاعليّة كبيرة في توسيع نفوذهما في العالم، وخاصّة في منطقة الشّرق الأوسط والمحيط الهادئ، في تحدٍّ للنّفوذ الأمريكيّ، وهو ما ولّد صراعاً خفيّاً وظاهراً في الوقت نفسه، حول كسر الهيمنة الأمريكيّة على العالم، وإعادة روسيّا لدورها الفاعل على الصعيد العالميّ كقوّة عظمى، فيما يسعى التّنين الصّينيّ إلى التسلّل بهدوء في عدّة مناطق في العالم، مستخدماً قوّته الاقتصاديّة النّاعمة، غير معتمد على التدخّلات العسكريّة الفظّة التي ترتَدُّ عليها سلباً، لتعيد إحياء مشروعيها “طريق الحرير” و”الحزام”، كاستراتيجييّة اقتصاديّة وسياسيّة في الوصول والسيطرة على مصادر الطّاقة وطرق المواصلات البرّيّة والبحريّة والمضائق، والتحكّم بالأسواق العالميّة، عبر اتّباعها أسلوب المزاوجة بين الإنتاج الرّأسماليّ والتخطيط المركزيّ الاشتراكيّ، لتغدو قوّة اقتصاديّة تهدّد أكبر اقتصاديّات العالم، وعلى رأسها الولايات المتّحدة الأمريكيّة.
فيما تحاول روسيّا “البوتينيّة” إعادة لعب دور الاتّحاد السّوفيّيتي السّابق، عبر تدخّلها في مناطق الصراع السّاخنة، عسكريّاً وسياسيّاً، وتسجيل حضور مكثّف لها في مختلف الأزمات، وبالأخصّ في منطقة الشّرق الأوسط، معتمدة على قوّتها العسكريّة المتطورة، لتعيد تثبيت قدمها في عدّة مناطق وتغيّر معادلات التّوازن على الأرض.
اتّجهت روسيّا في السنوات الأخيرة نحو التصعيد العسكريّ مع الولايات المتّحدة في عدّة مناطق حيويّة من العالم، كجزء من استراتيجييّتها العسكريّة والاقتصاديّة والسّياسيّة في توسيع مناطق نفوذها، عبر التّواجد في البحار والمحيطات، لتنافس فيها الولايات المتّحدة الأمريكيّة، لتبدأ بتنفيذ الخطوات الأولى لمشروعها الأوراسي، عبر التمدّد شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، وتشكيل تحالفات إقليميّة تحدُّ من الهيمنة الأمريكيّة على العالم، باحثة عن جغرافيّات تمارس فيها دورها كدولة تتحكّم في رسم مستقبل العلاقات والتّوازنات السّياسيّة والعسكريّة الدّوليّة. وجعلت روسيّا من منطقة الشّرق الأوسط وتركيّا وإيران والصّين نقاط ارتكاز أساسيّة لها في تنفيذ مشروعها، ليذهب العديد من الباحثين إلى حدّ الاعتقاد بأنّها تحاول استعادة دور الاتّحاد السوفياتي السّابق في إطار السيطرة وتوسيع مناطق النفوذ، ولكن تحت عنوان “المشروع الأوراسي” الذي يجمع بين قارتي آسيا وأوروبا.
لعلّ المصالح الاقتصاديّة والوصول إلى مصادر الطّاقة من نفط وغاز، هي المحرّك والدّافع الأكبر للقوى العالميّة للدّخول في صراعات مختلفة، وخاصّة في منطقة الشّرق الأوسط، ما جعل منها ساحة دائمة للصراع والحروب والنّزاعات الدّوليّة، لتنعكس سلباً على استقرار بلدانها، بعد أن أدّى تدخّل تلك القوى في دول المنطقة إلى ترسيخ أنظمة استبداديّة فُرِضَت على شعوبها دون إرادتها، لتستفرد بالقرارات المصيرية لبلدانها وتقيّد حُرّيّة مجتمعاتها، وتبدّد قدراتها الاقتصاديّة في حروب ونزاعات وهميّة لا طائل منها.
سنحاول في دراستنا أن نعرج على المفاصل الرّئيسيّة للصراع الخفيّ بين كلّ من الصّين والولايات المتّحدة الأمريكيّة، وتصاعد نبرة المواجهة بينهما، رغم أنّها لا تزال في حدود الصراع الاقتصاديّ، والذي قد يتطوّر إلى صراع عسكريّ مع تحوّل الصّين إلى قوّة اقتصاديّة عظمى، تزاحم الولايات المتّحدة في العديد من مناطق العالم الحيويّة. كما أنّ التّعاون الرّوسيّ – الصّينيّ في عدد من المجالات، وخاصّة العسكريّة والسّياسيّة والاقتصاديّة، يصل في بعض الأحيان إلى التّكامل، ما يجد تعبيراته المباشرة في منطقة الشّرق الأوسط، على اعتبار أنّها المنطقة الأكثر أهميّة لجميع القوى. وسنتطرّق إلى آفاق تطوّر هذا الصراع، وهل سيصل إلى مرحلة المواجهة العسكريّة، وانعكاسه على شعوب المنطقة في خضّم حالة الارتياب واللا استقرار التي تعيشها بعد اندلاع ربيع ثورات الشّعوب في العقد الثّاني من الألفيّة الثّانيّة.
كما نجد أنّه من المهمّ قراءة هذا الصراع وتأثيراته على القضيّة الكُرديّة وحلولها، على اعتبار أنّها قضيّة تستقطب اهتمام القوى العظمى. وكذلك معرفة كيفيّة تناول تلك القوى للقضيّة من منطلق قضيّة شعب يسعى نحو حُرّيّته، وكذلك تبيان المقاربات التي أبدتها مقارنة بمواقفها وقراراتها الإقصائيّة السّابقة. وكذلك تقتضي الضرورة البحثيّة أن نلقي ضوءاً على الدّور التركيّ في هذا الصراع، بعد أن غدت عنصراً يهدّد استقرار المنطقة، عبر تدخّلها المباشر في عدد من دول المنطقة مثل سوريّا وليبيا واليمن والعراق.
استراتيجييّة الصّين في منطقة الشّرق الأوسط
بعد أن حقّقت الصّين تطوّراً اقتصاديّاً مذهلاً مع بداية الألفيّة الثّانية، رافقها حاجتها الماسّة إلى مصادر الطّاقة وأسواق لتصريف بضائعها، غدت تتحرّك كقوّة “إمبرياليّة” تبحث عمّا يمدّ اقتصادها بشريان الحياة. فاتّجهت أنظارها نحو منطقة الشّرق الأوسط وأولتها أهمية كبيرة، لما تمتلكه المنطقة من 56% من الاحتياطات العالميّة من النفط، وكذلك من الغاز. واعتمدت الصّين من البداية استراتيجييّة هادئة وناعمة لتمدّدها، وعدم افتعالها أيّ بؤر توتّر على غرار الولايات المتّحدة الأمريكيّة وروسيّا، وربّما هذا مردّه بالدّرجة الأولى التقاليد والثّقافة الكونفوشيوسيّة الصّينيّة، وإدغامها مع الأيديولوجيّة الشّيوعيّة التي انتهجتها بعد انتصار ثورتها الاشتراكيّة على يد مؤسّسها ماوتسي تونغ، كما أنّ العامل الدّيمغرافي ساعدها في تجاوز العديد من المنغّصات، حيث أنّها استندت إليه في بناء قوّة الصّين الاقتصاديّة والعسكريّة.
تسعى الصّين دائماً إلى الوصول إلى مصادر الطّاقة في منطقة الشّرق الأوسط، وقد وضعتها استراتيجييّة عليا لها، حيث أنّ المنطقة توفّر ما نسبته 47% من إمداداتها النّفطيّة، وتخشى انقطاع هذا الإمداد بفعل التدخّلات الأمريكيّة في المنطقة. ووفق ما ذكره “الدّكتور خضر عباس عطوان” في دراسة له بعنوان “مستقبل العلاقات الأمريكيّة الصّينيّة”، التّابع لـ”مركز الإمارات للدّراسات والبحوث الاستراتيجييّة” في فبراير/ شباط 2021، حول سعي الصّين لديمومة تدفّق النّفط إليها من دول الخليج العربيّ، أنّها تضع ضمن استراتيجييّاتها طويلة الأمد إعداد قوّة ردع أمام أمريكا، إلى جانب تحفيز دول الخليج على فتح أسواقها أمام البضائع الصّينيّة المنافسة لمثيلاتها الأمريكيّة. ورغم أنّ الصّين ليست في الموقع الذي يؤهّلها فتح أيّ مواجهة عسكريّة مع الولايات المتّحدة، إلا أنّها تعتمد على أساليب الرّدع الدّبلوماسية كسبيل للحفاظ على مكاسبها في المنطقة، وتحاول إمساك العصا من المنتصف، دون الإخلال بتوازنات القوى في المنطقة.
لم تعتمد الصّين أيّ سياسة عسكريّة للتوسّع في الشّرق الأوسط، ولم تجنح إلى إقحام نفسها في الصراعات الدّاخليّة في بلدان المنطقة مثل الولايات المتّحدة، كذلك لم تتورّط في دعم طرف على حساب طرف آخر، بل حافظت على مسافة واحدة من جميع أطراف الصراع في المنطقة وفي الدّولة الواحدة. حتّى في ملفّ الأزمة السّوريّة، التي سنأتي إليه لاحقاً بشيء من التّفصيل، لم تنتهج سياسات عدائيّة للنّظام أو المعارضة مثل روسيّا، رغم استخدامها لحقّ النّقض (الفيتو) عدّة مرّات ضدّ مشاريع قرارات غربيّة في مجلس الأمن لصالح النّظام السّوريّ، وهذا ما أكسبها قوّة سياسيّة إضافيّة إلى رصيدها السّياسيّ، ومنحها قدرة أكبر للتحرّك بكافّة الاتّجاهات للحفاظ على مصالحها الحيويّة في سوريّا المستقبل.
تتبنّى الصّين مواقف سياسيّة أكثر اعتدالاً من الأزمات التي تمرّ بها المنطقة، وحصرتها في المقاربة التّجارية والاقتصاديّة، على عكس الولايات المتّحدة الأمريكيّة، فهي لم تطوّر عقيدة عسكريّة توسّعيّة لدى الجيش الصّينيّ، وحصرت مهامه في الدّفاع عن الصّين ضدّ الأخطار والتهديدات الخارجيّة، ولم تعتبر في يومٍ ما أنّ أمنها القوميّ يتهدّد في منطقة الشّرق الأوسط أو أيّ منطقة أخرى في العالم على غرار أمريكا.
وفق هذه الاستراتيجييّة التي اتّبعتها الصّين؛ جنحت معظم دول المنطقة إلى إقامة علاقات اقتصاديّة وتجارية واسعة معها، وفتحت أبوابها على مصراعيها أمام تدفّق بضائعها ذي التكلفة المنخفضة، ما حدا بتلك الدّول، وخاصّة دول الخليج العربيّ إلى النّظر إليها كبديل عن الولايات المتّحدة الأمريكيّة كشريك تجاريّ أوّلي من جهة، ومن جهة أخرى لاستخدامها كورقة ضغط ضدّ الأخيرة، رغم القناعة الرّاسخة لديها بأنّها لا يمكن أن تستغني عن الولايات المتّحدة في قضايا الأمن والدّفاع عن أنظمتها. وهذه المسألة بالذّات تشكل تحدّياً كبيراً لأمريكا أمام تغلغل الصّين في اقتصاديّات دول المنطقة، واعتمادها عليها في تدفّق السّلع والبضائع الصّينيّة، مقابل انكماشها – نوعاً ما – في التّعامل الاقتصاديّ مع أمريكا. ولا يبدو، حسب خبراء ومحلّلين اقتصاديّين وسياسيّين يراقبون صعود نجم الصّين في المنطقة، أنها – أي الصّين – في وارد التدخّل في الشؤون الدّاخليّة لبلدان الشّرق الأوسط، أو حمايتها من الهزّات العنيفة التي تتعرّض لها أنظمتها من الدّاخل، بفعل الحراك الدّاخليّ لشعوبها ضدّها، في ذات الوقت تجد تلك الدّول نفسها مطمئنّة نوعاً ما من أن تحاول الصّين فرض أيديولوجيّتها الشّيوعيّة عليها أو تملي عليها شروطها في إقامة علاقات اقتصاديّة متطوّرة معها.
من جانبها تراقب الولايات المتّحدة الأمريكيّة عن كثب وبحذر وقلق شديدين التدخّلات الرّوسيّة في المنطقة، وكذلك التمدّد الاقتصاديّ الصّينيّ، ما حدا بقائد القيادة المركزيّة الأمريكيّة الجنرال “كينيث ماكينزي” إلى القول في عام 2020 بأنّ “الشّرق الأوسط أصبح ساحة صراع بين القوى الكبرى، حيث تسعى الصّين لاستخدام ثقلها الاقتصاديّ في بناء رأس جسر استراتيجييّ طويل المدى، بينما تنشر روسيّا قدرات عسكريّة ضئيلة، لكنّها عالية التركيّز لعرقلة الولايات المتّحدة”.
ملامح السّياسة الرّوسيّة في الشّرق الأوسط:
اتّبعت روسيّا سياسة عسكريّة فظّة للتدخّل في شؤون المنطقة. فمنذ بداية تدخّلها في سوريّا نهاية سبتمبر/ أيلول 2015، بدا واضحاً من خلال تتبّع مساراته غياب رؤية استراتيجييّة روسيّة حيال المنطقة، في حين كانت أكلافها الاقتصاديّة باهظة على الخزينة الرّوسيّة، التي تعاني بالأصل من صعوبات كبيرة بفعل تَبِعات العقوبات الاقتصاديّة والتّجارية التي فرضتها عليها الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبيّ بعد ضمّها لشبه جزيرة القرم إلى أراضيها.
انعكست الأزمة الاقتصاديّة الرّوسيّة على دورها السّياسيّ والعسكريّ في سوريّا بشكل مباشر، فرغم أنّها لم تتمكن من الوصول والسّيطرة على منابع النّفط السّوريّ إلا بنسبة ضئيلة، ولم تتمكّن من إنجاز حلّ سياسيّ ناجز، واقتصر دورها على تعزيز مكانة النّظام ومحاولة تعويمه وشرعنته من جديد، إلا أنّها اصطدمت بالرّفض الأمريكيّ المثبّط لدورها، فعوّلت على تحقيق نصر عسكريّ نهائي يُعيدُ لها مكانتها، إلا أنّها لم تحقّق أهدافها، رغم أنّها وقّعت مع النّظام اتّفاقيّات استراتيجييّة طويلة الأمد، كاتّفاقيّة استثمار ميناء طرطوس ومطار دمشق الدّوليّ وغيرها من الاتّفاقيّات السُرّيّة التي لم يُكشف عنها إلى الآن، إلا أنّها منيت بخسائر كبيرة أيضاً، وظلّ المُنجز الرّوسيّ في سوريّا مرهوناً بالموافقة والرّضا الأمريكيّ، دون أدنى شكّ.
لكن الصحيح أيضاً أنّ تمدّد روسيّا في منطقة الشّرق الأوسط مبعثه ليس فقط ملء الفراغ الإقليميّ الذي تركته أمريكا بعد انسحاب قوّاتها من العراق، واعتمادها على حكومات دول وأنظمة موالية لها في الحفاظ على مصالحها الاستراتيجييّة، بل نلمس رغبة روسيّة أوسع وأكبر في استعادتها لمكانتها كـ”قوّة عظمى”، فهي تسعى جاهدة للوصول إلى مصادر الطّاقة والحفاظ على مكانتها في سوق بيع الأسلحة كمصدّر أساسيّ لها، وهو ما وضعه الرّئيس الرّوسيّ فلاديمير بوتين ضمن استراتيجييّة بلاده في التنافس مع الولايات المتّحدة الأمريكيّة، فقد حظي بتوقيع عقود بيع منظومات صواريخ “إس – 400” مع كلّ من السّعوديّة وتركيّا، فيما وقّع مع تركيّا اتّفاقيّة السيل التركيّ للغاز الرّوسيّ ووصوله إلى الأسواق الأوروبيّة عبر الأراضي التركيّة، بعد أن تعذّر مرور أنابيبه عبر أوكرانيا، إلى جانب توسيع مجال التّبادل التّجاريّ بينها وبين دول المنطقة، وتطلّعها إلى تنشيط علاقاتها العسكريّة والاقتصاديّة مع كلّ من مصر ودول الخليج العربيّ.
وحدّدت الدّراسة التي أعدّها “مركز الإمارات للدّراسات والبحوث الاستراتيجييّة” دوافع روسيّا للتوجّه نحو منطقة الشّرق الأوسط، وتتمثّل في:
1 – إجبار الولايات المتّحدة على تفهُّم مصالح روسيّا، والتّعامل معها كقوّة عظمى مكافئة لها.
2 – الدّوران حول جبهة الناتو الجنوبيّة في كلّ من منطقتي شرق وجنوب المتوسّط (سوريّا وليبيا).
3 – تعزيز العلاقات الرّوسيّة مع إيران، ومحاولة إطالة أمد الخلاف بين تركيّا وحلف الناتو.
كما تحاول روسيّا التموضع في المنطقة والوصول إلى المياه الدّافئة، إن كان في البحر الأبيض المتوسّط أو الخليج العربيّ، إلا أنّ ما يَحدُّ من التمدّد الرّوسيّ في المنطقة قدرتها المحدودة على فرض سيطرتها على البحار، لافتقارها إلى تلك القوّة البحريّة من حاملات طائرات وسفن حربيّة كبيرة، تؤهّلها للسيطرة على الممرّات والطرق البحريّة التّجاريّة، لتستخدمها ورقة ضغط ضدّ أمريكا والدّول الغربيّة عموماً، فهي تمتلك عدداً محدوداً من تلك القطع البحريّة وحاملات الطائرات، لا يمكنها من المناورة وفرض سيطرتها ونفوذها في البحار والمحيطات كما هي أمريكا. فالصراع بين القوّة البرّيّة المتمثّلة بـ”التيلوكراتيا” والقوّة البحريّة المتمثّلة بـ”التالاسوكراتيا” هي راجحة لصالح أمريكا، حسب خبراء استراتيجييّين.
واتّضح خلال العشر سنوات المنصرمة من عمر ثورات “ربيع الشّعوب” في المنطقة، أنّ روسيّا انحازت إلى الحكومات وأنظمة الحكم، دون أن تراعي مطالب الشّعوب في التحرّر والدّيمقراطيّة، وهي لطالما استخدمتها أمريكا ورقة تُضعِف الدّور الرّوسيّ، وتَحدُّ من قدرتها على كسب حلفاء جُدُد إلى جانبها.
الاستراتيجييّة الرّوسيّة – الصّينيّة المشتركة ضدّ أمريكا في الشّرق الأوسط:
انبرت العديد من الأوساط البحثيّة والمسؤولين الأمريكان إلى انتهاج لهجة التحذير ضدّ مخاطر التمدّد الرّوسيّ والصّينيّ على مصالح الولايات المتّحدة في العالم وخصوصاً في الشّرق الأوسط، وإن كان البعض يميل إلى استخدام خطاب أقلَّ حدّيّة من غيره، إلا أنّها في النّهاية ترفع الإشارات الحمراء أمام صعود قوى أخرى مناوئة لأمريكا، ما يُهدّد تفرّدها بقيادة العالم، على عكس توقّعات منظّري العولمة من ميشيل فوكوياما ومن قبله زبيغنو بريجنسكي مستشار الأمن القوميّ الأمريكيّ في عهد الرّئيس الأسبق جيمي كارتر، من أنّ أمريكا تسيّدت قيادة العالم دون منازع. فالتحرّكات الرّوسيّة بالتنسيق مع الصّين في عدّة ملفّات دوليّة شائكة ومعقّدة كالملفّ السّوريّ، واتّخاذهما مواقف مشتركة في مجلس الأمن، وضعت أمريكا في وضع لا تُحسد عليه، وبدأت تحتسب لكلّ خطوة لهما، للحفاظ على موقعها وريادتها في العالم.
التّنسيق الرّوسيّ – الصّينيّ لم يتجاوز الجوانب التكتيكيّة، ولم تتطوّر بعد لتصلَ إلى توحيد مواقفهما وجهودهما في القضايا الاستراتيجييّة، وجلّ ما تسعيان إليه هو لجم وتحديد قوّة الولايات المتّحدة في منطقة الشّرق الأوسط، دون الذّهاب بعيداً في فتح مواجهة دبلوماسيّة وعسكريّة معها في المنطقة. فالإيديولوجيّة والثّقافة الصّينيّة بحدّ ذاتها تشكل مانعاً أمام الحكومة والقيادة الشّيوعيّة الصّينيّة في إثارة أيّ نزاع وصراع عسكريّ مفتوح مع الولايات المتّحدة، في حين أنّ روسيّا هي الأخرى غير قادرة على الصعيد الاقتصاديّ في تصعيد المواقف مع الولايات المتّحدة. فالإحصائيّات التي نشرتها العديد من مراكز الأبحاث الاستراتيجييّة حول القُدُرات العسكريّة الصّينيّة والرّوسيّة وكذلك الاقتصاديّة، تشير إلى فوارق كبيرة بينها وبين الولايات المتّحدة، فضلاً عن أنّ العقوبات التي تفرضها الأخيرة على الدّولتين، تشكّل عاملاً ضاغطاً عليها وتَحدُّ من قدراتها على المناورة والتصعيد معها.
مظاهر وتجلّيات العلاقات الرّوسيّة – الصّينيّة في الشّرق الأوسط:
شكّلت الأزمة السّوريّة عامل جذبٍ واستقطابٍ للقوى الأجنبيّة نحو المنطقة، وغدت بؤرة صراع قويّة بينها، لتعمد إلى تحشيد قوّاتها العسكريّة فيها، سعياً منها إلى زيادة نفوذها. فرغم أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة تحتفظ بقوّات برّيّة وبحريّة دائمة التّواجد في عدد من دول المنطقة، مثل الأسطول السّادس العائم في البحر الأبيض المتوسّط، إلى جانب قاعدة (العديد) في قطر، وكذلك “إنجيرلك” في تركيّا وغيرها، إلا أنّها زجّت بأعداد إضافيّة من قوّاتها في المنطقة، تحسّباً لفقدانها مواقعها الحيويّة والاستراتيجييّة. بالمقابل وجدت كلّ من روسيّا والصّين في اندلاع الأزمة السّوريّة، مناسبة في توجيه قوّاتها العسكريّة إلى سوريّا، حيث أجرت البحريّتان الرّوسيّة والصّينيّة أوّل مناورات مشتركة في البحر الأبيض المتوسّط، في 11 مايو/ أيّار 2015، في مسعى منهما إلى مدّ نفوذهما في منطقة الشّرق الأوسط. وشاركت الصّين بعدد محدود من قوّاتها العسكريّة في معارك مع الجيش السّوريّ في بعض مناطق سوريّا، كجزء من التزاماتها في مكافحة الإرهاب، والقضاء على مجموعات الإيغور الصّينيّة التي تقاتل ضدّ قوّات النّظام السّوريّ ضمن مجاميع إرهابيّة.
أحياناً تظهر خلافات وتناقضات بين القوّتين – أي روسيّا والصين – تجعلهما تخطّطان بشكل منفصل، مثل تركيّز الصّين على استخدام ثقلها الاقتصاديّ للتمدّد في المنطقة وبناء تحالفات تجاريّة واقتصاديّة بمعزل عن روسيّا، وفي أحيان كثيرة قد تتناقض هذه المساعي مع المصالح الرّوسيّة في الشّرق الأوسط، مثل توقيع الصّين عدّة اتّفاقيّات مع دول الخليج وإيران لتوريد النّفط، وفتح أسواقها أمام البضائع الصّينيّة. فيما تركّز روسيّا على جعل المنطقة سوقاً لبيع أسلحتها وتوسيع أنشطتها العسكريّة، إلى جانب دورها في التحكّم بأسواق النّفط العالمية لوجودها ضمن منظمة أوبك. ويلاحظ العديد من الخبراء العسكريّين أنّ الوجود العسكريّ الرّوسيّ في سوريّا يهدف بالدّرجة الأولى إلى إعادة تنشيط دورها العسكريّ في المنطقة، وتثبيت أقدامها في المياه الدّافئة فيها، بعد أن تراجع الدّور الرّوسيّ كثيراً بعد انهيار الاتّحاد السوفييتي السّابق، وكذلك لمدّ الذّراع الرّوسيّة إلى ليبيا، التي تعتبر هي الأخرى الخاصرة الإفريقيّة الشّماليّة، حيث تخطّط روسيّا أن تصل عبرها إلى المغرب العربيّ وإفريقيّا، وكثّفت تواجدها في البحر الأبيض المتوسّط لضمان تنقّل أساطيلها العسكريّة، حتّى بات بإمكانها الوصول إلى السّواحل المصريّة، بعد أن طوّرت علاقاتها معها في الفترة الأخيرة، وأقامت معها مناورات عسكريّة مشتركة، فضلاً عن التّعاون في مجال استكشاف النّفط في المياه الإقليميّة المصريّة، وهو ما تعتبره الولايات المتّحدة تحدّياً كبيراً لها، لطالما أنّها خاضت صراعات عديدة في ليبيا باستخدامها قوّات حلف الناتو، وكذلك في مصر، بعد أن أعادت نظام الرّئيس عبد الفتّاح السيسي إلى السُّلطة ودعمت انقلابه على حركة الإخوان المسلمين. ويرى العديد من المراقبين أنّ روسيّا غير قادرة على ملء الفراغ الاستراتيجييّ في المنطقة عبر قوّتها العسكريّة فقط، وأنّ قدراتها الاقتصاديّة لا تسعفها على إعادة بناء البلدان التي أتى عليها الدّمار والخراب بعد أن شهدت ثورات شعبيّة، دون التّشارك والاعتماد على الصّين لتتمكّن من إغلاق المجال الحيويّ أمام الولايات المتّحدة. فاعتمادها على القوّة الاقتصاديّة الصّينيّة؛ يؤهّلها للدخول إلى المنطقة عبر البوّابة الاقتصاديّة أيضاً وليس العسكريّة فقط، وهو ما تعوّل عليه روسيّا في ترسيخ تواجدها في المنطقة.
تحدّيات العلاقات الرّوسيّة – الصّينيّة وانعكاسها على منطقة الشّرق الأوسط:
رغم العديد من القضايا التي تتقاطع فيها تجمع الصّين مع روسيّا، إلا أنّه ثمّة وقائع على الأرض، تجعل من علاقاتهما هشّة وقابلة للتصدّع في أيّ وقت كان، وهو ما تعتبره الولايات المتّحدة أنّها مسألة جديرة بالاهتمام ويمكن توسيع الهوّة والفجوة بين الطرفين، عبر استمالة روسيّا وبثّ التّناقضات مع الصّين. فرغم أنّ التّعاون العسكريّ بين روسيّا والصّين يعتبر أهمّ أوجه التّعاون والعلاقات بينهما، حيث وقّع الجانبان اتّفاقيّات ثنائيّة في مجال التسليح والاقتصاد والتنقيب عن النّفط والغاز، إذ تستحوذ الصّين على 45 في المئة من صادرات السّلاح الرّوسيّ، حيث حصلت على أنظمة الصّواريخ المضادة للطائرات من طراز “إس – 400” وطائرات من طراز “سوخوي 35” لتسليح جيشها، فيما جرى توقيع اتّفاقيّة تقضي بتوريد 38 مليار طن سنويّاً من الغاز الرّوسيّ لمدّة 30 عاماً، عبر تشغيل خطّ نقل الغاز الرّوسيّ للصّين “قوّة سيبيريا” الذي دخل حيّز العمل في مايو/ أيّار 2019.
وتعتبر الصّين أكبر المستوردين للنّفط والغاز الرّوسيّ، في حين أنّ حجم الاستثمارات الصّينيّة في الاقتصاد الرّوسيّ لا تتجاوز 3 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبيّة في روسيّا، حسب دراسات اقتصاديّة روسيّة وصينيّة.
تكتنف العلاقات الرّوسيّة – الصّينيّة العديد من الخلافات العميقة التي تجعل منها قابلة للتفكّك، فتجد روسيّا نفسها قلقة إزاء الهيمنة الاقتصاديّة الصّينيّة في عدّة مناطق من العالم، وذلك من خلال مشروعها “طريق الحرير/ الحزام الاقتصاديّ الأرو – آسيوي”، وهو مشروع عابر للحدود والقارات يهدف إلى شقّ طرق ومدّ سكك حديد وخطوط نفط وغاز، وإنشاء غيرها من البنى التحتيّة في عدّة بلدان، ويمتدّ من آسيا الوسطى مروراً بدول الشّرق الأوسط وصولاً إلى أوروبا، حيث بدأت الصّين بإنشاء جسور معلّقة مائيّة وبريّة بينها وبين باكستان والهند، وكذلك أنشأت خطّ للسك الحديديّة يربطها بإيران التي تعتبر المورّد الرّئيسي للنّفط لها، حيث تستورد من إيران ما نسبته 64% من حاجاتها النّفطيّة. وخلافها مع روسيّا حول سيبيريا، يضع تلك العلاقات على مفترق صعب للطرفين، فالكثافة الدّيمغرافية الصّينيّة في سيبيريا “مساحتها 13.1 مليون كم2، ويقطن فيها 39 مليون روسيّ مقابل 100 مليون صيني”، وطمعها بالمواد الأوّليّة فيها، تشجّع ملايين الأيدي العاملة الصّينيّة على الهجرة إليها، لدرجة وصفها بعض الخبراء بأنّها “الأرض الصّينيّة الجديدة”، خاصّة أنّ اليد العاملة الصّينيّة رخيصة ووفيرة، وتمتلك تكنولوجيا وخبرات.
وحسب الدّراسة التي أعدّها “مركز الإمارات للدّراسات والبحوث الاستراتيجييّة”، أنّ “خلافات الصّين وروسيّا خارج الشّرق الأوسط، تظلّ سبباً محتملاً لعرقلة التوصّل إلى استراتيجييّة مشتركة بعيدة المدى في المنطقة. فمؤخّراً، تصاعدت الخلافات بين الجانبين حول مشاعر تاريخيّة متّصلة بمدينة فلاديفوستوك الحدوديّة، التي يعتبرها الصّينيّون جزءاً من بلادهم. وإضافة إلى ذلك، زاد الغضب الصّينيّ جرَّاء تعزيز روسيّا مبيعات الأسلحة للهند المنخرطة في نزاع حدوديّ ساخن مع الصّين، إلى جانب تأخير إرسال أنظمة الدّفاع الجوّيّة (S – 400) التي اشترتها الصّين”.
غير أنّ القضيّة الأكثر حساسيّة بالنّسبة للصّين، يتمثّل في التّقارب الأمريكيّ – الرّوسيّ لـ”كبح جماح الصّعود الصّينيّ”. وقد نبّه عدد من المسؤولين الصّينيّين من خطورة حدوث مثل هذا التّقارب والتّنسيق الاستراتيجييّ، طالما أنّ روسيّا انتهجت مواقف غير ثابتة إزاء عدد من القضايا العالميّة، إن كان في موافقتها على قرار الحرب على العراق عام 2003، وفي الأزمة السّوريّة، حيث أبدت مقاربات أكثر إيجابيّة تجاه الولايات المتّحدة وموافقتها الضمنيّة على تحجيم الدّور الإيرانيّ في سوريّا، من خلال صمتها على الضربات الجوية التي توجّهها إسرائيل إلى المواقع العسكريّة الإيرانيّة في سوريّا. وفي هذا الإطار صرّح وزير الخارجيّة الأمريكيّ الأسبق “هنري كيسنجر” في يوليو/ تمّوز 2018 لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسيّة بالقول: “أرى إنّه من المفيد إنشاء تحالف مع روسيّا لكبح جماح الصّين الاقتصاديّ وتطويقها، كي تحافظ الولايات المتّحدة على مركزها في قيادة العالم”. وتعزّزت هذه القناعة أكثر أثناء ولاية الرّئيس السابق دونالد ترامب، خاصّة في القمّة التي عقدها الرّئيسان الرّوسيّ والأمريكيّ في 16 يوليو/ تموز 2018 في العاصمة الفنلنديّة هلسنكي.
يذهب العديد من المراقبين السّياسيّين إلى الاعتقاد أنّ جهود توحيد استراتيجييّة روسيّة – صينيّة مشتركة في الشّرق الأوسط مضادّة للولايات المتّحدة لن ترى النّور في المستقبل القريب، رغم “وجود ومؤشّرات على تقارب على المستوى التكتيكيّ قصير المدى في عددٍ من ملفّات المنطقة كالأزمة السّوريّة”.
الخطط الأمريكيّة لمواجهة تمدّد الصّين وروسيّا في المنطقة:
تسود الأوساط البحثيّة الأمريكيّة، وكذلك دوائر القرار الاستراتيجييّ الأمريكيّة، عدّة تكهّنات وسيناريوهات حول سُبُل لجم التمدّد الرّوسيّ والصّينيّ في العالم وخاصّة في منطقة الشّرق الأوسط. وتعتقد بعضها أنّ احتواء إيران من خلال العودة إلى الاتّفاق النّوويّ ورفع العقوبات عنها، بعدما ألغى الرّئيس الأمريكيّ السابق ترامب الاتّفاقيّة، إنّما يغلق الأبواب أمام روسيّا والصّين، ويجعل وصول الإمدادات النّفطيّة إلى الصّين، كما أنّ استبعاد أيّ تصعيد عسكريّ مع روسيّا والصّين في المنطقة، ولو على مستوى حشد القوّات، واعتماد الدّبلوماسيّة كسبيل لعرقلة جهود الدّولتين في التمدّد وإقامة علاقات اقتصاديّة وتجاريّة، ذات جدوى أكثر من المواجهة العسكريّة، لطالما اعتمدت الولايات المتّحدة أسلوب تقليص النّفقات العسكريّة، إلى جانب عدم اعتمادها على النّفط في الشّرق الأوسط بشكل استراتيجييّ بعد بدء استخراجها النّفط الصخريّ في أراضيها.
ويعتقد المسؤولون في الولايات المتّحدة أنّ تقديم التطمينات إلى دول المنطقة للحفاظ على أمن واستقرار بلدانها، وتشكيل تحالفات إقليميّة معها، يُساهم في قطع الطريق على موسكو وبكّين في ملء الفراغ الاستراتيجييّ في المنطقة، على أن تكون واشنطن نقطة جذب لدول المنطقة. وفي هذا الإطار تجهد الإدارات الأمريكيّة المتعاقبة إلى توقيع اتّفاقيّات دفاع مشتركة مع عواصم المنطقة، وإقامة قواعد عسكريّة على أراضيها لحمايتها من التمدّد الإيرانيّ في الظاهر، إلا أنّها في ذات الوقت تهدف إلى تطويق كلّ من روسيّا والصّين اقتصاديّاً وعسكريّاً. فرغم أنّ السّعوديّة وقّعت اتّفاقيّة شراء منظومة صواريخ “إس – 400” من روسيّا، إلا أنّ الولايات المتّحدة جمّدت الاتّفاقيّة إلى حدّ ما. كما أنّ تدفّق السّلع والبضائع الصّينيّة إلى أسواق دول الخليج العربيّ، لم تؤثّر على مشتريات تلك الدّول من السّلع الأمريكيّة، خاصّة أنّها تمتاز على الصّينيّة بالجودة.
فالخيارات التي طرحتها الولايات المتّحدة للجم تحرّكات كلٍّ من روسيّا والصّين في المنطقة، وضعت الدّولتين أمام اختبارات صعبة، منها عدم تمكّنها من تجاوز القيود التي تفرضها الأولى على حُرّيّة الملاحة البحريّة، وعدم قدرة الأخيرتين على توفير البدائل المناسبة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، خاصّة بعدما أوحى تدخّلهما في سوريّا وليبيا، أنّهما تسعيان إلى إحراز مكاسب آنيّة سريعة، حيث غاب عن تحرّكهما أيّ رؤية استراتيجييّة بعيدة المدى، على عكس الولايات المتّحدة.
وحسب دراسة بحثيّة لمركز “الأهرام”؛ تسعى الولايات المتّحدة في الفترة الأخيرة إلى “طرح بدائل لمشاريع تكنولوجيّة تكون لها تَبِعات أمنيّة على مصالح الولايات المتّحدة ودول المنطقة، وكذلك مراقبة مبادرة الحزام والطريق، ووضع عراقيل أمامها”.
وحسب تقييم الدّراسة؛ فإنّ “المنظور الأمريكيّ، وفق مراكز بحثيّة أمريكية وحتّى بعض دوائر القرار الأمريكيّ؛ أنّ الصّين هي القطب الثّاني في النّظام العالميّ الجديد، وروسيّا قوّة راجحة فقط، وفي هذا ثمّة اتّفاق بين الأوساط البحثيّة الصّينيّة مع واشنطن حول هذه الرؤية”.
ويعتقد العديد من الخبراء الاستراتيجييّين أنّ القوّة الأمريكيّة وقيادتها للعالم، إنّما تنبع من قوّتها العسكريّة والاقتصاديّة، حيث استطاعت الولايات المتّحدة الأمريكيّة خلال السنوات الأولى من الألفيّة الثّانية أن تنتج بمفردها 25% من جملة النّاتج العالميّ، رغم أنّ عدد سكّانها لا يتجاوز 5% من عدد سكّان العالم، فيما لديها ما يقارب من 250 ألف جنديّ منتشرين حول العالم وفي أكثر من /700/ قاعدة عسكريّة موزّعة على /130/ دولة.
ويؤكد الباحث “محّمد عطيّة محمّد ريحان” في دراسة له بعنوان “التجربة الصّينيّة وتحدياتها المستقبلية”، أنّ الصّين واعتماداً على بنيتها الجغرافيّة الواسعة، وكذلك ثقافتها العريقة، حقّقت تنمية اقتصاديّة كبيرة، وهو “ما يشير إلى دخولها آفاق جديدة، لتغدو قوّة دوليّة عظمى على حساب الولايات المتّحدة، رغم أنّ الأخيرة ستحتفظ بمكانتها في النّظام الدّوليّ، ولكن بهيمنة أقلّ في ظلّ نظام دوليّ متعدّد الأقطاب.
رغم التباين في أرقام النّاتج القوميّ بين كلّ من الولايات المتّحدة والصّين، فقد احتلّت الصّين المرتبة الأولى في معدّلات النموّ الاقتصاديّ، حيث تشير إحصاءات عامي 2007 و2007 إلى أنّ معدّل نموّ الاقتصاد الصّينيّ وصل إلى 11.9% و9.1% على الترتيب مقارنة بـ2% و1.2% للولايات المتّحدة. فيما “بلغ الفائض في الميزان التّجاريّ الأمريكيّ الصّينيّ، نحو /266.3/ مليار دولار لصالح الصّين. وفى السنة ذاتها، حلّت الصّين محلّ اليابان كأكبر دائن أجنبيّ للحكومة الأمريكيّة. وناهزت الاحتياطات الصّينيّة من العملة الأمريكيّة التريليوني دولار أمريكيّ. هذا الاحتياطي الهائل تناقض تماماً مع الوضع الماليّ للولايات المتّحدة، حيث تجاوز العجز في الموازنة الأمريكيّة التريليوني دولار أمريكيّ”.
الأرقام الواردة أعلاه تشير بكلّ وضوح إلى التحدّي الصّينيّ أمام الولايات المتّحدة، ما انعكس بشكل مباشر على خططها ومشاريعها في الشّرق الأوسط، إن كان على صعيد موارد الطّاقة، أو اعتماد دول المنطقة على الصّين في مبادلاتها التّجاريّة، لتفتح أسواق المنطقة أبوابها أمام تدفّق البضائع والسّلع الصّينيّة التي غزت كلّ العالم، بحيث باتت الولايات المتّحدة غير قادرة على مواجهتها ومنافستها، لعدّة عوامل؛ منها ما يتعلّق بالأسعار وكذلك سهولة التوصيل، والتنوّع أيضاً. فيما دخلت الصّين أسواق الاستثمارات النّفطية عبر توقيع عدّة عقود مع دول الخليج في استخراج وتصفية ونقل النّفط، وهو ما يدخل ضمن إطار المشروع الصّينيّ “طريق الحرير” وكذلك “الحزام”.
تحتفظ الولايات المتّحدة بمكانتها كدولة عظمى ذات سيادة عالميّة، وتسعى إلى فرض وضعها السّياسيّ. والخلاف الإيديولوجيّ بينها وبين الصّين، ينعكس على عدّة مناطق في العالم، وخاصّة على منطقة الشّرق الأوسط، فالصّين دولة اشتراكيّة تنتهج إيديولوجيّة شيوعيّة، فيما الولايات المتّحدة دولة رأسماليّة، وهو ما يشكل الخلاف الأكبر بينهما، من حيث التوجّهات السّياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة، رغم أنّ المفكّر عبد الله أوجلان في كتابه “دفاعاً عن شعب”، يؤكّد بشكل لا يدع مجالاً للشكّ؛ بأنّ “الصّين زاوجت بين الرّأسماليّة والاشتراكيّة”. وهذا بحد ذاته يؤسّس لنموذج خاص وفيه الكثير من التعقيد على صعيد العلاقات الدّوليّة ومعادلات الصراع والتّعاون والنّفوذ في المنطقة والعالم. والاعتقاد الأقوى أنّ هذه الأسباب دفعت راسمي السّياسة والاستراتيجييّة الأمريكيّة إلى إبداء مقاربات إيجابيّة من روسيّا، على حساب الصّين.
تشير الإحصاءات إلى أنّ التّعداد السكّاني الضخم للصّين يمثّل “قوّة شرائيّة هائلة تصل إلى 25% من حجم الطلب العالميّ، وهو في الوقت ذاته قوّة إنتاجيّة داعمة للقدرة التّنافسيّة للمنتجات الصّينيّة في الأسواق العالميّة، حيث وصل حجم النّاتج الإجمالي السّنويّ للصّين إلى 17.6 تريليون دولار عام 2014، وهو بطبيعة الحال يعكس قوّة الإنتاج الصّينيّ ودرجة تنوّعه”.
ويعتقد العديد من خبراء الاقتصاد أنّه رغم تباطؤ معدّلات النموّ الاقتصاديّ الصّينيّ، لكنّه يواصل الارتفاع. ويعزو بعضهم أنّ هذا النموّ مرجعه بالأساس يتمثّل في “نموّ قطاع الإنتاج الصناعيّ. وكذلك فإنّ الحجم الهائل للصادرات الصّينيّة، والذي وصل إلى حوالي 4.3 تريليون دولار أمريكيّ عام 2014، يعكس درجة انتشار وتنوّع الصادرات الصّينيّة وقدرتها الفائقة على اختراق الأسواق العالميّة”.
و”على صعيد الجدارة الّسياديّة والائتمانيّة للاقتصاد الصّينيّ؛ فإنّ حجم احتياطات الصّين من النّقد الأجنبيّ هائل ووصل إلى 4 تريليون دولار أمريكيّ عام 2014، وهو ما يعني أنّ الصّين لا تحتاج إلى الأموال اللّازمة لتحقيق معدّلات النموّ الحالية بصورة متواصلة لسنوات قادمة، بقدر ما تحتاج إلى التكنولوجيا والإدارة الحديثة والعمالة الماهرة”. وهو دأب القيادة الصّينيّة في فتح استثمارات في عدّة بلدان، وخاصّة في منطقة الشّرق الأوسط، لقربها من مصادر الطّاقة والمواد الأوّليّة، وكذلك من الأسواق، ومثال ذلك المدينة الصناعيّة الصّينيّة في بلدة “عدرا” في ريف دمشق بسوريّا، والتي سنأتي إليها لاحقاً.
ويشير بعض المهتمّين بالنموّ الاقتصاديّ الصّينيّ، أنّ “الاقتصاد الصّينيّ الذي لم يكن يتجاوز 6.7% من حجم الاقتصاد الأمريكيّ عند انهيار الاتّحاد السوفييتي نهاية عام 1991، في حين أنّه أصبح الآن يناهز نصف حجم الاقتصاد في الولايات المتّحدة”. وأنّه إذا ما استمرّت معدّلات النموّ في البلدين على وتيرتها الحالية؛ فإنّ الصّين ستزيح الولايات المتّحدة عن قمّة النّظام الاقتصاديّ الدّوليّ في غضون عقدين من الزّمن، على أقصى التّقديرات”.
تنامي القوّة العسكريّة الصّينيّة وتدخّلها في المنطقة:
إنّ ما يميّز التفوّق الأمريكيّ وفرض قوّتها العالميّة، امتلاكها القوّة العسكريّة التي تؤهّلها الوصول إلى جميع بقاع العالم، بعد أن نشرت قوّتها لتتحكّم في مجمل الصراعات العالميّة وتكون حاضرة فيها بقوّة، وليس أقلّها في الشّرق الأوسط والمحيط الهادئ. فالترسانة العسكريّة الضخمة للولايات المتّحدة وامتلاكها أحدث أنواع الأسلحة، يمنحها قوّة السّيادة العالميّة، وهو ما شكّل قوّة ردع كبيرة أمام روسيّا والصّين، ما دفعهما إلى عدم استسلامها أمام القوّة العسكريّة الأمريكيّة، فعمدت إلى زيادة الإنفاق العسكريّ وزيادة تسليح جيوشهما، والسعي إلى تعزيز قدراتهما العسكريّة. فعمدت الصّين إلى زيادة ميزانيّة الدّفاع لديها، وربط قرار الجيش في الحرب والسّلم باللّجنة المركزيّة للحزب الشّيوعيّ الحاكم، ما يفسّر تصاعد النّبرة العسكريّة الصّينيّة أمام التّهديدات والتحدّيات الأمريكيّة المستمرّة. فالثّابت في السّياسة الدّوليّة أنّ النموّ والتوسّع الاقتصاديّ والتّجاريّ، إن لم يرافقه قوّة عسكريّة تحمي طرق التّجارة ومصادر الطّاقة وكذلك الأسواق، فإنّها عُرضة للاهتزاز في أيّ وقت كان.
فرغم أنّ الصّين دولة نوويّة، وامتلكت السّلاح النّوويّ منذ فترة طويلة، وباعتبارها ليست قوّة إمبرياليّة مثل الولايات المتّحدة، إلا إنّ سلاحها ظلّ في إطار قوّة الرّدع وحماية الصّين من التهديدات الخارجيّة، ولم تعمد الصّين إلى انتهاج سياسة نشر قوّاتها العسكريّة في بحار ومحيطات العالم، بهدف حماية حلفائها الإقليميّين، والحالة السّوريّة وإرسالها قوّة دوليّة إلى السودان في دارفور، قد تبدو استثناءً في السّياسة الخارجية والعسكريّة الصّينيّة، فيما ينظر إليها آخرون أنّه تحوّل استراتيجييّ في توجّهات الصّين نحو فرض نفسها قوّة دوليّة. وعلى ضوء ذلك دأبت في السّنوات الأخيرة إلى رفع التّعاون العسكريّ بينها وبين روسيّا، فحصلت منها على منظومة صواريخ “إس – 400” المتطوّرة.
و”تُشير التّقارير الصادرة عن الكونغرس الأمريكيّ إلى أنّه ما بين عامي 2000 – 2009 زادت معدّلات الإنفاقات العسكريّة الصّينيّة بنسبة 11.8%. وحسب ما ورد في تقارير وزارة الدّفاع الأمريكيّة “البنتاجون” لعام 2009، فإنّ حجم الإنفاق العسكريّ الصّينيّ قد بلغ 150 مليار دولار أمريكيّ. ويرى محلّلون أنّ جهود الصّين فيما يتعلّق بتطوير طائرات الشبح وصواريخ قادرة على ضرب أهداف متحرّكة في البحر؛ دليلٌ على التزام الصّين بتحديث تكنولوجيّتها الدّفاعيّة.
وحسب خبراء عسكريّين، فقد احتلّ الجيش الصّينيّ المرتبة الثّالثة بعد الجيش الرّوسيّ من حيث الإنفاق العسكريّ، حيث ارتفع بمعدّل 12.2% لتصل ميزانيّة الدّفاع إلى 126 مليار دولار أمريكيّ، حسب الأرقام الرّسميّة الصّينيّة، والتي قد تكون في الواقع أعلى من ذلك. كذلك عدد القوّات الصّينيّة بلغ عدداً مذهلاً للغاية، فقد وصل إلى /2.285.000/ فرد مع /2.300.000/ فرد احتياط.
وبحسب “تقرير معهد ستوكهولم لدراسات السّلام لعام 2015” فإنّ الموازنة العسكريّة الأمريكيّة بلغت /610/ مليار دولار أمريكيّ، بينما احتلّت الصّين المرتبة الثّانية بموازنة عسكريّة قُدّرت بحوالي /216/ مليار دولار أمريكي. إلا أنّ الملاحظ أنّ الموازنة العسكريّة الأمريكيّة إلى انخفاض، بينما الموازنة العسكريّة الصّينيّة إلى ارتفاع؛ وبحسب تقرير لنفس المعهد لعام 2013، نجد أنّ الولايات المتّحدة قد احتلّت المرتبة الأولى في قائمة الدّول الأكثر إنفاقاً على التسلّح، ولكن بموازنة عسكريّة قدرها /640/ مليار دولار أمريكيّ. فيما أكّد التقرير أنّ الصّين احتلّت المرتبة الثّانية ولكن بموازنة عسكريّة قدرها /188/ مليار دولار أمريكيّ، وهو ما يؤكّد أنّ الموازنة العسكريّة الأمريكيّة قد انخفضت بمعدل 7.8% مقارنة بمثيلتها لعام 2012. في حين ارتفع الإنفاق العسكريّ الصّينيّ بمعدّل 7.4% مقارنة بالعام ذاته.
إنّ حجم تخفيض الميزانيّة العسكريّة الأمريكيّة، يشير، حسب خبراء استراتيجييّين، إلى تراجع الدّور الأمريكيّ العالميّ، وصعود قوى أخرى منافسة لها، وبكلّ قوّة، مثل الصّين وروسيّا، وهو ما وجد تجلّياته القويّة في منطقة الشّرق الأوسط، إن كان في الانتشار العسكريّ لروسيّا والصّين، أو في تنامي قدراتهما الاقتصاديّة في السيطرة على مصادر الطّاقة وأسواق المنطقة.
فاعليّة الصّين ضمن دول الـ(BRICKS) ومعاهدة (شنغهاي):
تلعب الصّين دوراً مركزيّاً وهامّاً ضمن تحالف مجموعة الـ”بريكس” المشكّلة من خمسة دول، هي: “روسيّا، الصّين، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا”. وهو تكتّل اقتصاديّ بالدّرجة الأولى، يحاول جاهداً التملّص من القوانين والعقوبات التي تفرضها الولايات المتّحدة عليها. كما أنّه يهدف للتحرّر من الهيمنة الأمريكيّة وتأسيس نظام عالميّ جديد ثنائي القطبيّة.
فدول “البريكس” تعتمد بالدّرجة الأولى على قوّة الاقتصاد الصّينيّ، إضافة إلى القوّة العسكريّة الرّوسيّة، ومصادر المواد الأوّليّة من الدّول الثّلاث، وهي تشكّل تحدّياً كبيراً أمام الولايات المتّحدة. وقد قال أحد المسؤولين العسكريّين الكبار في النّظام السّوريّ أثناء بداية اندلاع الثورة السّوريّة، ردّاً على سؤال حول تحوّل الثّورة إلى أزمة، والدّمار وعدد القتلى التي تخلّفها الأزمة، فردّ قائلاً: “إنّ دول البريكس وإيران وفنزويلا ستساعدنا في إعادة إعمار سوريّا، وأمّا الضحايا؛ فليرحمهم الله”. وهذا يفسّر سلوك دول مجموعة البريكس على الوقوف مع الأنظمة الاستبدادية في المنطقة وعدم إيلائها أهميّة لتطلّعات شعوب المنطقة، رغم أنّ الدّول الغربيّة هي الأخرى لا تُعيرُ هذه المطالب أيضاً أهميّة كبيرة، بل تنظر إليها من زاوية مصالحها الاقتصاديّة والسّياسيّة والعسكريّة.
وتحاول دول البريكس فتح ثغرات في الحصار الذي تفرضه الولايات المتّحدة وأوروبا عليها، من خلال أعمال أقرب إلى القرصنة، منها مثلاً تحدّي العقوبات التي فرضتها الولايات المتّحدة على إيران في تصدير نفطها، وخاصّة إلى سوريّا، التي هي أيضاً مشمولة بحزمة كبيرة من العقوبات الاقتصاديّة والعسكريّة، فلا تزال إيران تصدّر نفطها إلى سوريّا والصّين ودول أخرى، تحت حماية عسكريّة من روسيّا، وغطاء سياسيّ صينيّ في المحافل الدّوليّة كمجلس الأمن الدّوليّ وما إلى ذلك من المؤسّسات الدّوليّة. فالحمائيّة التي تقدّمها مجموعة دول البريكس لبعض دول المنطقة، تعتبر زعزعة لنمط العلاقات التي فرضتها الولايات المتّحدة في المنطقة والعالم. ووفق الأرقام التي أوردتها عدد من مراكز الأبحاث في الولايات المتّحدة، فمن المتوقّع أن تزداد واردات الصّين النّفطية من دول المنطقة لتتجاوز الولايات المتّحدة في العام 2030، وهذا يشير بزيادة حركة التّبادل الاقتصاديّ بين دول الخليج العربيّ والصّين إلى مستويات غير مسبوقة، ما ينعكس في تعزيز دور دول البريكس في المنطقة أيضاً.
لقد حاولت الصّين منذ بداية نهوضها الاقتصاديّ أواخر سبعينات القرن الماضي، وخاصة مع دخولها عام 1979، إلى تأسيس كيانات سياسيّة واقتصاديّة إقليمية ودولية، تواجه فيها سعي الولايات المتّحدة لتحجيم دورها الدّوليّ. ففي 15 يونيو/ حزيران عام 2001 أسسّت “منظّمة شنغهاي للتّعاون”، وضمّت في البداية ستّة دول آسيويّة، هي كلّ من: “الصّين، كازاخستان، قيرغيزستان، روسيّا، طاجيكستان، وأوزبكستان”، لتنضمّ إليها كلّ من “الهند وباكستان” في عام 2017 في قمّة أستانا، ولتصبح قوّة اقتصاديّة شبه متكاملة تفرض سيادتها على بحر الصّين والمحيط الهندي والهادئ، وتتحكّم في الممرّات البحريّة الحيويّة.
وتتمحور أهداف المنظّمة “حول تعزيز سياسات الثّقة المتبادلة وحسن الجوار بين دول الأعضاء، ومحاربة الإرهاب وتدعيم الأمن ومكافحة الجريمة وتجارة المخدّرات ومواجهة حركات الانفصال والتطرّف الدّينيّ أو العرقيّ. وكذلك التّعاون في المجالات السّياسيّة والتّجاريّة والاقتصاديّة والعلميّة والتّقنيّة والثّقافيّة، وكذلك النّقل والتّعليم والطّاقة والسّياحة وحماية البيئة، وتوفير السّلام والأمن والاستقرار في المنطقة”.
التّحالفات الإقليميّة التي أسّستها الصّين، فتحت شهيّة عدد من دول منطقة الشّرق الأوسط على التوجّه نحوها، لتهدّد بها الولايات المتّحدة الأمريكيّة. فوزير الخارجيّة السّوريّ السّابق “وليد المعلّم” حدّد في بداية الأزمة السّوريّة خيارات النّظام السّوريّ في التوجّه شرقاً وجنوباً، منوّهاً إلى تحالف النّظام مع الصّين وروسيّا لمواجهة ما سمّاه بـ”الحرب الكونيّة التي تشنها الدّول الغربيّة على بلاده”، وأشار أنّه – أي النّظام – “سينسى أنّ أوروبا وأمريكا كانت موجودة على الخارطة العالميّة”، وفق تعبيره.
كذلك لا تزال تركيّا تتّبع سياسة ازدواجيّة بين روسيّا وأمريكا، لمدّ نفوذها في منطقة الشّرق الأوسط. فقد هدّد الرّئيس التركيّ أردوغان أكثر من مرّة بنيّة بلاده الانضمام إلى منظّمة “شنغهاي”، في تحدٍّ لتخفيف الضغوط الأمريكيّة على نظامه الذي يحاول العمل ضدّ المصالح الاستراتيجييّة الأمريكيّة في المنطقة. وحاولت الصّين من جهتها استمالة تركيّا للانضمام للمنظّمة، غير أنّ قضيّة المسلمين الإيغور ممّن جنّدتهم تركيّا ضدّ الصّين وزجّت بهم في الحرب الأهليّة السّوريّة، حَدَتْ بالصّين إلى توخّي الحذر في مساعي تركيّا، فضلاً عن العلاقات الاستراتيجييّة العميقة التي تربطها بالولايات المتّحدة والتي لا يمكنها الفكاك منها بسهولة. ورغم أنّ تركيّا عمدت في الفترة الأخيرة إلى تسليم عددٍ من عناصر الإيغور المنظّمين إلى الصّين، على حساب فتح الأسواق التركيّة أمام الاستثمارات الصّينيّة، إلا أنّ الصّين لا تزال متخوّفة من التحرّك التركيّ في المنطقة، التي تميل إلى تنفيذ الإملاءات الغربيّة، وخاصّة الأمريكيّة.
تجلّيات الصراع الرّوسيّ الصّينيّ مع الولايات المتّحدة في سوريّا:
ظهر الانقسام الرّوسيّ الصّينيّ مع الولايات المتّحدة الأمريكيّة أكثر خلال الأزمة السّوريّة، وهو صراع عكس في طيّاته حالة شديدة التعقيد، اتّسمت ببروز حالة من التّعارض بين مصالح الدّول العظمى، حيث غدا صراعاً دوليّاً واضح المعالم. ورغم وقوف الصّين في ظلّ روسيّا، إلى أنّ تصاعد الصراع بين روسيّا والولايات المتّحدة، حَوّلَ سوريّا إلى ساحة لتصفية الحسابات الدّوليّة بينهما، وليرسم فيها ملامح نظام دوليّ جديد ينبثق من معاناة الشّعب السّوريّ.
التّوافقات الجزئيّة بين روسيّا والولايات المتّحدة على عدد من الملفّات السّاخنة في الأزمة السّوريّة، لم يخفّض من حدّة تنافسهما وصراعهما في سوريّا. فرغم أنّ روسيّا وأمريكا وقّعتا على عدّة اتّفاقيّات في سوريّا؛ منها ما سُمّيت باتّفاقيّة “كيري – لافروف” عام 2016 على تقاسم مناطق النّفوذ في شرق الفرات وغربها، وكذلك التّفاهمات بينهما على تقاسم السّيطرة في الأجواء وعدم الاحتكاك بين قوّاتهما على الأراضي السّوريّة.
لكن يبدو أنّ تلك المعادلة قد تغيّرت نوعاً ما بعد الاحتلال التركيّ لمناطق سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، إثر انتشار القوّات الرّوسيّة شرقيّ الفرات، حيث حصلت احتكاكات متكرّرة بين قوّات البلدين. كما أنّ صراعهما للاستحواذ على المناطق الغنيّة بالثروات مثل النّفط والغاز والسّدود المائيّة، حدا بالمنطقة لتصل إلى حدّ الاشتباك المباشر بين القوّتين. ورغم توجيه الولايات المتّحدة ضربات عسكريّة إلى بعض حلفاء روسيّا في سوريّا، مثل ميليشيّات “فاغنر” الخاصّة التي تحارب إلى جانب القوّات العسكريّة الرّوسيّة وقوّات النّظام، أثناء شنّها هجوماً على حقل “كونيكو” الغازي عام 2018، فإنّ روسيّا تنصّلت من مسؤوليّتها عن تلك الميليشيّات، ما فسّره عدد من المراقبين، بأنّ روسيّا لا تسعى للتصعيد في المناطق الواقعة تحت النّفوذ الأمريكيّ.
كذلك محاولة كلتا الدّولتين للاستفادة من الدّور التركيّ في سوريّا، دفع بتركيّا إلى تطويع قسم كبير من المعارضة السّوريّة لصالحها، لتزجّ بها في مناطق صراعها المختلفة في المنطقة والعالم. سَعَت تركيّا إلى الاستثمار في التّناقضات بين الدّولتين، لمدّ نفوذها في سوريّا، فاحتلّت مناطق واسعة من الأراضي السّوريّة. فروسيّا تسعى إلى إحداث شرخ بين تركيّا وحلف الناتو، وبالتّالي محاولة ضمّها إلى المشروع الأوراسيّ الرّوسيّ. كذلك تحتلّ تركيّا مكانة هامّة في مشروع الصّين “طريق الحرير”، فيما تحاول الولايات المتّحدة الحفاظ على تركيّا، وإبقائها ضمن استراتيجييّتها في المنطقة، والاستفادة من دورها ومكانتها الجيوسياسيّة في المنطقة. فكما عوّلت في بداية ما يُسمّى بـ”الرّبيع العربيّ” على تركيّا وحزب العدالة والتنمية في التّسويق لما أسمته بـ”الإسلام المعتدل”، كذلك لا تزال تجد فيها أداة لها جدواها في إجراء تحوّلات كبيرة في المنطقة لصالحها مشروعها “الشّرق الأوسط الجديد”.
ويعتقد “عبد الجليل زيد” في مقالة له بعنوان “الصّين والمسألة السّوريّة” نشر في موقع الجزيرة. نت بأنّ “سوريّا لا تشكّل حالة مهمّة في حدّ ذاتها بالنسبة إلى كلّ موسكو أو بكّين، إنّما هي وسيلة للاحتجاج أو جزء من استراتيجييّة أوسع لمقايضتها في قضايا أكثر أهميّة تتركّز في مناطق أكثر حيويّة. فعلى الرّغم من حجم المصالح الصّينيّة في سوريّا، لكن ذلك لا يبرّر مجازفتها بإغضاب الغرب الذي ترتبط معه بشبكة مصالح هائلة”. ويذهب العديد من المراقبين إلى التأكيد أنّ روسيّا تقايض كلّاً من الولايات المتّحدة الأمريكيّة وتركيّا على أوكرانيّا وقضيّة القرم، فيما الصّين تقايضها على تقليص نفوذها في المحيط الهادئ وقضيّة تايوان، ولا نيّة لروسيّا والصّين إلى الانخراط في صراع مفتوح مع الولايات المتّحدة في سوريّا، وجُلُّ ما يشغل بال الصّينيّين الاستحواذ على عقود إعادة إعمار سوريّا، خاصّة مع امتلاكها القدرات الاقتصاديّة التي تؤهّلها لذلك.
من جهة أخرى لا تفتح سوريّا شهيّة روسيّا والصّين، فهي ليست دولة نفطيّة مهمّة، ورغم أنّ الصّين استخدمت حقّ النّقض الفيتو عدّة مرات مع روسيّا ضدّ مشاريع قرارات في مجلس الأمن الدّوليّ تدين النّظام السّوريّ في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وأجرت مناورات عسكريّة مشتركة مع روسيّا في البحر الأبيض المتوسّط عام 2015، وأعلنت انضمامها إلى الأسطول البحريّ الرّوسيّ الذي رسى قُبالة السّواحل السّوريّة في البحر المتوسّط (ميناء طرطوس) بحاملة طائرات وعلى متنها جنود وطائرات صينيّة، إضافة إلى صواريخ موجّهة من طراز “كروز”. كما زجّت ببعض عناصرها في الحرب إلى جانب قوّات النّظام في مناطق محدودة في سوريّا، إلا أنّها لم تذهب بعيداً للإيغال أكثر في الصراع السّوريّ مثل روسيّا، وحافظت على توازن علاقاتها مع جميع الأطراف، بما فيها الولايات المتّحدة.
تنظر الصّين إلى الصراع في سوريّا من زاوية مصالحها الاستراتيجييّة مع إيران، فهي أكبر مورّد للنّفط والغاز لها، وخاصّة من حقل “بارس” في الجنوب، وبينهما خطط استراتيجييّة لمدّ أنابيب الطّاقة عبر أفغانستان، لذلك وقفت الصّين ضدّ العقوبات الأمريكيّة على إيران، وتدافع عنها في سوريّا أيضاً. ووفق النّظريّة الصّينيّة أنّ إسقاط النّظام السّوريّ، سيؤدّي حتماً إلى إضعاف إيران أيضاً، وهو جزء من الاستراتيجييّة الأمريكيّة في سوريّا، أي إضعاف إيران. والاستراتيجييّة الأمريكيّة تقضي بفرض حصار على التمدّد الاقتصاديّ الصّينيّ في المنطقة.
وفي بداية تدخّل روسيّا العسكريّ في سوريّا في نهاية سبتمبر/ أيلول 2015، أيّدت الصّين هذا التدخّل، واعتبرته مشروعاً؛ كونه جاء تلبية لطلب دولة لها سيادة وعضو في الأمم المتّحدة، وهي في هذا تريد إسباغ المشروعيّة على التدخّل الرّوسيّ، والتوافق معها لاحقاً في العديد من المواقف المشتركة.
استخدمت الصّين، وكعادتها، قوّتها الاقتصاديّة النّاعمة في دعم النّظام السّوريّ، فهي تعتبر مثلها مثل روسيّا، سوريّا نقطة ارتكاز للانطلاق نحو مصادر الطّاقة، ونقطة عبور رئيسيّة لصادراتها نحو بلدان المنطقة، فالاستثمارات الصّينيّة في سوريّا لم تتوقّف عن العمل رغم كل ما مرَّ على سوريّا من ويلات وحروب، فمدينة “عدرا” الصناعيّة التي تملك فيها الصّين عدّة شركات، تحاول توسيع نقاط عملها، ولتغدو مركزاً للتوسّع في المنطقة.
وفي دراسة للباحث “مروان قبلان” بعنوان “المسألة السّوريّة واستقطاباتها الإقليميّة والدّوليّة”، يؤكّد الباحث أنّ الأزمة والصراع في سوريّا بات “بين حلفاء كلّ من النّظام السّوريّ والمعارضة، متمثّلاً بكلّ من روسيّا وإيران، وخلفهما الصّين بشكل خفيّ، والدّول الغربيّة بقيادة الولايات المتّحدة الأمريكيّة وحلفائهما الإقليميّين”. ويخلص الكاتب إلى نتيجة بضرورة وضع نهاية لهذا الصراع و”اتّخاذه شكل المنازعة الصفريّة التي تقتضي بالضرورة وجود رابح وخاسر بين النّظام والمعارضة، فضلاً عن عدم قدرة أيّ طرف من الأطراف الإقليميّة والدّوليّة على السّماح بخسارة وكيله المحلّيّ، فقد بات مرجّحاً أن تكون الأزمة السّوريّة من النّوع الطويل والمعقّد والذي قد يأخذ شكل الحرب الأهليّة – كما حصل في لبنان والعراق – أو قد يتّسع ليشمل دولا إقليميّة بالغت في الرّهان على مآلات الثورة السّوريّة”. إلا أنّها وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التعقيد، بحيث بات صراعاً دوليّاً صرفاً بين الدّول الضالعة في الأزمة السّوريّة.
وفي دراسة أخرى للباحثة “سُنيّة الحسينيّ” بعنوان “سياسة الصّين تجاه الأزمة السّوريّة: هل تعكس تحوّلات استراتيجييّة جديدة في المنطقة؟”. تستعرض الباحثة مراحل تطور السّياسة الخارجية الصّينيّة تجاه الأزمة السّوريّة اعتماداً على محدّدي المصلحة والأيديولوجيا، وتعتبرهما “محدّدين أساسيّين في الفكر السّياسيّ الصّينيّ”، وأنّ الصّين تناور “ما بين أهميّة سوريّا الاستراتيجييّة والأمنيّة والاقتصاديّة للصّين، وما بين دعم الصّين لسوريّا على أساس تحقيق العدالة وإرجاع الحقوق والدّفاع عن المظلوم”. وتخلص الباحثة إلى نتيجة مفادها أنّ “الموقف الصّينيّ الدّاعم لاستمرار الأسد على رأس النّظام السّوريّ؛ منبعه اعتقاد الصّين أنّ محاولات الولايات المتّحدة لزعزعة استقرار المنطقة العربيّة، يأتي لسدّ الطريق أمام إمدادات النّفط التي تصل إليها، وخصوصاً أنّ ذلك جاء بعد تراجع اهتمام الولايات المتّحدة بمنطقة الشّرق الأوسط وسعيها للخروج منها، بعد اكتشاف كميّات هائلة من النّفط في كندا والبرازيل وتطوير العديد من التقنيات لاستخدام الطّاقة البديلة والطّاقة الكامنة في باطن الأرض، كبديل مستقبليّ للنّفط”.
مستقبل الصراع الرّوسيّ الصّينيّ مع الولايات المتّحدة في الشّرق الأوسط:
تتّجه كلّ من روسيّا والصّين إلى تعزيز تواجدهما ونفوذهما في المنطقة، عبر الانتشار العسكريّ والانفتاح الاقتصاديّ على دول المنطقة، وملء الفراغ الذي تركته الولايات المتّحدة عقب اندلاع ثورات ربيع الشّعوب في عدد من الدّول، مثل سوريّا وليبيا واليمن، عبر الاعتماد على حلفاء لهم مثل إيران والنّظام السّوريّ وخليفة حفتر، وجماعة الحوثيين في اليمن، لتطرح نفسها قوّة منافسة وبديلة للولايات المتّحدة، خاصّة بعد أن فشلت الأخيرة في استعادة الأمن والاستقرار إلى دول المنطقة، رغم تشكيلها تحالفاً يضمّ نحو /72/ دولة لمكافحة الإرهاب. إلا أنّ الولايات المتّحدة تحاول في أحيان كثيرة استخدام سياسة ضرب الخصم بالخصم، عبر إثارة التّناقضات بين روسيّا والصّين، ومحاولة استمالة أحد القوّتين إليها، إن كان عبر تخفيف العقوبات الاقتصاديّة عليها، أو التشارك معها في بعض الخطوات التي من شأنها أن تبعد الأولى عن الثّانية، وتجلّى ذلك أكثر في تناولهما للأزمة السّوريّة. فقد وافقت الولايات المتّحدة الإبقاء على النّظام بالتوافق مع روسيّا، ولم تعترض على رعاية روسيّا اجتماعات أستانا المتعدّدة، بهدف عدم حدوث تقارب استراتيجييّ بين روسيّا والصّين، إلى جانب عدم اعتراضها بقوّة على تعاون تركيّا مع روسيّا في الملفّ السّوريّ، أو إقامة الأخيرة علاقات اقتصاديّة معها. ولكن هذا لا يعني أنّ الولايات المتّحدة قد غضت الطرف عن المحاولات الرّوسيّة في فرض نفسها قوّة عالميّة بديلة لها. وفي هذا الصدد يقول “المبدأ الاستراتيجييّ لوزير الخارجيّة الأمريكيّ الأسبق “هنري كيسنجر” إنّه يجب على واشنطن أن تنظّم علاقاتها بالخصمين، الصّينيّ والرّوسيّ، على أساس أن تكون خياراتها تجاههما أعظم دائماً من خياراتهما تجاه بعضهما بعضاً”، أي عدم إغفال أيّ خيار تجاه كلتا الدّولتين، بما فيه الخيار العسكريّ. ويبدو من خلال الصراع الدّائر بين الطرفين، أنّ الأجواء تعيد بهما إلى الحرب الباردة، رغم تغيّر موازين القوى بشكل كبير لصالح الولايات المتّحدة منذ بدء الألفيّة الثّانية.
فروسيّا المُثقلة بالأعباء الاقتصاديّة، لا يمكنها مجابهة الولايات المتّحدة في منطقة الشّرق الأوسط، وعدم قدرتها على حلّ الأزمة السّوريّة بمفردها، خير مؤشّرٍ على النّفوذ القويّ للولايات المتّحدة، فضلاً عن ضيق المجال الحيويّ الرّوسيّ في المنطقة، حيث معظم دول المنطقة دخلت في تحالفات واتّفاقيّات عسكريّة واقتصاديّة طويلة الأمد مع الولايات المتّحدة، فروسيّا الباحثة عن موطئ قدم لها في المياه الدّافئة، لا تملك ميراثاً قويّاً في منافسة الغرب في المنطقة. كما أنّ الصّين هي الأخرى ليس بمقدورها حماية الأنظمة الرّاهنة من تداعيات ثورات الشّعوب، فالقوّة الاقتصاديّة والإيديولوجيا وحدهما غير كافيتين لاستعادة الاستقرار في المنطقة، إن لم تقترن بالقوّة العسكريّة ومكافحة الإرهاب.
كما أنّ النزاعات بين روسيّا والصّين حول عدّة ملفّات، مثل سيبيريا، تُعدُّ إحدى أسباب عدم وصول القوّتين إلى وضع استراتيجييّة واضحة وموحّدة في المنطقة، ما يترك الأبواب مواربة أمام الولايات المتّحدة لمدّ نفوذها أكثر في المنطقة وتستمرّ في تحكّمها بمصادر الطّاقة.
تأثيرات الصراع الرّوسيّ الصّينيّ مع الولايات المتّحدة على حلّ القضيّة الكُرديّة:
تُعدُّ القضيّة الكُرديّة جزءاً أساسيّاً من قضايا منطقة الشّرق الأوسط، مثل القضيّة الفلسطينيّة، وهي في إحدى جوانبها تعتبر قضيّة مركزيّة، لا يمكن دون حلّها بشكل عادل، كقضيّة شعب ووطن، أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار، طالما عصفت بالمنطقة الحروب والصراعات والنّزاعات طيلة أكثر من قرن منذ تقسيمها وفق مسطرة سايكس – بيكو في بداية القرن المنصرم وإلى يومنا الرّاهن.
يحمل حلّ القضيّة الكُرديّة تعقيدات عديدة، منها ما وضعتها القوى العالميّة، وأخرى خلقتها الدّول التي اقتسمت جغرافيّة كردستان فيما بينها، بعد نشوء الدّول القوميّة في كلّ من تركيّا والعراق وسوريّا وإيران، حيث سوّقت لنظريّة التآمر وربطتها بالقضيّة الكُرديّة. فدخلت في أحلاف وعلاقات الغاية منها سدّ جميع السُبُل أمام حلّ القضيّة الكُرديّة. ولا يخفى على أحد أنّ الصراع في بداية القرن العشرين على جغرافيّة كردستان بين كلّ من بريطانيا وفرنسا وروسيّا، حدت بها إلى تقسيم الوطن الكُرديّ بين أربعة دول، وانعكس الصراع الدّوليّ، إن كان في الحرب العالميّة الأولى، أو بين الحربين العالميّتين، بشكل مباشر على واقع كردستان والشّعب الكُرديّ، من خلال تمريره عبر مجازر جماعيّة، دون أن يصدر أيّ رد فعل من قوى الهيمنة العالميّة حينها، بما فيها الاتّحاد السوفييتي الذي كان يدّعي الدّفاع عن الشعوب المقهورة ودعم حركات التحرّر الوطنيّة في العالم.
إنّ الخوض في تفاصيل الصراع الدّائر على كردستان وفيها، هو موضوع بحث طويل، ربّما تُتاح لنا الفرصة لاحقاً لإعداد بحث كامل عنه، لكن ما يهمُّنا في هذه الدّراسة، هو إسقاطات الصراع الدّائر في المنطقة بين الولايات المتّحدة الأمريكيّة وكلّ من روسيّا والصّين على الواقع الكُرديّ، وخاصّة في روج آفا/ غرب كردستان، وكذلك على باكور/ شمال كردستان.
حافظت الصّين على خطّها الجامع بين الطّموح في الصعود الاقتصاديّ، والنأي بنفسها عن الصراعات والنّزاعات الدّوليّة المختلفة، وهي في هذه الحالة، ومن حيث النتيجة، لعبت، ولا تزال، دوراً سلبيّاً وانتهازيّاً، إن صحَّ التعبير، لتدخل في مساومات ومقايضات مع الدّول الرّأسماليّة، لاستدامة تدفّق الطّاقة اللّازمة لتدوير عجلة الصناعة المتنامية لديها، غير آبهة بقضايا الشّعوب ومصيرها، ولتبتعد عن مبادئها الاشتراكيّة والشّيوعيّة، التي طالما نادت بها. ولم تُبدِ أيّ مواقف إيجابيّة تجاه القضيّة الكُرديّة، على العكس من ذلك، لا تزال تؤيّد مواقف وممارسات الدّول المقتسمة لجغرافيّة كردستان. وخلال الأزمة السّوريّة، دعمت الصّين بشكل خفيّ مساعي تركيّا في نقل المسلمين الإيغور المتطرّفين من الصّين، لتوطينهم في المناطق الكُرديّة، إن كان في باكور كردستان أو في عفرين التي احتلّتها تركيّا في 18 مارس/ آذار 2018. وهي تنظر إلى المسألة من زاوية التخلّص من المتطرّفين الإيغور، ولو كان على حساب تشريد الشّعب الكُرديّ من موطنه الأصليّ.
كما أنّ روسيّا هي الأخرى، مارست سياسة عدائيّة تجاه قضيّة الشّعب الكُرديّ في روج آفاي كردستان وباكور، فهي التي منحت تركيّا الضوء الأخضر لاحتلال عفرين وسري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض، كما أنّها لا تزال تمارس ضغوطاً على النّظام السّوريّ لمنعه من إنجاز أيّ اتّفاق مع الإدارة الذّاتيّة الدّيمقراطيّة في شمال وشرق سوريّا.
دخول قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة ضمن التّحالف الدّوليّ لمكافحة الإرهاب، اعتبرته روسيّا وكذلك الصّين، تحالفاً مناوئاً لها وضدّ مصالحها في سوريّا. وعليه وجد الصراع الرّوسيّ – الأمريكيّ مرتسماته على الأرض في محاولة روسيّا النّيل من قوّات سوريّا الديمقراطية والإدارة الذّاتيّة الدّيمقراطيّة وإضعافها، وكذلك من الشّعب الكُرديّ في روج آفا.
المناكفات بين القوّات العسكريّة الرّوسيّة والأمريكيّة في مناطق روج آفا، هي في المحصّلة، تفضي إلى فرض حصار عليها، وإبقائها ضمن دائرة مغلقة، وبالتالي عدم تمكّنها من تحقيق انفتاح على العالم الخارجيّ.
بدروها الولايات المتّحدة الأمريكيّة لم تخطو إلى الآن خطوات جادّة في سبيل ترسيخ بنية الإدارة الذّاتيّة، وليتمكّن الكُرد من نيل حقوقهم المشروعة ضمن سوريّا ديمقراطيّة في المستقبل، فظلّت تنظر إلى القضيّة الكُرديّة من زاوية معادلتها بميزان الرّبح والخسارة مع حلفائها مثل تركيّا والعراق، ولم تضع إلى الآن استراتيجييّة واضحة للتّعامل مع القضيّة الكُرديّة.
فالصراع بين روسيّا والولايات المتّحدة في بداية عام 2016 أدّى إلى تقسيم مناطق روج آفا بين “شرق وغرب الفرات”. فهذا المفهوم والمصطلح المرتبط بمناطق نفوذ الدّولتين لم يكن موجوداً قبل الاتّفاق الذي حصل بين وزيري خارجيّتيهما، وهذا هو الجرح النّازف في روج آفا، تبعه احتلال عفرين وسري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض.
لا تزال الدّول العظمى تتعامل مع القضيّة الكُرديّة من منطلق الحفاظ على مصالحها في المنطقة، وكان الرّئيس الأمريكيّ السّابق دونالد ترامب الأكثر وضوحاً في هذه المسألة، عندما وقف مع تركيّا في عدوانها على مناطق روج آفا، وساوى بين الشعب الكُرديّ ودولة الاحتلال التركيّ، حيث ادّعى بأنّ الصراع بينهما طويل وليس بوسعهم إنهاءه. كذلك أطلقت رئيسة الوزراء البريطانيّة السّابقة “تيريزا ماي” تسمية “الإرهاب” على الشّعب الكُرديّ في لقاء لها مع أردوغان.
خاتمة:
إنّ النّهوض الاقتصاديّ الصّينيّ المتنامي، والسّعي الحثيث للبحث عن مساحات إضافيّة لاستثماراتها التي غزت العالم أجمع، وكذلك حاجتها المستمرّة إلى الطّاقة، من نفط وغاز، مقروناً بتعزيز روسيّا لقدراتها العسكريّة وإنشاء عدّة قواعد لها في منطقة الشّرق الأوسط، لا تضعها في سويّة الولايات المتّحدة من حيث قدرتهما على مواجهتها في المنطقة، وكذلك السّيطرة على مصادر الطّاقة وأسواق بلدان المنطقة، وأغلب الاعتقاد أنّ الولايات المتّحدة ستحافظ على موقع الرّيادة في فرض نفوذها العالميّ، ولا تغدو محاولات روسيّا والصّين سوى عراقيل آنيّة، سرعان ما ستتلاشى وتزول أمام القوّة العسكريّة والاقتصاديّة الأمريكيّة في المنطقة، وتغلغلها في تفاصيل مجتمعاتها وشعوبها.
المراجع:
_________________________
1 – دراسة للدّكتور “خضر عباس عطوان” بعنوان “مستقبل العلاقات الأمريكية الصّينيّة”، التّابع لـ”مركز الإمارات للدّراسات والبحوث الاستراتيجييّة” في فبراير/ شباط 2021.
2 – تصريح لقائد القيادة المركزيّة الأمريكيّة الجنرال “كينيث ماكينزي” في عام 2020.
3 – دراسة بحثيّة لمركز “الأهرام” عن العلاقات الصّينيّة الأمريكيّة عام 2020.
4 – دراسة للباحث “محّمد عطيّة محمّد ريحان” في دراسة له بعنوان “التجربة الصّينيّة وتحدياتها المستقبلية”.
5 – كتاب “دفاعاً عن شعب” للمفكّر الكُرديّ عبد الله أوجلان.
6 – تقرير معهد ستوكهولم لدراسات السّلام لعام 2015.
7 – مقالة للكاتب “عبد الجليل زيد” بعنوان “الصّين والمسألة السّوريّة” نشر في موقع الجزيرة. نت.
8 – دراسة للباحث “مروان قبلان” بعنوان “المسألة السّوريّة واستقطاباتها الإقليميّة والدّوليّة”.
9 – دراسة للباحثة “سُنيّة الحسينيّ” بعنوان “سياسة الصّين تجاه الأزمة السّوريّة: هل تعكس تحوّلات استراتيجييّة جديدة في المنطقة؟”.