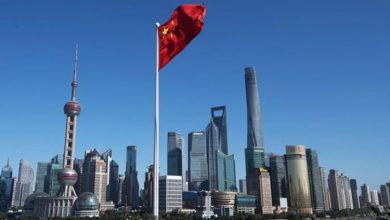السياسة الدولية كوانتمياً (أثر الفراشة والاحتمالات اللانهائية)
سردار هوشو
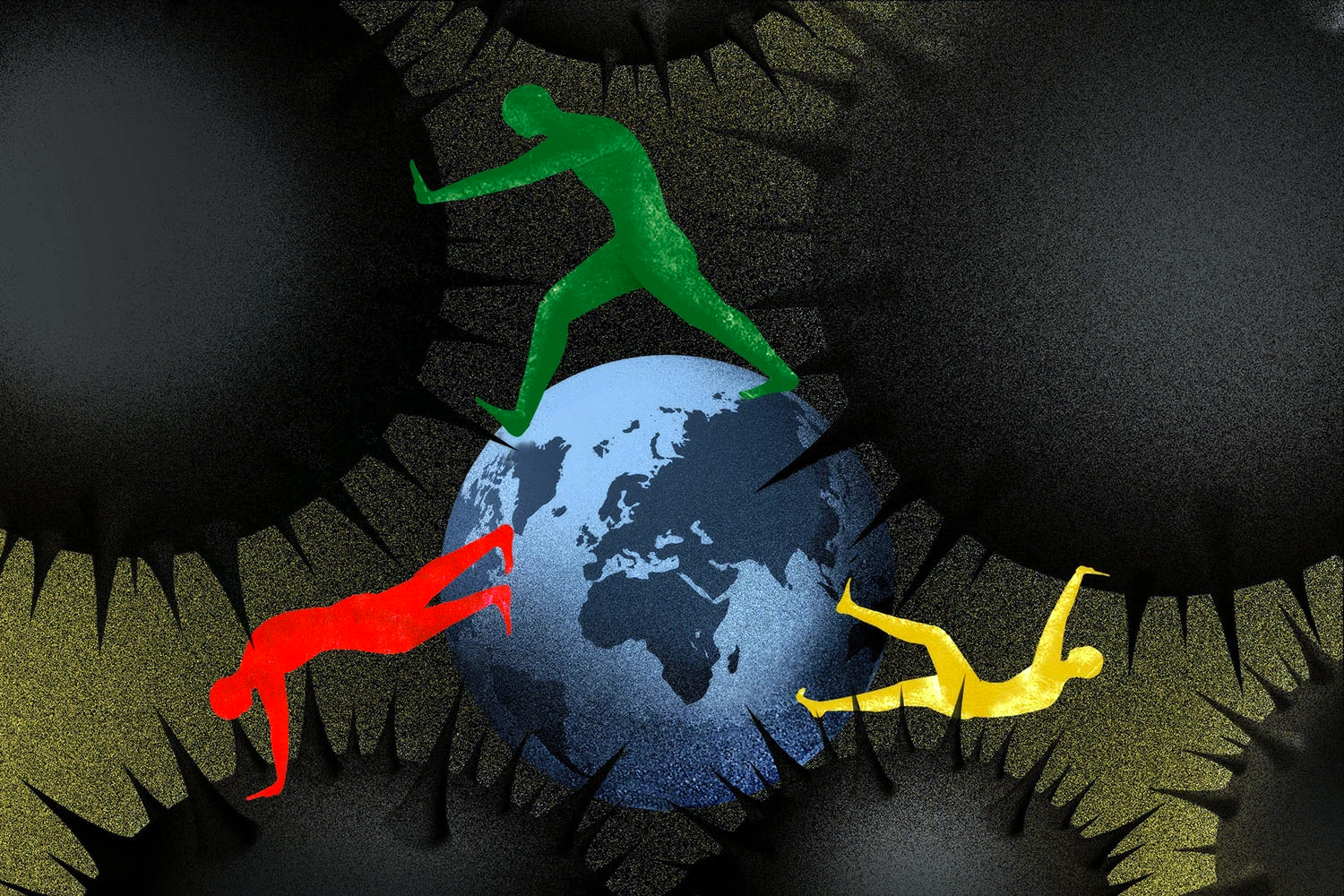
السياسة الدولية كوانتمياً (أثر الفراشة والاحتمالات اللانهائية)
نظرة تاريخية على تطور الفيزياء وانعكاساتها على السياسة:
بعد اكتشاف نيوتن قوانين الحركة, أضحى العالم عبارة عن نظام محكم يتحرّك وفق قوانين ثابتة, وإذا ما استطعنا معرفة أسباب الحوادث نستطيع حينها التنبّؤ ليس فقط بما سيحدث في المستقبل, بل نستطيع التحكم في الظاهرة أيضاً إذا ما استطعنا التحكم في الأسباب التي تؤدي لحدوث الظاهرة, وبهذا المعنى يستطيع الإنسان التحكم بالعالم والسيطرة عليه, ويثبت أنه الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يسيطر على العالم, وأن يوجهه بما يخدم مصالحه, ما ولّد لديه الشعور بالاستقرار والسيطرة. وفي عام 1814 جاء العالم الفرنسي “لابلاس” ليؤكد أنّ وضع الكون في الحاضر هو نتيجة وضع الكون في الماضي، وهو سبب وضعه في المستقبل, وأنّ المستقبل مفتوح، وواضح كما هو الماضي, ويستطيع الإنسان التنبؤ بالمستقبل تماماً، وهو ما نسميه (مبدأ الحتمية). إلى أن جاء العالم الأسكتلندي ماكسويل عام 1876 ليؤكد أن الفروق البسيطة في الأوضاع المبدئية, ستؤدي إلى فروق في الوضع النهائي ولكن في حالات استثنائية. وفي عام 1890 جاء العالم هنري بونكاريه ليقول إن الوضع الجديد لأيّ جسم يعتمد اعتماداً كبيراً وحساساً جداً على وضعه الأوّلي, وإن الحركات الميكانيكية معقدة جداً بصورة لم يستطع نيوتن وماكسويل توقعها, حيث كتب في عام 1908 “لماذا لا يستطيع علماء الأرصاد الجوية التنبؤ بحالة الطقس بصورة مؤكدة, والعواصف تبيّن أنها ناتجة عن طريق الصدفة بأن الإعصار سيحدث في مكان ما, ولكن لا يستطيعون التنبؤ بالضبط بموقع الإعصار ب 1/10 في أي مكان, وبالتالي تجاهُلُنا لهذا ال 1/10 من المعلومات لو استطعنا أن نعرفها لتمكنّا من معرفة موقع الإعصار بالضبط , ولكن تجاهلنا لـ 1/10 يجعلنا نشعر أنّ الإعصار يحدث عن طريق الصدفة، وهذا ما يسمى بنظرية الفوضى (الكايوس) وينتج عنها بالتالي, إنّنا لا نستطيع التنبؤ بمستقبل أيّ نظام؛ لأنّ التغييرات الطفيفة والبسيطة في ظروفها الأولية لها أثر كبير في مستقبله، عكس مبدأ الحتمية الذي تبنّاه لابلاس ونيوتن اللذان أكّدا على إمكانية التنبؤ بأيّ نظام, وهكذا نجد أن نظرية الفوضى كانت صدمة ومفاجأة للإنسان الذي كان يعتقد أنّ العالم نظام متوازن ومستقر ونستطيع التنبؤ والتحكم به وبمستقبله, ولهذا نجد العلماء في تلك الفترة كانوا رافضين نظريةَ الفوضى؛ لأنّها كشفت عن تواضع العلم وعجزه وعدم سيطرته على الطبيعة كما كان يُتوهّم, لأنه تبيّن أن الطبيعة هي التي تتحكّم به، وليس هو الذي يتحكم بها, وجاء العالم إدوارد عام 1961وقام بإجراء تجربة بيّنت أنّ المتغيّرات البسيطة والضئيلة التي نهملها في أيّ تجربة, قد تؤدي إلى إحداث تغييرات كبيرة في النتائج, وهذا ما يُطلق عليه (أثر الفراشة), فالفراشة تسبّب اضطرابات وتموّجات في الهواء، وبعد فترة زمنية تسبّب إعصاراً في مكان ما, كما أنها يمكن أن تتسبب بعدم حدوث إعصار في مكان آخر, وبالتالي فإن الفراشة كائن قويّ وإنك إذا ما قتلتها يمكنها أن تدمّر بلدك بالكامل. إن كلام بونكاريه عن فرق ال 1/10 يمكن أن يُحدث الإعصار, وإن التغييرات البسيطة التي لا يعريها الإنسان أيّ اعتبار يمكن لها أن تؤدي إلى نتائج كبيرة غير متوقعة, وهذه النظرية تنطبق في كافة مجالات الحياة كما في الاقتصاد, فكثيراً ما تحدث أزمات اقتصادية غير متوقعة, وكذلك في علم العسكرة كثيراً ما تتغلب قوة ضعيفة بالعدد والعتاد على قوة كبيرة مسلحة بأحسن أنواع الأسلحة, فقيام الحرب العالمية الأولى التي راح ضحيتها ثمانية ونصف مليون إنسان, كانت نتيجةً لاغتيال فردينان ولي عهد إمبراطورية النمسا والمجر, وكلمة تقولها لشخص يمكن لها أن تغيّر كثيراً في العالم, وقد انعكس هذا الأمر على السياسة أيضاً, حيث دخلت السياسة إلى حالة من عدم الوثوقية أو حالة عدم التعيين, فليست الظواهر السياسية اليوم ظواهر قابلة للتنبؤ كما في الماضي, ففي السياسة اليوم؛ باتت الوقائع محكومة بأثر الفراشة, أي بمستوى الأحداث الصغيرة التي تؤدي إلى أحداث كبيرة, حيث تراجع دور القياس الاستقرائي لصالح البجعة السوداء أي الأحداث التي تأتي من خارج السياق المألوف, إن عالم الصغريات “المايكرو” عالم يتجاوز الاحتمالية إلى انعدام اليقين مما جعل التحليل السياسي والتنبؤ السياسي في مهبّ الريح, وأدى إلى تكريس مبدأ الفوضى العمياء، وقد انعكس هذا على السياسة أيضاً, حيث ظهرت ميولٌ في علم السياسة باعتبار أنّ الطبيعي في الوجود هو زيادة معاملات الفوضى, لهذا بدأت نظريات سياسية تميل إلى اعتبار أن النظام الدوليّ الذي تأتّى من مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية, كان خطأ مجافياً للطبيعة بخلاف السعي نحو التنظيم, وهذا ما سُمّي بفلسفة السياسة ما بعد الحداثة, التي تعتمد على النسبوية وتلغي أيّ تعيين, والتي تؤدي إلى العبثية السياسية وتُحيل كلّ القضايا إلى الّلا معنى, حيث ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية تيّار مؤيّد لمبدأ العماء والفوضى الخلاقة (المحافظون الجدد).
وقد كان للمفكر والقائد الكردي عبدالله أوجلان رأي نقدي في هذه النظرية عند تناوله للعلم كأسلوب للبحث عن الحقيقة, فهو يرى أن البحث في المادة داخل جسم الإنسان هو الأسلوب الأقرب إلى الصحة, لكن يبدو من غير الممكن الوصول إلى التفسير الأقرب إلى الصحة للمادة داخل مختبرات الحداثة المعزولة بإحكام, في حين أن العلاقة بين الناظر والمنظور إليه في فيزياء كوانتم لا تعترف إطلاقاً بالقياس الأكيد المجزوم به، فمثلما يُجري الناظر تغييرات على المادة بمقدور المنظور إليه أيضاً إفلات نفسه من عين الناظر ضمن شروط المختبرات.
حيث ترتب على هذه النظرية الكوانتية، تجاوز المنهج الاستقرائي في قراءة المستقبل وفتح باب الاحتمالات, لأن في أيّ حدث هناك احتمالات لا نهائية وفقاً لمبدأ الكون كله, إنه يلعب بالنرد, أي إنه لا توجد حالة تعيين, حيث أننا لا نستطيع أن نفهم الأحداث ولا نستطيع ضبطها بمقياس.
أي إننا نبحث عن قضايانا حيث يوجد الضوء الذي اعتدنا عليه في المعارف السابقة, أي أنّنا بالتأكيد لا نعرف نتائج ما سيحدث، أو ما لن يحدث بالاستناد إلى المعلومات المحدودة التي نمتلكها, فكلّ حقيقة هي حقيقة، ونقيضها أيضا حقيقة, وإن أفضل ما يمكننا فعله في السياسة اليوم؛ هو أن نعيّن احتمالية حدوث شيء أو احتمالية تطوّره مع الوقت.
إنّ مستقبل أيّ صراع مفتوح على احتمالات غير متوقعة إذا ما تدخّل ظرف ما حاسم يجعله في حالة واحدة متعينة, أي بتدخّلٍ ما يتعيّن احتمالاً دون آخر, وإن بقاء الصراع أو ظهور حلّ لهذا الصراع أمران متراكمان في الوضع الحالي، ولا يمكن التنبؤ به, حيث تدخُّلُ دولة أو ردّ فعل لدولة ما لجماعة ما قد يُخرج الاحتمالات المتراكمة إلى حالة متغايرة.
إننا نعيش الحالة النيوتونية ولكن الحقيقة تكمن في الحالة الكوانتية, فكلُّ حدث مستقبلي معتمدٌ على الحسّ العام, وكل فكرة جديدة لدى الناس غير مألوفة من قِبل الحسّ العام, نجد دائماً أن هناك ممانعة تغيير لديهم, فهم يعتقدون أنهم يمتلكون الحقيقة كاملة. كذلك في السياسة عندما تأتي حقائق جديدة غير متوقعة فإن هذه الوقائع تُرفض, ونجد أن هناك ممانعة لما هو جديد, فهناك دائماً حنين إلى الماضي وأن الماضي دائماً هو الأفضل, ومشهد النهايات سيشكل قطعاً ابستمولوجيا مع الحسّ العام في السياسة وفي وقائع المجتمعات.
التغييرات الدولية
لقد مرت السياسة بثلاث مراحل:
ـ مرحلة الفكر السياسي الأخلاقي الممتد من سقراط الذي دعا إلى التسامح، وكيف يجب أن تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم؟ والحاكم يجب أن يكون فيلسوفاً هدفه الرئيسي هو البحث عن الخير وتحقيقه، وأفلاطون يُعتبر أول من وضع نظاماً سياسياً, والسياسة عنده ليست أكثر من امتداد طبيعي للأخلاق, وهو الذي تخيّل كيف يجب أن يكون شكل الدولة وما يجب فعله كي تكون الدولة ناجحة وتحقق السعادة, وصاغ كل ذلك في كتابه “الجمهورية” والذي تأثر به الفارابي في صياغة آرائه السياسية، حيث تأثر بالفلسفة الأخلاقية والسياسية لدى أفلاطون وربط السياسة بالأخلاق, وأنّ غاية الرجل السياسي هي تحقيق الخير ومن ثم تحقيق السعادة (ما يجب أن يكون). لكن هذه السياسة الأخلاقية كانت غير قابلة للتنفيذ لأن الحكم الأخير فيه للواقع لا للأفكار والقيم, وهي ما تسمى بالسياسة ما قبل الحداثة.
ـ المرحلة الثانية هي مرحلة السياسة الواقعية التي غلب فيها مبدأ الواقع على الأفكار أو القيم, وهي مرحلة الحداثة, حيث تعيّنت السياسة على مبدأ الواقع باعتبارها “فناً للممكن” فمنذ اتفاقية “وستفاليا” التي وُقِّعت بعد حرب دموية وطويلة الأجل بين الكاثوليكية والبروتستانتية, حيث وقّع الطرفان عام 1648على مجموعة من البنود والنقاط التي حددت فيما بعد, شكل النظام العالمي والعلاقات الدولية. ومن أبرز ما جاء فيها:
- التركيز على مبدأ سيادة الدولة, أي أنّ من حق الدولة مهما كانت صغيرة أن تقرر مصيرها، وتتّخذ القرارات التي تراها مناسبة داخل حدودها, دون الخضوع لأي طرف خارجي أو تدخل من دولة أخرى.
- تكريس مبدأ الولاء القومي, بمعنى تعزيز الحالة القومية على الحالة الدينية، وذلك لتجنّب الصراعات الدينية التي جلبت الويلات للشعوب الأوربية.
- مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
حيث ارتكزت هذه المرحلة في السياسة الواقعية على أربعة قوائم وهي:
ـ الميكافيلية التي تعني فصل الذات عن الموضوع، وتأسس بذلك علم السياسة.
ـ الأداتية التي ترى كل شيء في الواقع بما فيه العقل, أداةً لخدمة الواقع.
ـ البراغماتية التي تعتبر ألّا قيمة للنظرية إذا لم تكن ذات فائدة, تكون النظرية أو الفكرة صحيحة بمقدار المنفعة التي تقدمها.
ـ الوظيفية التي عنيت بالتعامل مع الواقع كما هو دون البحث في أسباب ما فيه.
وبهذه العناصر الأربعة مورست السياسة, فبعد الحرب العالمية الثانية نشأ نظام القطبين؛ الاتحاد السوفييتي “حلف وارسو” و”الحلف الأطلسي” بقيادة أمريكا, وكان هناك ما يشبه التنافس بالمعنى السياسي والإيديولوجي بين الطرفين, فكان رأي الماركسيين أنّ هناك مسحوقين، وبأنهم يحتاجون في العالم كلّه إلى رعاية خاصة، وإعادة توزيع الثروة, وهذا الأمر شكّل للولايات المتحدة الأمريكية تحدّياً كبيراً, وبناءً على ذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية بترميم النموذج الاقتصادي الرأسمالي, حيث أنشأت ما يسمى بدولة الرعاية, إذ يجب على الدولة أن ترعى مواطنيها وخاصة الفقراء وذلك من خلال الضمان الصحي والرعاية للمجتمعات ورفع مستوى الرواتب وتأمين دور للسكن وتقديم المال, لكي يتمكنوا من العيش في حال البطالة, وإطلاق الحريات العامة, وكل ذلك كردّ على النظرة الماركسية.
لقد صُنّفت هذه المرحلة تحت اسم التوازن الدولي الجديد, استناداً إلى توجّه السياسة الخارجية للاتحاد السوفييتي التي سعت للاندماج بالمجتمع الدولي, والانتماء لمفهوم القيم ذات الطابع الكونيّ للإنسانية, والرغبة في معالجة الصراعات الإقليمية بالوسائل السياسية السلمية والحوار.
هكذا نجد أن في مرحلة الحداثة نشأ وَهْمُ ضبطِ الواقع بالقوانين السياسية متأثراً بقوانين الفيزياء النيوتونية, ورافقت هذه الرغبة نظريات أشدّ وهماً وهي نظرية المؤامرة السياسية والتوقعات الاستقرائية والتاريخية, التي تتبنّى أن المستقبل هو آتٍ من الحاضر وأن الحاضر آتٍ من الماضي, لأنّ معرفة المستقبل مبنية على معرفة الماضي.
هذا الاتجاه سرعان ما اصطدم بأنّ الوقائع المستقبلية كانت وحيدة عصرها ومتفرّدة, وليست متشابهة لأي مما عرفتها البشرية من أحداث في الماضي, ما يعني أن هناك قطيعة بين الحاضر والماضي والمستقبل, وهذا الشكل من السياسة مُورِسَ حتى الثمانينيات من القرن العشرين حيث نشأ تيار جديد وهو تيار ما بعد الحداثة (الكوانتا السياسية).
المرحلة الثالثة: صُنّفت هذه المرحلة بأنها مرحلة إنهاء النظام العالمي ذي الثنائية القطبية التي سادت منذ انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وانهيار الاتحاد السوفييتي, وتخلّيه عن مكانته في قيادة العالم، حيث مهّد لنظام عالمي ذي قطب واحد وهو الولايات المتحدة الأمريكية وتفرّدها في قيادة العالم, والتي كانت تقوم سياستها على مبدأ البراغماتية والمنفعة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول, ورسْم مسار جديد على مستوى العلاقات الدولية.
وفي هذا الصدد يقول الكاتب “سيرغي قره مورزا” في كتابه؛ (الاتحاد السوفييتي من النشأة الى السقوط): “خسرت معارك حركات التحرر الوطني في مختلف أنحاء العالم الكثير بسبب سقوط الاتحاد السوفييتي, ليس لأنها فقدت نصيراً مهمّاً في مواجهة محاولات الهيمنة الدولية فحسب, وإنما لأن استفراد قوة واحدة بقيادة العالم قد أفقد النظام العالمي واحداً من أهم شروط التوازن المطلوبة دولياً).
واستطاعت أمريكا رسم خارطة جيو- سياسية جديدة ترسم معالمها ومحطاتها وحدودها منفردةً في صياغة نظام عالمي جديد, وتتحكم بمفاصل السياسة الدولية والعلاقات الاستراتيجية في العالم بشكل مضبوط كما تشتهي، ودون أي منافس لها, وهذا الشكل للنظام العالمي الجديد مورس حتى الثمانينيات من القرن العشرين حيث نشأ تيار جديد وهو تيار ما بعد الحداثة (الكوانتا السياسية).
فإذا كانت مرحلة الحداثة قد تأثرت بفيزياء نيوتن، وحاولت رسم علمٍ للسياسة مضبوطٍ بقوانين صارمة, فإن مرحلة ما بعد الحداثة ترافقت مع نهاية الاتحاد السوفييتي، ونظام القطبين الضابط للعالم مع نشوء الفيزياء الكوانتية, إذْ نسفت منطق القوانين الصارمة, ورسمت فهماً جديداً للفيزياء، فتأثرت بها السياسة بدورها, فهو يقوم على أن الفروق الطفيفة تُنتج أحداثاً كبيرة، وأنّ العالم يفهم فهماً أكبر, ما يُفسِّر أن مخالفة المنطق والحسّ العامّ يمكن الائتلاف معه في عالم لا يمكن ضبطه. إن الفوضى العمياء أو العماء هي سمة الوجود الغالبة وإن ما نراه منظّماً هو من طبيعة مخّ الإنسان أو ترتيبه وتناظراته وميله إلى التجريد, وأنّ المستقبل لا يمكن تعيينه سلفاً، وهو مشكّل من عدد لا متناهٍ من الاحتمالات, وقد ترتّب على ذلك تعايش النظام الدولي مع العماء حيث ينتشر العماء بصورة لا سابق لها.
إنّ التحليل السياسي الاستقرائي التاريخي لم يعدْ ممكناً في الحالات العمائية؛ لأنه لا ينطبق إلا على المنظومات المستقرة؛ أي الحداثية, ففي هذه المرحلة ذهب إلى أن النظام العالمي الجديد سوف يكون نظاماً متعدّد الأقطاب, فإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هناك أوروبا الغربية واليابان وربّما الصين, وهذا النظام ما يزال في ضوء التكوين، ولمّا تنضجْ معالمه بعد, وأنّ مرحلة التسعينيات تميّزت بتصدّع البنى والهياكل القديمة للنظام السابق, وفي المقابل لم تتّضح هوية البنى والتوازنات الجديدة من النظام الجديد, ما يدفع إلى توصيف مرحلة التسعينيات وتطور النظام العالمي بأنها مرحلة انتقالية بين نمطين مختلفين من تطور العلاقات الدولية.
لم يعدْ هناك لأيّ شعب في عصر التفاعلات الدولية القوية التي نعيشها أملٌ في الاحتفاظ باستقرار قراره الوطني من خلال الدفاع الجامد عن المفاهيم القديمة في السيادة الوطنية, وما تتطلّبها من رفع جدران العزلة أو الاستعداد للانخراط في الحروب الدفاعية, فبقدر ما ينجح شعب من الشعوب في التحوّل إلى شريك في تقرير المصير العالمي يحظى بهامش من المبادرة يتيح له تكوين قرار وطني، ولحمة وطنية جامعة، والاحتفاظ بالحدّ الأدنى من الإرادة الحرة, والاستقلال يستدعي اليوم منا الانتقال من مفهوم السيادة إلى مفهوم الشراكة, وفي قلب هذه السياسة التي تؤسس لمفهوم الشراكة العالمية, يوجد مفهوم المسؤولية, وهذا الشعور بالمسؤولية يقف على طرفي نقيض مع روح الأنانية والانفرادية السائدة لدى الدول الكبرى, كما أنّها على طرفي نقيض مع روح التهرّب في مواجهة المسؤولية و رميها على الآخرين.
وللمسؤولية السياسية ثلاثة أبعاد أو وجوه:
الوجه الأول: هو مسألة النخَب والطبقات السياسية تجاه المسائل التي تتعلق بتسيير البلاد التي يحكمونها وحسن إدارتها لمواردها, فلم يعد الحكم داخل أيّ بلد مسألة خاصة بالنخب الحاكمة, لكنّه أصبح هو نفسه مسألة من مسائل الإدارة الدولية, بقدر ما أضحى للسياسات الفاسدة لأي بلد نتائج وعواقب مباشرة على سياسات ومصير المجتمعات والبلدان الأخرى القريبة أو البعيدة, لذلك نجد أنّ النخب التي تُظهر قدراً من الضعف والعجز في إدارة موارد البلاد, وبقدر ظهور العجز في إدارة الأمور الداخلية في البلاد واللجوء إلى وسائل العنف لحلّ المسائل, سوف تفقد المصداقية العالمية، وبالتالي ستواجه رفضاً من النظام العالمي أو الدول التي تجد نفسها أكثر تعرّضاً لمخاطر سياساتها, وهذا يفتح الباب أمام التدخّلات الدولية والخارجية في شؤون الدولة والتي سوف تلقى قبولاً كبيراً من المجتمع الدولي، كما حدث في الحالة العراقية 2003 عندما تدخلت الولايات المتحدة الأميركية في العراق، وعملت على تغيير النظام فيه, ولا بدّ من بناء إدارة سياسية عالمية بالمعنى الحقيقي للكلمة تشارك فيها الشعوب جميعاً وتتفاوض فيما بينها, فيما وراء حدود الدول التي تتنازع على أن تخضع أكثر فأكثر في أجندتها الداخلية إلى النخب الحاكمة التي تتحكم بها وتستخدمها لخدمة مصالحها.
والوجه الثاني يتعلق بطبيعة السياسات التي تمارسها النُّخَب الحاكمة في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية, وتنبع أهمية هذا الوجه من حقيقة أنه لم يعدْ يكفي لبلد أن يراهن على امتلاك موارد كبيرة مادية وبشرية حتى يضمن تقدّمه ونموّه, وإنما يتوقف على قدر ما يكون للدولة أو الجماعة من مشاركة إيجابية في بناء إطار فعال وناجح للتعاون الإقليمي, و بقدر ما تساهم من خلال سياساتها الإقليمية البناءة في تحسين فرص التنمية عند المجتمعات المحيطة بها, وليس فقط داخل حدودها تحظى بقدر أكبر من المصداقية، وتزداد فرص حصولها على الشرعية العالمية.
أما الوجه الثالث فيشير إلى المقدرة التي تملكها القيادة أو النُّخَب الحاكمة على الارتفاع فوق المصالح القومية, من أجل ضمان الاتساق والانسجام العالميين وتعزيز فرص وشروط الأمن والسلم الدوليين, فليس لمجتمع اليوم داخل المنظومة الدولية وزن سياسيّ ولا معنويّ إلا بقدر الجهود التي يبذلها للمساهمة في حلّ المشاكل الدولية كما هو الحال مع قوات سوريا الديمقراطية, حيث سعت كبرى الدول في العالم إلى الاعتراف بها ومدّ يد العون لها لأنها ساهمت في خوض حرب كبيرة, وقدمت الآلاف من الشهداء ليس فقط دفاعاً عن وجودها وحقها, لا بل عن العالم بأسره, حيث تمكّنت من تخليص العالم من داعش الذي كان يمثل أكبر خطر إرهابي في المنطقة والعالم.
وطبعاً كل هذا يتناقض بشكل قاطع مع سياسات الهيمنة الدولية والانفراد, كما ويتناقض مع عقلية الاتّكال والتبعية التي تميل إليها بعض الدول وما يرافقها من اعتماد منطق التسوّل على الولايات المتحدة وأوروبا؛ للحصول على الدعم اللازم، والحفاظ على الأمن والاستقرار أو الدفاع عن المصالح القومية والوطنية، كما هو الحال مع تركيا, التي تسعى دائماً بالاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إلى فرض إرادة التركياتية على كافة مكونات الشعب بمختلف أطيافه داخل تركيا, وفي محاربتها المستمرة للأكراد ليس فقط داخل حدودها بل حتى في سوريا والعراق.
من النادر جداً لأيّ دولة متورّطة في حقل العلاقات الدولية أن تتمتع بالحرية الكاملة, حتى أنّ قادة أعظم القوى مقيّدون بالظروف والملابسات التي يجدون أنفسهم محاطين بها, وقد يكون استقلال الدول وهو متضمّن أحياناً في مفهوم القوى العظمى أنموذجاً مثالياً, غير أنه ليس واقعياً أن تكون أصغر القرارات الداخلية في كثير من الأحيان مرتبطة بشكل كبير بالعديد من المتغيرات الخارجية, وتتوقف على الأوضاع السياسية الدولية.
بعد عام2001 ثبتت نظرية العماه الاستراتيجية الأمريكية في السياسة, ومن أنصار هذا الاتجاه في أمريكا المحافظون الجدد, حيث يذهبون إلى القول إلى أنه إذا كان الكون كله غير منظم ولا نستطيع ضبطه والتحكم به, فلماذا نسعى نحن إلى أن نكون المنظِّمين للعالم ونكون شرطيّ النظام في العالم, وأن منظمات الأمم المتحدة والمبادئ الدولية التي تمّ وضعها لجعل العالم أكثر انتظاماً ما هو إلا خطأ عظيم, إننا نسير بذلك عكس إرادة الطبيعة, فكما الكون كله خرج من نقطة منظّمة إلى حالة عماه كلية كما في نظرية الانفجار الكبير, وكذلك العالم كله يقتتل فيما بينه منذ بداية الخليقة إلى يومنا هذا, فلماذا مطلوب منا أن نسعى إلى النظام في الكون, فالوجود كله سِمَتُه الأساسية هي الفوضى لا النظام, وكما في حالة المادة التي ننعتها بأنها مستقرّة ومنتظمة هي في الحقيقة في حالة فوضى, فالفوضى هي الخلاقة وهي الأساس لا النظام, ولم يعدْ في مقدورنا أن نتحكم بمفاصل السياسة وتوجيهها؛ لأنّ أحداثاً صغيرة قد تُخرج الحالة المعنية إلى حالة مغايرة تماماً.
إنّ ما حدث في الحالة التونسية من إحراق “بوعزيزي” نفسه قد أخرج تونس إلى مشهد لم يتوقّعه أحد، وانعكس ذلك على منطقة الشرق الأوسط كاملةً؛ في سوريا ولبنان والعراق, بمعنى آخر؛ يريدون القول: – كيف لنا أن نتعامل بعقلية الحداثة لمرحلة ما بعد الحداثة؟.
يقول “هيغل”: “لكل مرحلة روحها أي عقلها وطبيعتها, لكنّها تختلف عن الروح الكلية التي تعني الحرية, فعندما نفكر بعقلية الحداثة لما هو ما بعد الحداثة, نكون مخالفين مع روح العصر ومغتربين جداً عن العقل الكلي (الفوضى الخلاقة)”.
طبعاً كل هذه الأفكار مستقاة ومبنية على نظرية الفيزياء الكوانتية, لذلك ما يحدث اليوم في منطقة الشرق الأوسط هو انعكاس لنظرية الفوضى, فحالة الفوضى هذه مطلوبة دولياً لأن الوجود هكذا, فالشرق الأوسط تاريخياً مركزٌ في الصراع الدولي, فلماذا نسعى إلى إحلال النظام فيه؟ بل يجب أن يبقى في حالة الصراع والفوضى.
ومن أنصار هذا التيار والمتأثرين به “ترامب” وفريقه الذين يسعون إلى إحلال الفوضى بدلاً من النظام, حيث يقولون: علينا أن نكون نقطة النظام الوحيدة في العالم والعالم كله في حالة فوضى, لأننا نستطيع أن نتحمّل نتائج أي حدث طارئ, نحن نملك أكبر قوة اقتصادية في العالم، وبالتالي ظهور أي أزمة اقتصادية نستطيع تجاوزها, كذلك نحن القوة العسكرية الأولى في العالم، ولا يمكن لأحد أن يؤثر علينا, و كذلك القوة المعرفية والتكنولوجية… وكلُّ هذه العوامل تجعلنا خارج قوانين العالم. ففي عام 2002 بدأت ملامح هذا النظام السياسي الجديد تتبلور, فإذا كان الشرق الأوسط تاريخياً هو مركز الصراع الدولي, فلماذا نسعى إلى إحلال النظام فيه؟
ومن ملامح هذا النظام ممنوع المقاومة, لأنها من مخلّفات الحرب العالمية الثانية, إنما من حقك أن تتفاوض. ممنوع أن تكون لك سيادة إنما مبدأ التدخل الإنساني هو الأساس.
إذا ما أسقطنا الحالة الكوانتية الجديدة في السياسة على عالمنا المعاصر, فسنجد أننا نعيش الكوانتا السياسية بكل مفرزاتها, فنحن اليوم أمام عالم تسوده الفوضى وأمام مخرجات لا نهائية من الاحتمالات والحلول, إن فيروساً صغيراً لا يمكن رؤيته بالعين المجرّدة (كورونا) قد أحدث تغيرات كبيرة لم تفلت منها دول بحجم أمريكا وروسيا وأوروبا, وغيّر شكل العالم في حالة (أثر الفراشة) وإلى الآن لا نستطيع أن نعرف كيف سيكون شكل العالم ما بعد كورونا؟ فهو يتجه باتجاه شكل جديد غير متوقع, قطب واحد أم متعدد الأقطاب؟
ستكون للمليشيات الصغيرة أثر كبير على الساحة السياسة في المنطقة والعالم, لأنها تتعامل خارج قوانين نيوتن, فهي تعيش حالة من المرونة وتملك القدرة على التكيّف والتعامل مع أي حدث طارئ، وسيكون للمنظمات غير الحكومية، وصندوق النقد الدولي والإعلام الدورَ الكبير في تحديد الاتجاهات, لذلك نجد كيف أنّ الدول تضخّ مليارات الدولارات على هذ الجانب, فأحياناً يكون إعلام دولة ما أكبر من الدولة نفسها.
سيبُقون على حالة الفوضى هذه في منطقة الشرق الأوسط ,وسيكون ساحة للصراع الدولي، فهم يقولون: – إنّ الشرق الأوسط تاريخياً كان مركزاً للصراعات الدولية، ويجب أن يبقى هكذا؛ غير منظم، وغير مستقر.
إننا اليوم أمام عالم لا توجد فيه حقيقة واحدة وإنما مجموعة من الحقائق, حتى وإن تعارضت مع بعضها، فكلُّ حقيقة هي حقيقة في سياق ما.
سيكون للصراعات داخل المؤسسات الأمريكية وآلية معالجتها بين فريق ترامب ومؤسسات الدولة العميقة, انعكاساتها على شكل النظام العالمي والصراعات في المنطقة, فهل سيكون النصر فيه لترامب وفريقه؟ وبالتالي انكفاء الصراعات الدولية والتركيز على الداخل الأمريكي, وهذا ما يفسر انسحاب أمريكا من سوريا والعراق وأفغانستان؟ وسيكون هناك حالة من التوافق مع روسيا، وبالتالي عدم إعطاء أهمية كبيرة للحلف الأطلسي، وعدم تزويده بالإمكانات لانتشاره على حدود روسيا, ما يتسبب في استفزاز الأخيرة؟ أم يجب التركيز على الصين وحدها، أم سيكون للدولة العميقة القول الفصل وبالتالي سنعيش الحالة الصراعية مع العدو الأساسي الذي هو روسيا وما سيترتب عليه من صراعات في منطقتنا والعالم.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة؛ هل فعلاً ستكون الولايات المتحدة الأمريكية خارج هذه الفوضى؟ بمعنى آخر هل ستستطيع المحافظة على حالة النظام في عالم تسوده الفوضى أم أنّ هذه الفوضى ستصيبها أيضاً؟
كل هذا يُفسَّر على عدم اتخاذ قرار واضح، واستراتيجيّة عميقة للسياسة الأمريكية, أي أنّنا نتوجّه إلى عالم بلا نظام، وإلى عالم بلا مركز، ونظام جديد ليس فيه هيمنة للغرب، فنحن أمام عالم لم يتبلور بعدُ، ولم يتّضح ما يريده حتّى الآن.
المراجع
- عبدالله أوجلان، مانفيستو الحضارة الديمقراطية، المجلد الأول، مطبعة، آزادي، الطبعة الثانية، 2014
- سيرغي قره، مورزا، الاتحاد السوفييتي من النشأة الى السقوط، ت: شوكت يوسف، الهيئة السورية العامة للكتاب، 2019 .
- روبرت جاكسون، ميثاق العولمة – سلوك الانسان في عالم عامر بالدول، ت: فاضل جتكر، الرياض، مكتبة العبيكان ،2003 .
- عبد العليم محمد، واشنطن والنظام الدولي الجديد، مجلة اليوم السابع، العدد 33، 1990.
- https://studies.aljazeera.net
- https://firatn.com