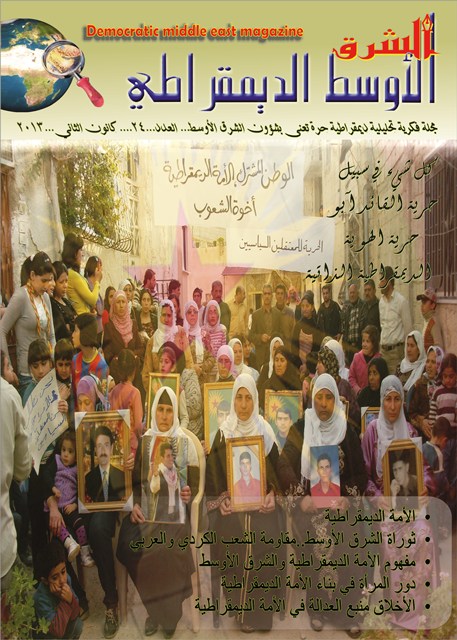الأقليات في سوريا ما بين المواطنيّة والمركزية وتكاثر الدول
صلاح الدين مسلم

صلاح الدين مسلم

- في مفهوم الأقليات
- القانون الدولي والأقليات
- الأقليات في سوريا
- داعش والأقليات
- الحداثة والأقليات وصراع الهوية
- المركزية والأقليات
- المواطنيّة والأقليات
- حلول المركزية وتكاثر الدول
في مفهوم الأقليات
إنّ المفهومَين “أقلية” و”أغلبية” حديثا العهد نسبياً في القانون الدولي، رغم وجود الاختلافات بين المجتمعات المحلية على مرّ التاريخ. ومنحت بعض النظم السياسية في الواقع حقوقاً مجتمعية خاصة لأقلياتها، على الرغم من عدم استناد ذلك إلى أي اعتراف ب “حقوق” للأقليات بهذا المعنى. فنظام الملّة في الإمبراطورية العثمانية، على سبيل المثال، كان يتيح قدراً من الاستقلال الذاتي على الصعيدين الثقافي والديني للطوائف الدينية غير المسلمة، من قبيل المسيحيين الأرثوذكس والأرمن واليهود وغيرهم. وأعلنت الثورتان الفرنسية والأمريكية في أواخر القرن الثامن عشر حرية ممارسة العقيدة بوصفها حقاً أساسياً، رغم أن أياً منهما لم تعالج بصورة مباشرة المسألة الأوسع نطاقاً المتعلقة بحماية الأقليات. واعترف مؤتمر فيينا لعام 1815، الذي فكك إمبراطورية نابليون، إلى حد ما بحقوق الأقليات، وكذلك فعلت معاهدة برلين لعام 1878، التي اعترفت ببعض الحقوق الخاصة لطائفة جبل آثوس الدينية[1].
الأقليات القومية: نشأت مع ظهور الدولة القومية في الغرب والشرق، وبعد أن وضعت الحدود، فبالضرورة أن تكون هناك أغلبية عددية قومية، وأقلية عددية قومية، وحاولت الدولة القومية الاعتماد على الأغلبية القومية في تذويب الأقليات العددية اللغوية في بوتقة الأكثرية، فالأمة الحاكمة تسعى إلى خلق مجتمع قوميّ نمطيّ متأطّر بلواء حدود صارمة وقطعية مقدّسة، وصارت حلمًا فردوسيًّا للأغلبيّة وجحيمًا للأقليّة، سواء كانت تلك الأقلية أصيلة في تلك الأرض وأقدم من اللغة الأكثرية.
لقد اختُرعت المصطلحات في تمجيد اللغة الرسمية على أنّها لغة وطنيّة جامعة، ومنهم من اعتبر اللغات غير اللغة الرسميّة على أنّها لغات ثقافيّة، وضعفت لغات الأقليات أمام هذا الاهتمام الكبير بلغة الأغلبية، وبالتالي بثقافة تلك اللغة التي جعلتها سيّدة الثقافات، وقويت اللغة الرسميّة وتضخمت فوق طاقتها أيضًا، فعلى سبيل المثال أتذكّر عندما كنتُ بالجامعة أنّ محاضرًا قدّم رسالة ماجستير بعنوان (الفاعل في اللغة العربية)، وكذلك رأيتُ كتابًا ضخمًا عن الفاتحة، التي تُقرأ في أقل من دقيقة.
وصار هناك تمجيد مبالغ لعرق دون عرق آخر، وظهرت الطبقية العرقية ضمن مجتمع الدولة القومية، مع أنّ التجمعات الأثنية الكبيرة التي تؤلّف الإنسانية قد أسهمت مساهمات خاصّة في التراث العام، فلا يمكننا الحديث عن الشرق الأوسط دون الحديث عن الكلدان والآشور والسريان والأرمن والكرد… على سبيل المثال الذين أصبحوا أقلّيّة في حدود دولة مزّقت تلك الجغرافية قبل قرن من الزمان، بعد أن كانوا أكثرية في زمن لم تكُن هناك مشكلة كبيرة لظاهرة الأقليات الحاليّة.
الأقلّيات الدينية: والمقصود هنا الأقليات التي تعتنق دينًا مخالفًا لدين الأغلبية، أو مذهبًا دينيًّا متميّزًا بسمات عقائديّة وسياسيّة تعطيه قدرًا واضحًا من التمييز العقيدي، حتّى لو انتمى في إطاره العام إلى دين الأغلبية، وقد كانت الأقلية الدينيّة اليهوديّة على سبيل المثال مضطهدة على مرّ التاريخ، وقد أثّر ذلك على طريقة نظرتها إلى الكون والطبيعة والبشر بشكل عام، فالأقلية اليهودية لم تصل إلى السلطة ولم تؤسس دولتها على مرّ التاريخ قبل إنشائها دولة إسرائيل، وكانت تعيش حياة منغلقة على نفسها، وخوفًا من الوسط المسيحي أو الإسلاميّ، وبالتالي استطاعت أن تحافظ على تقاليدها اليهوديّة التي تحوّلت مع الأيّام إلى هويّة قوميّة، ولسنا في صدد تحليل الأقلية اليهوديّة، لكن هذا الفكر الانغلاقيّ أثّر على الكثير من الأقليّات الدينيّة، مثل الإيزيديّة، الذين يمتلكون هويتين تعتبران أقلية بالنسبة للعراق، أوّلًا هم كرد، وثانيًّا هم غير مسلمين، وكذلك الأمر بالنسبة للكرد الفيليين فهناك الاضطهاد المزدوج، فهم كرد وشيعة في آن واحد، وبالتالي هم في مواجهة حرب ضروس، سواء من جانب الدولة القوميّة أو من الأقلية الكرديّة السنّيّة، “ففي كلّ رجل تتلاقى انتماءات متعدّدة تتعارض أحيانًا فيما بينها وتجبره على خيارات ممزّقة[2].” وبالتالي هناك أزمة هويّة حاليًّا، بين الهويّة القوميّة والهويّة الدينيّة، ودمجها معًا كالحالة الإسرائيليّة التي تجمع ما بين الدين اليهوديّ والثقافة اليهوديّة أو القوميّة اليهودية، وكذلك الحركات العروبيّة الإسلاميّة التي شكّلت نواة لتعصّب ثنائيّ حدّ السيف.
لا شكّ أنّ الدين ولِد كثورة ضدّ الطغيان والطبقيّة وتكديس المال وعدم المساواة، وكانت الأديان تنشأ في الطبقات الدنيا في المجتمع، كبركان يتفجّر في وجه الدولة الهرميّة الطبقيّة، ولكن بعد عدّة سنوات تعتنق الدولة دين الأغلبية وتجعلها دين الدولة، فيتحوّل الدين المجتمعيّ إلى دين السلطة، فيغيّر من أخلاقيّات الدين، ويجعله وسيلة لخلق الفتن والفساد والتعصّب وأداة لمحاكمة الشعب، فقسطنطين اعتنق الدين المسيحي بعد ثلاثة قرون من ولادة المسيح، وكذلك اعتنق الكثير من الأغنياء والتجار الدين الإسلاميّ لكي يحوّلوا الدين إلى أداة أيديولوجية لقمع المجتمعات وابتزازها، واحتكارها، ومحاربة الأقليات وإبادتها، فالأندلس على سبيل المثال عندما كانت تحت الحكم الإسلامي كانت الأغلبية فيه للدين الإسلامي، وكان المسيحيّون أقلّيّة، بل لم يبق ذكر للمسيحيين في الأندلس، وعندما حكمها الإسبان بعد سقوط الأندلس صار الدين الإسلامي أقلّيّة في إسبانيا، بل لم يبق فيها مسلمون، وتنصّر الكثير من المسلمين مع جرائم محاكم التفتيش.
لقد أفضت هذه الثقافة الإقصائيّة على مرّ التاريخ إلى تقوقع الكثير من الأقليات في حاضنات بعيدة عن المركز تحافظ على عاداتها وتقاليدها التي تعتبر هويّة لها، والتي تستطيع الفكاك منها، فلا يستطيع مجتمع أن يعيش من دون هويّة، فعاشت الكثير من الحضارات التي أصبحت أقلّية في الجبال منعزلة عن الواقع المدينيّ الإقصائي، وصار يطلق عليهم كلمة بربري أو همجيّ أو وحشيّ، “ومن المرجّح أنّ كلمة بربري تقود من الناحية اللغوية إلى غموض وجمجمة أفاني العصافير، بمواجهة القيمة التعبيرية للغة البشرية، وكذلك كلمة متوحّش التي تعني أنّه آت من الغابة، تذكر بنوع من الحياة الحيوانية بمواجهة الثقافة الإنسانيّة. وفي كلتا الحالتين نرفض القبول بواقعة تنوّع الثقافة نفسها، ونفضل أن نرمي خارج الثقافة، في الطبيعة، كل ما لا يتوافق مع القواعد التي نعيش في ظلّها[3].” وبالمقابل اندمجت بعض الأقليات في المدينة، في حارات منعزلة، وبفضل صناعتها وتجارتها استطاعت أن تحمي نفسها، كالأرمن والمسيحيين في سوريا والعراق وتركيا…
القانون الدولي والأقليات
أضحى الغرب منصوبًا كقاضٍ عالميّ على حساب القيم والمثل المحلية، فبعد النهضة العلميّة في أوروبا والحربين العالميتين الأولى والثانية، ترسّخت الليبرالية ومبادئ حقوق الإنسان والأقليات من ضمنها، في منظمات حكومية وغير حكومية وتحت قبة الاتحاد الأوروبي وخارجها، ومن خلال التضحيات التي قدّمها الغرب، كضحيّة التعصّب القومي الذي كان ناتجًا طبيعيًّا للدولة القوميّة التي نشأت في الغرب، وصارت مثالًا يحتذى به والفردوس المعهود المفقود، وأكثر من دفع فاتورة الدولة القوميّة هي الدول التي اخترعت هذه الفكرة وروّجت لها، ولكنّها مازالت أسيرة هذا الفكر الإقصائي لبقيّة الأقليات، إذ “كيف يمكن الحديث عن تمتّع فرد ما بحقوقه كإنسان إذا ما كان محرومًا من الحقوق التي تتصل بهويته كعضو في جماعة متمايزة بهويتها[4]؟”
إنّ القانون الدولي لا يراعي التنوّع الثقافي ونظرة الثقافات للكون، فالإنسان في الشرق على سبيل المثال يؤمن بشيء لا يدركه الغرب، ومن هنا جاء الاغتراب الشرقي لعلمنة المعرفة عند الغرب، والحقيقة الكلّية ليست استئثار أيّة ثقافة وإنّما هي حصيلة التقارب.
هناك فكرة أورَبَة الكوكب، وفردنة العلاقات الإنسانية كلّها وتقويض بنيتها، ومن بعدها تقويض النظام الاجتماعي الذي يحكمها إذ يقول جوزيف ياكوب في هذا السياق: “إنّ استبداد حقوق الإنسان يُحَلُّ من خلال شرعنة كلّ الثقافات[5].”
ففكرة الدولة القومية التي انبثقت من الغرب وانتشرت في الشرق عن طريق المستشرقين والمتنورين قد ألقت بظلالها السلبية على كلّ هذه المآسي في الغرب والشرق على حدّ سواء، فكلّ المآسي التطهيرية الإباديّة من تطهير الأرمن قبل قرن إلى عمليات الصهر والإبادة في كلّ دول الشرق الأوسط قد ألقت بظلالها المأساوية، فلم نرَ هكذا عمليات تطهير ممنهجة قبل قرن من الآن، فصحيح كانت هناك نسف للحضارات وعمليات انتقام من الحضارات المغلوبة، منذ البابليين والآشوريين وصولًا إلى هولاكو، لكن عمليات التطهير كانت لبسط السيادة الإمبراطوريّة، وليس عمليات قولبة للمجتمع وصهره في لغة ودين الأغلبية.
لا شكّ أنّ الأقليات في العالم باتت متخلّفة مقارنة بالأكثرية، عبر بوتقة تأطير اللغة الرسمية كلغة التعليم والسلطة، فهي لا تعرف علم الاجتماع – علم الألسنة – علم الاجتماع الأثني – علم السلالة – علم اللغات – علم اللغات الأثني – علم الأثريات – علم النفس الاجتماعي – التحليل النفسي – دراسة الحضارات… وهذا ما يؤثّر على واضعي القانون أو حقوق الإنسان، فالأقليات في الشرق كالكرد على سبيل المثال من خلال تقوقعهم على ذاتهم في لقرن الماضي باتوا بربريين بالنسبة للأغلبية؛ خريجي مدارس الدولة القومية التي تشرّبت ثقافة الأكثرية والنمطيّة والنظرة الإقصائية للأقليّات، بالطبع ليس الذنب ذنب الأكثرية في هذه العملية الإقصائيّة، بل المشكلة في نظام الحكم المركزيّ لهيمنة الدولة القوميّة التي زرعت أفكارها عبر المدارس والجامعات ووسائل الإعلام، مع أنّ معظم الدول العربية كالعراق وسوريا والأردن ولبنان قد صادقت على المواثيق الأساسية للأمم المتّحدة المتعلّقة بحقوق الإنسان – وإن كانت من نظرة الغرب إلى الشرق – والتي تعترف من بين حقوق أخرى بحقّ الأقليات ولكنّها لا تحترم تلك الالتزامات التي أبرمتها طواعية.
بالمقابل نرى الخوف من هذه الحداثة التنويرية الغربيّة، وعدم الاستفادة من تجاربها الإيجابيّة، من خلال وائل الخطاب الدولتي (الإعلام والتعليم)، فالمجتمع متخوّف من ناحية أخرى من هذه الثقافة الفرديّة، التي تصوير الحداثة على أنّها حصان طروادة ثقافة غربيّة غريبة عنهم، وبالتالي يتمّ الخوف منها من خلال التأثير على الهويّة، وهي مثار شبهة، وعندما يتمّ محاربة هذه العولمة والحداثة، يكون البحث من قبل الحداثويين عن آليات الخرق لهذا الحصن المتين عبر زرع الفوضى التي بإمكانها أن تخلق تصدّعًا للجدار وتقبُّل موجات الحداثة، وذلك من خلال الاختراق في عقول المفكرين الذين يرون أنّ الحداثة هي الحبل والرابط ما بين الحداثة كفكر تنويري علمي يساعد في رقيّ المجتمعات والحداثة كمشروع ينسف الهويّات في بوتقة الدولة القومية التي تلغي كل القوميّات، والدولة القوميّة تحارب هذه الحداثة من ناحية، وتشاركها الأفكار السلطويّة من ناحية أخرى، وبالتالي نرى الجنون الدولتي في الانتقام من الشعوب والأقليات في الدولة، وكذلك الأمر ينطبق على المجتمع المشوّه بفعل هذه التلاعبات بمصيره، “فعندما يتحوّل رجل سليم العقل بين ليلة وضحاها إلى قاتل، فهناك جنون بالتأكيد. ولكن عندما يوجد آلاف وملايين القتلة، وتتكرّر الظاهرة من بلد إلى آخر، في قلب ثقافات مختلفة، عند أتباع جميع الديانات مثلما عند الذين لا يدينون بأيّ منها، فلا يكفي أن نقول “جنون” ما ندعوه تساهلًا “جنون قاتل” هو تلك النزعة عند أمثالنا لأن يتحوّلوا إلى جزّارين عندما يشعرون أن قبيلتهم مهدّدة[6].” وهذا ما رأيناه فيما يسمّى بالأحداث في سوريّة.
الأقليات في سوريا
إنّ سوريا هي بقعة مقتطعة من منطقة التنوّع الأثني في الشرق الأوسط، ولكلّ أثنيّة امتدادها التاريخي والجغرافي لدول الجوار التي حدّدتها اتفاقية سايكس بيكو 1918 التي قسّمت كلّ هذه الأثنيات لحدود لم تراعِ الامتداد الأثنيّ للكرد والأرمن والسريان والمسيحيين والتركمان والآشوريين والعلويين والعرب السنة وباقي الأثنيات والأعراق، فهناك كرد في العراق وسوريا وإيران وتركيا، وكذلك المسحيون، والأرمن… وهناك امتداد عشائري ما بين الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين والسعودية… ناهيك عن التنوّع الأثني التاريخي الكبير في المدن الكبيرة مثل دمشق وحلب وحمص والقامشلي وغيرها.
وتعدّ منطقة سوريا منطقة صراع حضارات عبر تاريخ نشوء الدول، ناهيك عن منطقة حوض الفرات التي كانت حدود الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية طوال عقود من الزمن، وكانت منطقة الهروب من النزاعات، ونستطيع أن نطلق عليها كمنطقة آمنة أو فاصلة لنزوح العديد من الأعراق هربًا من حرب الدول المتصارعة.
لم تكن الحرب التي تحصل ما بين الإمبراطوريات على الرغم من وحشيتها حربَ أقليّات، وإنّما كانت حرب سيطرة الدول، وبسط النفوذ، لم تكن ظاهرة الأقليات في سوريا مشكلة كبيرة ما بعد جلاء الانتداب الفرنسيّ عن سوريا في عام 1946 مشكلة فناء وإبادة مثلما حصل في الأحداث السورية، فلم يكن هذا التمايز الأقلّوي مرضًا قاتلًا، ولكن ما بعد تحوّل الدولة إلى دولة قوميّة ما بعد اتحاد مصر وسوريا عبر الجمهوريّة العربيّة المتّحدة بقيادة جمال عبد الناصر، عام 1958 حيث ظهرت المخاطر الأقلويّة، وبدأت الاحتقانات، والخوف من تشظّي الهويّة، فإنّ تحوّل الجمهورية السوريّة إلى جمهوريّة عربيّة سورية كان بحدّ ذاته إقصاءًا للأقليات غير العربيّة، والدستور الذي اشترط أن يكون رئيس الجمهوريّة عربيًّا مسلمًا، أضحى إقصاءً للأقليات غير المسلمة، ومن هنا تفاقمت المشاكل الأقلوية، فالعلويون يشكّلون 13% من نسبة سكّان سوريا والدروز: 3,5% والمرشديون والإسماعيليون: 3% والكرد بطوائفهم وأديانهم (العلوي – السني – الإيزيدي): 15% والشيعة: 2% التركمان والشركس: لا توجد إحصائية دقيقة حوالي 3% والمسحيون بطوائفهم وأثنياتهم 10% والغالبية عرب سنة أكثر من 50%. أي أنّ الدولة القوميّة اختصرت هويّة الدولة في 50% ونفت النصف الآخر، أو قبلتهم عبر نسف هوياتهم والانصهار في هويّة الدولة القوميّة.
إنّ ربيع المجتمعات الذي تحوّل عبر محوري المصطلحات إلى الربيع العربي، قد أخرج النزعات الأقلّيّة وتحوّلت الجماعات المسلّحة إلى جماعات قاتلة فانية للأقليات، وكان خروج المظاهرات من الجوامع في يوم الجمعة إقصاء لكلّ الأقليات المجتمعيّة التي لم تكن راضيّة عن الدولة القوميّة الإقصائيّة، والنظرة الأقلّويّة للحكم في سوريا، عبر توصيفها أنّها حكم الأقلّيّة العلويّة، والتي أصبحت تهمة يمكن أن يكون الحدّ هو الذبح، بمجرّد تهمة النصيرية، والتي تدلّ في مدلولها على استحضار الكلمة التاريخيّة (النصيريّة) التي لم تكن متداولة من قبل، ومن جهة أخرى زرع الخوف من الفناء والدمار الشامل إذا استلم العرب المسلمون السُّنّة الحكم، وبالتالي كان اللعب على وتر الأقلّيات تحايلًا على جوهر الصراع الحقيقي ما بين المجتمع ومفهوم الدولة.
داعش والأقليات
لطالما كانت هناك آيات قرآنية تميّز أمّة الإسلام عن بقيّة الأمم، وكانت لها أسباب سياسيّة حينها، ولكن ظلّت هذه الآيات ركائز تعتمد عليها الجماعات التعصّبيّة الإقصائيّة للأقليات، كالآية التي تقول: “كُنتمْ خَيْرَ أمَّةٍ أُخْرِجَتْ للِناَّسِ تأمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنْهوَنَ عَنِ الْمُنكَر” والآيات التي تدلّ على أنّ الإنسان مسيّرٌ وليس مخيّرًا، وأسماء الله الحسنى لها قسمان قسم يدلّ على الجمال (الجميل، الرحمن، الرحيم..) وقسم يدلّ على الجلال (المنتقم، الجبّار، المتكبّر…).
وقد كان الصراع محتدمًا ما بين الجلاليين والجماليين، فالمتصوفة كانوا روّاد الجمال الإسلاميّ، بينما استند الخلفاء والأمراء على الجلال الإسلاميّ، فتدرّج الدين الإسلاميّ من البساطة إلى التعقيد، فالمذهب المالكيّ على سبيل المثال كان مذهبًا بسيطًا سمحًا مقارنة بالحنفية مرورً بالشافعية وصولًا إلى الحنبلية، حتّى وصلت إلى الوهابية فالقاعديّة فالداعشيّة، ولا ندري غدًا أي مذهب أكثر تشدّدًا وتطرّفًا سوف يولد، فعبر الصيرورة التاريخيّة على مدى أربعة عشر قرنًا انتصر روّاد الجلال وصولًا إلى داعش، وانهزم فكر المتصوفين الذين ظلّوا في عزلتهم عن هذا التيار المتشدّد التكفيري، غير المؤمنين بالحرب وإراقة الدماء، وكانوا يحبون الله فيعبدونه، لا يخشونه فيعبدونه، أو يبحثون عن الشهوات فيعبدونه.
كانت الدولة الإسلاميّة (داعش) في ذروة التعصّب الدينيّ عبر التاريخ، وهي خلاصة التاريخ التعصّبيّ للثيوقراطيّة [7]الإسلاميّة، وهي امتداد للتاريخ الدمويّ للجماعات التكفيريّة الحالمة بالسلطة منذ الخلافات الدمويّة بعد وفاة النبيّ محمّد مرورًا بالخوارج والدمويّة الأمويّة، والسواد الفاشيّ العباسيّ وصولًا إلى الأخوان المسلمين فالقاعدة فداعش، وكانت الدولة الإسلاميّة القالب الأشدّ وطأ من الفاشيّة القوميّة في ظل الدولة القوميّة ذات النمط الواحد في اللغة الواحدة والثقافة الواحدة، والشعب الواحد.
لقد شوّه داعش الهويّة الإسلاميّة، فاختصر الإسلام في الشهوات (المال – السلطة – النساء) ولا بدّ من الاعتماد على القوّة والعنف، وتدمير المرأة نهائيًّا لبسط السلطة القويّة، ومحاربة كلّ أشكال الضعف، والأقليات ضعيفة أمام الأكثريّة فبالتالي أصبح محاربتها من أساسيّات الدولة الإسلاميّة، لكن هناك التاريخ الذي أوصل هذا الفكر إلى هذه الصورة.
لقد كان الفقه يعني الفهم والإدراك، لكن بعد ضعف الخلافة الإسلامية العباسيّة والعثمانية وانهيارها صارت بمعنى ترديد المعرفة وتطبيق النص كما فهمه القدماء، والتعلّق بالماضي السلف الذي بات خيرا من الخلف، فصورة المجد التليد باتت ضمن ذهنية المتفقهين، والماضيون هم الأعلم، فتقلصَّ الفقه الإِسلامي وبات صورة تكرارية عن الماضي، فبات تيار المحافظين الإسلاميين الجدد يرى أنّ القرآن يحتوي على كلّ المعرفة، بعد أن كانت هناك جلسات فكرية عميقة في بغداد في عصر المأمون، تحوّل الفقه إلى الابتعاد عن الفكر التنويري، وأضحى تنقية الفكر الدينيّ من كلّ التأثيرات الأجنبيّة الهاجس الأساس لدى المتفقّهين الجدد الذين مهّدوا لظهور التيّارات الإسلامية التعصّبيّة المتشدّدة التي مهّدت لظهور داعش، “ثمَّ شُيطنتْ الفلسفة والعلوم، فضلًا عن اضطهاد الأقليات والنسّاء. ما أدى لموت التبّادل الثقّافي الإِسلامي مع المُفكّرين غير المُسلمِين الامر الذي أدى بدوره إلى عقم ثقافي وركود مجتمعي وعلمي. أضف إلى ذلك اكتشاف الطريق البحري المعروف باسم رأس الرّجاء الصّالح من قبل المستكشف البرتغالي فاسكو ديجاما عام 1177 ممّا ساعد على التقّليل من أهميةّ الشّرق الأوسط عالميًّا[8].”
إنّ تدمير الثقافات الذي وصل إلى تدمير تماثيل بوذا في أفغانستان، وتدمير الآثار في الموصل وصولًا إلى الرقة، ومحاربة كلّ الثقافات العريقة، وانتهاج سياسات متناقضة تجاه الأقليات الأثنيّة، فمن جانب كانت هناك قوميّات من أنحاء العالم كافة حيث انضمّت إلى التنظيم من كل الأعراق والأنساب في العالم، وبالمقابل كانت هناك محاربة للأثنيّات المحلّية، وتكفير للكرد، وعدم القبول أن يتحدّث أحد باللغات المحلّية، وبالطبع تقديس اللغة العربيّة بما أنّها لغة القرآن ولغة أهل الجنّة، وتقديس الشام التي تعتبر أرض الأنبياء، بل الجنّة الموعودة عبر التاريخ الإسلاميّ التي اعتبرت الشام والعراق المليئة بأوصاف الجنّة المختلفة عن الصحراء في شبه الجزيرة العربية؛ مولد الإسلام.
بالمقابل كانت هناك محاربة لكلّ الأقليات الدينيّة غير الإسلاميّة على طريقة داعش، وتكفير كلّ التيارات الإسلاميّة التي لا تمشي على خطا داعش “وإنّ العالم المعاصر شهد بعُدًا جديدًا لخطر فكرة الجهاد مع ظهور أول دولة في القرن الحادي والعشرين ترتكز على مبادئ الشريعة وفكرة سمو الإسلام فوق كل الديانات. ومع ظهور داعش طفا على السطح سؤال: هل الدواعش يمارسون الإِسلام الحقيقي أم يقومون بتزييف الدين لخدمة أهدافهم الخاصّة؟
هنا يقول حامد عبد الصمد: “الإجابة على هذا السؤال تعتبر مشكلة سواء أجبنا بالنفي أو بالإيجاب. فلو قلنا إن داعش “لا” تمثل الإسلام، فمعنى ذلك أنه يمكننا مواصلة تدريس نفس نصوص الإسلام ونفس الآراء الفقهية القديمة وكأن شيئًا لم يكن، ولا داعي لأي إصلاح. لكن لو قلنا إن داعش “تمثل” الإسلام وتطبق نصوصه بضمير، فهي دعوة صريحة ومباشرة لكل شاب مسلم إما أن يترك الإسلام أو أن يلتحق بداعش. لقد أصابت الأعمال الإجرامية لداعش الكثير من المسلمين بالذعر من الإسلام المسلّح وجعلتهم أكثر قابلية لفكرة مراجعة التراث ومحاربة الإرهاب باسم الدين. ولكن على الجانب الآخر فإن البعض منهم رأى في داعش بشائر تحقيق الوعد الإلهي. بانتصار الإسلام[9].”
كأنّ الخيار المطروح هو إمّا الإسلام الداعشيّ أو الهروب من الذاكرة الإسلاميّة، وهنا مشكلة البحث عن الهويّة، وكأنّ المواطنيّة هي الحلّ الأمثل، وإلّا صور مجازر داعش أو الخراب في كوباني والرقة والموصل ماثلة أمام الأذهان، وهي ترعب من يرد أن يجعل الإسلام هويّة له.
الحداثة والأقليات وصراع الهوية
لقد طرح الغرب نفسه عبر التاريخ كمفهوم عالمي، أي كنموذج معياري وتعبير نهائي عن التطور البشري، ومن هنا خرج مفهوم العالمية أي أن كل ما يشبه الحضارة الغربيّة هو عالميّ، ومن هنا كانت فوقية الحضارة الغربية، وبالتالي شرعنت السلطة، وظهرت هرميّة الثقافات والأعراق والأجناس، فالغرب يحوّل الاستعمار إلى رسالة حضارية، ومقاومة الاستعمار إلى إرهاب وتخريب، والعكس صحيح بالنسبة للمُستعمَر.
يبدأ الغرب الآن بإعادة بناء الهوية، من خلال عملية التجريد من الوعي الذاتي بعد إفراغها من التراث وقطعها من كل الجذور بشكل يجعلها تتقبّل وضعها الجديد كطرف خاضع للسيطرة وتُقِرُّ بِه وترضى. لكنّ العولمة لاقت ردّة فعل كبير في المجتمع الشرقي، فصار هناك خوف من هذا المدّ العولمي، وبالتالي صار هناك انطواء على الهوية مقابل الترابط الاقتصاديّ، والشركات عابرة القارات، وهذا المدّ الاتصالاتي الذي لا يهدأ.
“فالذاكرة هي بالطبع الأرضية الأمثل لإعادة بناء الهوية. وهكذا يصبح المؤرخ، مؤرخ السلطة الجديدة المسيطرة، هو «المدير المحلَّف» المسؤول عن الذاكرة، فيعطي الروح والمضمون إلى مؤسسة الحضارة ويحوّل سفينة تجارة الرقيق إلى أداة اكتشاف وتجارة. هو أيضاً من يعيد إعطاء هوية جديدة للأماكن عبر تحويل سوق العبيد إلى «مكان تجاري»، وحصون اعتقال العبيد ونقلهم إلى «قلاع للدفاع والحماية»، ومقابر الرقيق، خاصة المقابر الجماعية منها، إلى أراضٍ مجهولة الهوية سرعان ما تخفيها المباني الإدارية أو التجارية[10].”
“إذ يعاني العالم الغربي راهناً من أعراض “أزمة هويتية” عميقة يبدو أنه غير مدرك لواقعها وأبعادها. وتبرز هذه الأعراض بشكل خاص في التوتر الواضح بين تضخّم موقفه (أو خطابه) المرتبط بالحضارة الكونية، والطابع المحوري الذي تتخذه أزمة الهوية فيه، وكذلك في علاقته ببقية العالم. هذه العلاقة تُختزلُ بالتسليع وإرساء الأمن وتعميم الطابع الإنساني، وفي اضطرابه وضيقه الشديد أمام التنوّع الثقافي والأثني والديني[11].”
إنّ الجوهر في نسق الحقيقة هو البحث عمّا هو خيّر، وليس البحث عمّا هو صواب، لكن العلم أو النظام العالمي العلميّ الجديد يبحث عمّا هو صواب ولا يهمّه إن كان خيّرًا أو لا، من هنا بدأت الأزمة العالميّة الحداثويّة العلمويّة، وبدأت الحروب الأقلويّة، وتفاقمت في القرنين الماضيين ومازالت في حرب ضروس، وكأنّها الطاعون الجديد.
ما انفكّ النضال ضدّ أيّ تهديد يهدّد الهويّة هو الهاجس الأوّل والأخير للإنسان الشرقيّ، فالغربيّ قد أصبح مدجّنًا بمفهوم المواطنيّة، والفردانيّة في الدولة العصريّة، وهو الحلّ السحرّيّ الذي سنعالجه فيما يأتي، لكنّ ما هي الهويّة؟ وما هو الانتماء؟
“يوجد في كل العصور أناس يعتبرون أنّ هناك انتماءً واحدًا مسيطرًا، يفوق كل الانتماءات الأخرى وفي كلّ الظروف، إلى درجة أنّه يحقّ لنا أن ندعو “هوية”. هذا الانتماء هو الوطن بالنسبة لبعضهم والدين بالنسبة لبعضهم الآخر. ولكن يكفي أن نجول بنظرنا على مختلف الصراعات التي تدور حول العالم لنتنبه إلى أن أي انتماء لا يسود بشكل مطلق. فحيث يشعر الناس أنّهم مهدّدون في عقيدتهم يبدو أن الانتماء الديني هو الذي يختزل هويتهم كلها. ولكن لو كانت لغتهم الأم ومجموعتهم الأثنية هي المهددة لقاتلوا بعنف ضدّ أخوتهم في الدين[12].”
لقد تمخّض عن هذه الحرب الطاحنة في سوريا صراع للأقليات أفرزت تغييرًا في الديمغرافية السورية، فانزاحت أقلّيات وأكثريات، فهربت معظم الأقلّيات من سوريا إلى الغرب، وظهرت أزمة الهويّة من خلال الاغتراب الكبير الذي حصل، “ولم يعد وضع المهاجر وضع مجموعة من الأشخاص الذين اقتلعوا من الوسط الذي يحتضنهم، لقد اكتسب قيمة نموذجيّة، فهو الضحية الأولى لمفهوم الهويّة القبائليّ. إذا كان هناك انتماء واحد بهم، وإذا كان لا بدّ من الاختيار، فسيجد المهاجر أنّه منقسم وممزّق ومحكوم عليه بأن يخون إمّا وطنه الأصليّ وإمّا الوطن المضيف، وهي خيانة سيحياها حتمًا بمرارة وغضب[13].” وهنا يظهر التشظّي الآخر في الشخصيّة، عبر أزمة الهويّة السوريّة وهويّة الدولة التي هاجر إليها، وهي إحدى مفرزات التدخّل الغربيّ في الشرق.
وبالمقابل ظهر في الداخل السوريّ تشظٍّ آخر؛ وهو الخوف من الهويّة، وتقلّب الهويّة، فإذا سئل سوريّ عن هويته وهو يعيش تحت كنف داعش عن هويته، بالطبع سيقول: “إنّني أنتمي إلى الدولة الإسلاميّة، وهويّتي هي الإسلام”، ونفس الشخص عندما يسأل وهو في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري أنّه عربيّ سوريّ، وفي الشمال السوريّ سيؤكّد على سوريّته، وقد يقول: إنّي شامي (نسبة إلى بلاد الشام) أو أنتمي إلى الوطن العربي، أو سوريا الكبرى حسب خارطة الحزب القومي السوري التي تضمّ قبرص أيضًا، لكنّه سيقول: إنّي أنتمي إلى هذا الكون عندما يكون مقعدًا لا يستطيع الحراك، كعالم الفيزياء ستيفن هوكينغ [14]الذي يقول: “نحن جميعًا مختلفون، ولا يوجد شيء اسمه إنسان قياسيّ أو نموذجي، بل إنّنا نشترك في نفس الروح البشريّة[15].”
المركزية والأقليات
إنّ هيمنة المركز على كلّ الأطراف في الدولة المركزية تجعل من اللغة الرسمية قالبًا للأكثريّة، وبالتالي تلاقي ردّة فعل متطرّفة تجاه صرامة المركزية وتطرّفها، من خلال إعلاء قومية على حساب أخرى، والحديث عن الهويات يكون ضمن الإطار الذي تحدّده الدولة المركزية، فهناك هويات يمكن الحديث عنها، وهويّات مرفوضة لا يجوز التحدّث عنها، ففي ظلّ المركزية تتضرّر القوميات والأقليات وتهدر حقوقها، وتنتهك حقوق الإنسان.
فالحركات المطلبية الأقلويّة تعمّ العالم وتنتشر وتتكاثر في بنية المجتمعات المدنية بطريقة معبرة، وتطرح أساس الدولة للمناقشة، فإذا كان القرن العشرون انتصارًا للدولة فالقرن الواحد والعشرين سيكون عصر تحطيمها، ويؤكّد هذا القول جوزيف ياكوب بقوله: ” إنّ القرن المقبل هو قرن الأقلّيّات، لأنّ العولمة تترك على هامشها شعوبًا وفئات اجتماعية تشدّد أكثر فأكثر على خصوصياتها، فهي مسعى منها لتأكيد هويتها[16].”
إنّ المركزيّة تسعى إلى ابتلاع كلّ المكونات الفسيفسائيّة، وفرض القالبية والنمطيّة على الدولة القومية المركزيّة، وبقدر ما تشدّد على المكونات المختلفة وتكثيفها في قبضتها قسرًا وتسعى إلى اجتذابها بالطرق كلّها، بقدر ما تتكوّن ردود فعل نابذة رافضة منغلقة منطوية، تبحث بكلّ الطرق عن الانعتاق من هذه القبضة القامعة، بكلّ ما تقوى عليها من طرق علمية وفلسفية ودينيّة وميتافيزيقيّة فتنفخ في الجزئيات وتضخّمها، وتكره لغة الأغلبية، وتضخم لغة الأقلية وتمنح القدسية، وكلّ من يخرج عن الملّة يصبح خائنًا، فتقوى الحركات الثوريّة، والطاقة الكامنة.
المواطنيّة والأقليات
كيف لعربي مهاجر إلى بريطانيا أن يقتنع أنّ ريتشارد قلب الأسد والجنرال كلايف ولورد كيتشنر، المعروفون بكرههم المسلمين أن يكونوا أبطالًا بالنسبة لهم؟ وكيف يستطيع سوريّ حاصل على الجنسية الفرنسيّة أن يقتنع ويؤمن بالجنرال غورو الذي احتلّ سوريا والذي يعدّ بطلًا فرنسيًّا؟ وكيف لإيزيديّ في شنكال أن يقتنع أنّ عيّاض بن غنم صحابيّ جليل وله عدّة مناقب ومن أشهر قواد الفتوح الإسلاميّة؟ فالكاتب الغربيّ يحوّل سفينة تجارة الرقيق إلى أداة اكتشاف وتجارة، ويعيد إعطاء هوية جديدة للأماكن عبر تحويل سوق العبيد إلى «مكان تجاري»، وحصون اعتقال العبيد ونقلهم إلى «قلاع للدفاع والحماية»، ومقابر الرقيق، خاصة المقابر الجماعية منها، إلى أراضٍ مجهولة الهوية سرعان ما تخفيها المباني الإدارية أو التجارية. والعبيد ليس من بينهم كاتب لكي يصوّر تاريخ القهر عبر عصور الحضارات التي كتبت تاريخها المدنيّ. “ويشارك عالم الأنثروبولوجيا في هذا التمرين عبر إعادة نعت تاريخ الشعوب الخاضعة للسيطرة بـ «الأساطير» وآلهتهم بـ «الأوثان» وروحانياتهم بـ «المعتقدات السحرية والبدائية» ولغاتهم بـ «اللهجات». من أهم الأدوات المستخدمة في عملية «التجديد» هذه، التعليم، لا سيما كتابة التاريخ وتدريسه، إضافة إلى تحديد شخصيات رمزية لتبجيلها وتعيين أحداث ومناسبات لتخليد الذكرى الواجب الاحتفاء بها[17].”
لقد ربط الفكر الغربي مفهوم الديمقراطية بشكل مباشر بمفهوم المواطنية، وأكّد على أنّه لا يمكن أن يقوم النظام الديمقراطي إلّا إذا كان الفرد في مجتمعه متمسكاً بحقوقه ويقوم بواجباته ويشارك بشكل واع في صياغة السياسات العامة ومحاسبة ممثليه في الندوة النيابية والسلطة التنفيذية.
وتعتمد المواطنية على مجموعة من المبادئ أهمّها المساواة في الحقوق والواجبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمشاركة الفعالة والمساءلة واحترام دولة القانون، فالمواطنية صفة سياسية بدلاً من التبعية للزعماء كما يصفها روّادها.
إنّ المواطنية هي تبعية الفرد التامة للدولة، من خلال الحقوق والواجبات، لكن من يحدّد الحقوق والواجبات؟ بالطبع هو القانون وليس العرف ورئيس العشيرة، ومن خلال هذا التعريف استبدل الزعيم أو القائد أو رئيس العشيرة بسلطة الدولة، وبالتالي كانت هذه الوصفة السحريّة للقضاء على ظاهرة تكاثر الأقليّات، بعد تكاثر الدول، لكن ظلّ الانتماء الأثني طاغيًا على الانتماء المدني (المواطنة) في الغرب والشرق على السواء.
يقول الباحث عبدالحكيم مراد؛ المحاضر في الدراسات الإسلامية في كلية “ديفينيتي” التابعة لجامعة كامبريدج الإنكليزية، “على الرغم من إصرار الحكومة على إدخال دروس “المواطنية” في المنهاج الوطني التعليمي يرى الجميع أنّ الدروس لا تدرّس جيداً والسبب يكمن في غياب إجماع وطني حول ماهية الهوية البريطانية[18]“.
“ومن جهته، قام جاك سترو[19]، بزيادة موضوع المسلمين والطابع البريطاني سوءاً من خلال مقاله عن سياسات الهوية الذي نشرته “وورلد توداي[20]“. كتب سترو في المقال أنّه في بريطانيا “ثمة مكان لمختلف الهويات ولكن عليها أن تتعهد بأن تلك الهويات لا يجب أن تهيمن على القيم الديموقراطية الأساسية أي الحرية والعدل والتسامح والتعددية التي تعرّف معنى ان يكون المرء بريطانياً. هذه هي الصفقة وهي غير قابلة للتفاوض[21]“.
لكن هناك نقطة جيدة في المواطنية المتعددة حيث يسمح هذا المفهوم للأفراد بأن يكونوا مواطنين لأكثر من دولة أو هيئة تنظيمية في آن واحد، وهنا تكمن بعض العدالة في المواطنيّة. لكنّ المواطنية الديموقراطية التي تعدّ الرابط المدني بين أفراد ينتمون إلى ثقافات متعددة، وتسمح بأن تعمل الدول على وضع إطارٍ يعزّز مفهوم الديموقراطية عبر سياسيات تربوية وتدريبية وثقافية وشبابية مع تحديد استراتيجيات ومقاربات بهدف الوصول إليها، وبالتالي تضع الأكثرية هذه الإسترتيجيّات.
فالديموقراطية تعبير إغريقي الاصل مشتق من كلمتين، Demos Kratos ، وكلمة Demos تعني الشعب وكلمة Kratos تعني السلطة، ويقصد بالشعب بمدلوله السياسي لا الاجتماعي، أي من لهم حقّ التمتع بالحقوق السياسية، وبالتالي تلغى الأكثرية والأغلبيّة، وسياسة الدولة هي التي تعتبر شعبًا بدلًا من الشعوب المنضوية تحت سقف سلطة الدولة، وكلمة السلطة والديمقراطيّة متنافيتنا ومتناقضتان كلّ التناقض، حيث تدّعي (الدولة – السلطة) الأخلاق عند الحاجة، وهي تعترف بالقانون فحسب ولا تعترف بالأخلاق.
يحضرني قول أمين معلوف في هذا السياق: قانون الأكثريّة ليس دائماً مرادفاً للديمقراطيّة والحرّيّة والمساواة، بل هو أحياناً مرادف للطغيان والاستعباد والتمييز العنصريّ[22].. وعندما تعاني إحدى الأقليات من القمع، لا يحرّرها الاقتراع العام بالضرورة بل قد يضيق عليها الخناق.
ارتبط مفهوم المواطنيّة بالمجتمع المدني الذي يعتبر مجموع الروابط والهيئات والمنظمات والمؤسسات التي تنشأ بشكل حر في المجتمع وبدون ارتباط مباشر بالسلطة أو تدخل منها، “إذ تُعتبر الحرية شرطاً لقيام المجتمع المدني، وأنشطة المجتمع المدني متعددة ومتنوعة وتشمل جميع قطاعات المجتمع وطبقاته واهتماماته، ولهذا فإن “المجتمع المدني” الحيوي هو الذي يتمكن أفراده من تكوين أعمالهم الجماعية وممارسة أنشطتهم بصورة مستقلة عن مؤسسات الدولة، ولكن ضمن “حكم القانون الدستوري” العادل والمقبول من المجتمع[23].” وبالتالي لم يخرج تعريف المجتمع المدني خارج منظومة (الدولة – السلطة) ضمن القانون الدستوري، وبالتالي عدم الاعتماد على الأخلاق أبدًا.
حلول المركزية وتكاثر الدول
إنّ الحركات الأقلويّة تعاني من مشكلة الحلّ، وهي في مأزق نظري وسياسي في ظل الوضع الانتقالي العالميّ، فهي إذا ما وصلت إلى السلطة سوف تعيد إنتاج نموذج الدولة القومية (النموذج التقليدي الأوروبي) الذي تنتقده بشدّة، وهذا هو الفخّ الذي وقع فيه الثوريون عبر التاريخ في تقليد نظام الحكم الذي ثاروا عليه، وهذا الخطأ مازال يتكرّر إلى يومنا هذا، وخاصة في القرن الواحد والعشرين الذي أصبح عقيمًا لا يولد الحلول.
تنبع مشكلة الأكثرية في عدم معرفة الحقيقة النابعة من كون الأقلية هي مرآة الأكثرية، والعكس صحيح، يقول دودو ديان[24]: “الجهل بالآخر جهل بالذات” فمن هنا ينبع مفهوم تكامل معرفة الهوية، فلا هويّة من دون الآخر، فالآخر هو مرآتك، كي تميّز نفسك عنه، وكي تعرف نفسك، وإلّا سيكون الجمود العقائدي هو الهويّة الجديدة ونفي الآخر والقالبية والنمطيّة وتضخيم الذات، فتضخيم لغة الأقلية وثقافتها هو تحريف للهويّة أيضًا، فلا بدّ من “إيجاد إدارة مشتركة لتعددية الهويات والثقافات داخل الدول في مجتمعاتنا التي تنحو نحو الكوسموبولوتية [25]بشكل متزايد، أي ابتكار إرادة جديدة للعيش المشترك، قائمة على التفاعل الكائن في الاعترافات بالتباينات وتكاملها وتجاوزها[26]“.
فقد ولدت الطبيعة التنوّع والاختلاف، وهذا التنوّع هو سبب التعقيد، وسبب الحياة، فالطبيعة باختلافاتها المعقّدة تسير وفق نظام جميل متناسق، وهذا التنوّع أكسبها جمالًا ومعنى، بالتالي يمكننا نحن البشر بما أنّنا جزء من الطبيعة على الرغم من أنّنا طبيعة ثانية أكثر تعقيدًا من الطبيعة الأمّ، لكنّنا نستطيع أن نتعايش ونكسب البشرية زخمًا أكثر جمالًا من هذه الحروب العرقية الأثنية الطائفية التي تعصب بالعالم. وهذا يقتضي مصطلحًا جديدًا؛ (الأمم الحديثة متعدّدة القوميّات[27])
فلا ديمقراطية من دون حكم ذاتي، فالإدارة الإيجابية للتعدّدية الثقافيّة مشروطة بطراز السلطة المجتمعيّة والسياسيّة، ومن هنا يمكننا صياغة مفهوم الدولة الديمقراطيّة (السياسيّة والثقافيّة)، وهذا يعني عدم اللجوء إلى المركزيّة، وإدارة الأقلّيّات نفسها بنفسها، وعدم استخدام الأقليات كأدوات، فهذا “يساهم في نزع الصفة السياسية عن المسألة الهويوية، وهذا ما يقتضي اعترافًا مزدوجًا بإمكانية تقسيم سلطة الدولة وإقامة الحكم الذاتي داخلها (حكمًا ذاتيًّا إقليميًّا أو محلّيًّا أو بلديًّا) وتعدّديّة الأمّة، وتنوّعًا في مقاربة حقوق الإنسان على المستوى الكوني[28].” فيكمن الحل في الاعتراف بإمكانية توزيع سلطة الدولة، والتمايز المحلّي، والحكم الذاتي في إطارها، فهناك صعود للقوى المبعدة والمهمّشة عن المركز (الإقليمية الداعية للحكم الذاتي، الانفصالية، السيادية، التعاونية، الإلحاقية، التقسيمية، الاندماجية..)
[1] النهوض بحقوق الأقليات وحمايتها – دليل المدافعين عنها / الأمم المتحدة – المفوضية السامية لحقوق الإنسان / جنيف ونيويورك 2012 / الصفحة 3
[2] الهويات القاتلة / أمين معلوف / ترجمة: نبيل محسن / ورد للطباعة والنشر / الطبعة الأولى / دمشق 1999 / الصفحة
[3] العرق والتاريخ / تأليف: كلود ليفي شتراوس / ترجمة: سليم حداد / المؤسسة الجامعيّة للدراسات والنشر / الصفحة 14
[4] نهاية العالم كما نعرفه – نحو علم اجتماعي للقرن الحادي والعشرين/ تأليف: ايمانويل والرشتاين / ترجمة فايز الصباغ / هيئة البحرين للثقافة والآثار / الطبعة الأولى / المنامة 2017 / الصفحة 9
[5] ما بعد الأقليات – بديل عن تكاثر الدول / تأليف: جوزيف ياكوب / ترجمة: حسين عمر / المركز الثقافي العربي / الطبعة الأولى 2004 / الصفحة 55
[6] الهويات القاتلة / أمين معلوف / ترجمة: نبيل محسن / ورد للطباعة والنشر / الطبعة الأولى / دمشق 1999 / الصفحة 29
[7] الثيوقراطية (بالإنجليزية: Theocracy) وتعني حكم الكهنة أو الحكومة الدينية أو الحكم الديني . تتكون كلمة ثيقراطية من كلمتين مدمجتين في اللغة اليونانية هما ثيو وتعني الدين وقراط وتعني الحكم، وعليه فإنّ الثيوقراطية هي نظام حكم يستمد الحاكم فيه سلطته مباشرة من الإله، حيث تكون الطبقة الحاكمة من الكهنة أو رجال الدين الذين يعتبروا موجهين من قبل الإله أو يمتثلون لتعاليم سماوية، وتكون الحكومة هي الكهنوت الديني ذاته أو على الأقل يسود رأي الكهنوت.
[8] الفاشيةّ الإِسلامية – مختارات/ حامد عبد الصمد / دار ميريت / القاهرة 2019 / الصفحة 122
[9] الفاشيةّ الإِسلامية – مختارات/ حامد عبد الصمد / دار ميريت / القاهرة 2019 / الصفحة 248
[10] https://www.iicss.iq/?id=487&sid=889
[11] https://www.iicss.iq/?id=487&sid=889
[12] الهويات القاتلة / أمين معلوف / ترجمة: نبيل محسن / ورد للطباعة والنشر / الطبعة الأولى / دمشق 1999 / الصفحة 16
[13] الهويات القاتلة / أمين معلوف / ترجمة: نبيل محسن / ورد للطباعة والنشر / الطبعة الأولى / دمشق 1999 / الصفحة 37
[14] ستيفن ويليام هوكينج (بالإنجليزية: Stephen William Hawking) ولد في أكسفورد، إنجلترا (8 يناير 1942 – 14 مارس 2018)[50][51]، هو من أبرز علماء الفيزياء النظرية وعلم الكون على مستوى العالم،[52] درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء، أكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على الدكتوراه في علم الكون، له أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني.
[15] من شبكة الانترنت
[16] ما بعد الأقليات – بديل عن تكاثر الدول / تأليف: جوزيف ياكوب / ترجمة: حسين عمر / المركز الثقافي العربي / الطبعة الأولى 2004 / الصفحة 19
[17] https://www.iicss.iq/?id=487&sid=889
[18] http://www.alhayat.com/article/1336234
[19] النائب العمالي ووزير الخارجية السابق ورئيس مجلس العموم
[20] مجلّة مجموعة تشاتام هاوس في لندن
[21] http://www.alhayat.com/article/1336234
[22] https://www.hekams.com/?id=9407
[23] نحو المواطنيّة / حركة السلام الدائم – الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات / 2009
[24] باحث سنغالي مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التمييز العنصري بين 2002 و 2008.
[25] الكوسموبوليتية أو كوزموبوليتان (بالإنجليزية: Cosmopolitanism)، (كوزموس من اليونانية: الأرض والسياسة) اللاقومية، تعبر عن مصطلح استعمله كارل ماركس وفريدريك أنجلز، لوصف حالة الشركات الاحتكارية، التي ولدت من رحم المنافسة الرأسمالية، وقصد ماركس وأنجلز استعمال هذا التعبير ليكون وصفا أكثر دقة، لحالة اندماج بين شركات من عدة جنسيات، تبحث عن يد عاملة رخيصة ومواد أولية وفيرة، بحيث تفقد الشركات صبغتها القومية، ويصبح منتجها مصنعا في أكثر من بلد. ويُشير مصطلح الكوسموبوليتية أيضاً لمفاهيم أخرى كالكونية أو الانفتاحية.
[26] ما بعد الأقليات – بديل عن تكاثر الدول / تأليف: جوزيف ياكوب / ترجمة: حسين عمر / المركز الثقافي العربي / الطبعة الأولى 2004 / الصفحة271
[27] ما بعد الأقليات – بديل عن تكاثر الدول / تأليف: جوزيف ياكوب / ترجمة: حسين عمر / المركز الثقافي العربي / الطبعة الأولى 2004 / الصفحة279
[28] ما بعد الأقليات – بديل عن تكاثر الدول / تأليف: جوزيف ياكوب / ترجمة: حسين عمر / المركز الثقافي العربي / الطبعة الأولى 2004 / الصفحة278