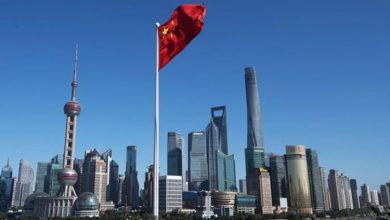سليمان محمود

الملك فيصل.. وحلم الدولة:
غداةَ الحرب العالمية الأولى كانت هذه المغامرةُ لا تبدو عبثيّةً، فقد كان العربُ خارجين تواً من العهد العثماني، الذي جُمعتْ في خلاله فعليّاً كلّ هذه البلدان تقريباً تحت عصا السلطان التركي إياه. فلماذا لا يمكنُ لها أن تجتمعَ مجدداً تحتَ سلطة ملكٍ عربيّ؟ ثمّ إنّ الأمرَ كان ينسجمُ مع أجواء ذلك الزمن، فالوحدةُ الإيطالية أُنجزت سنة1861 على يد كافور، وكذلك الوحدة الألمانية على يد بسمارك سنة1871
كان العربُ وقتها قد انجذبوا إلى شخصيّةٍ، لا تزالُ أسطوريةً في بعض الأوساط حتى الآن، ألا وهو الأمير الهاشمي فيصل. ذاك الذي كان لورنسُ العرب مستشارهُ وإلى حدٍّ ما مرشده. كان الأمير فيصل ابن شريف مكة، وكان يحلم بمملكةٍ عربية يكون هو على رأسها وتضمّ في مرحلةٍ أولى مجملَ الشرق الأدنى وشبه الجزيرة العربية. كان الإنكليزُ قد وعدوه بذلك لقاءَ انتفاض العرب على العثمانيين، كما وعدوا بالاعتراف بأبيه خليفةً على المسلمين. عند انتهاء الحرب الكبرى ذهب الأميرُ إلى فرساي مصطحباً العقيد لورانس ليطالبَ بتصديق الدول على مشروعه. وفي أثناء وجوده في باريسَ، التقى حاييم وايزمان، الشخصية الهامة في الحركة الصهيونية، والذي صار بعد مرور ثلاثين سنة أولَ رئيس لدولة إسرائيل. وقّعَ الرجلان بتاريخ1919على وثيقةٍ مدهشة تشيدُ بروابط الدم وبالعلاقات التاريخية الوثيقة بين شعبيهما، وتنصّ على أنه في حال قيام المملكة الكبيرة المستقلة التي يتمناها العربُ، فإنها ستشجّعُ إقامةَ اليهود في فلسطينَ. لكنّ هذه المملكةَ لم ترَ النورَ، فقد اعتبرتِ الدولُ أنّ شعوبَ المنطقة غيرُ قادرةٍ أن تحكمَ نفسها بنفسها، وقرّرت أن تعهدَ إلى بريطانيا ب(الانتداب) على فلسطين وشرق الأردن والعراق، وإلى فرنسا ب(الانتداب) على سوريا ولبنان. أثارَ الأمرُ غضبَ فيصل، فعمدَ إلى سلوك طريق أتاتورك، محاولاً أن يضعَ الدولَ أمام الأمر الواقع، فأعلنَ نفسه ملكاً على سوريا، وألّف في دمشقَ حكومة ساندتها معظم الحركات السياسية العربية. لكنّ فرنسا كانت لا تنوي التنازلَ عن الأراضي التي أعطيت لها، فبادرت إلى تجريد حملة عسكرية انتصرت بسهولة على قوات فيصل الهزيلة، واستولت على عاصمته عام1920، دارت المعركةُ الوحيدةُ في جوار قرية تدعى ميسلون. بعدما خسرَ الأميرُ الهاشمي مملكته السورية العابرة، حصلَ على العراق كجائزة ترضية تحت وصاية إنكليزية، لكن سمعته فقدت بريقها نهائياً. ووافته المنيةُ سنة1933أثناء وجوده في سويسرا وهو في الخمسين من العمر، وتوفي لورانس بعد سنتين في حادث دراجة نارية.
لم يحصل بعد ذلك أي اتفاقٍ بين العرب واليهود كاتّفاق سنة 1919، وأعني بذلك أي اتفاق شامل يأخذ بعين الاعتبار طموحات الشعبين الوطنية، ويحاول المصالحة بينهما. وجرى الاستيطانُ اليهودي في فلسطين رغم إرادة العرب، ولم يكف هؤلاء عن مقاومته بمقدار متساوٍ من الغيظ والاخفاق.
وحين ولدت دولةُ إسرائيل في أيار1948 رفضَ العربُ الاعترافَ بها، وحاولوا خنقها في المهد، فدخلت جيوشهم فلسطينَ، لكن لكي تُمنى بالهزيمة، الواحد تلو الآخر، واضطرتِ البلدانُ الأربعةُ المتاخمة لإسرائيل أن توقّعَ اتفاقات هدنة.
كانت هذه الهزيمةُ غير المتوقعة صدمةً سياسية كبرى للعالم العربي، وكان الرأي العام غاضباً ساخطاً على الإسرائيليين والإنكليز والفرنسيين، وإلى حدٍ ما على السوفيات والأمريكيين الذين سارعوا إلى الاعتراف بالدولة اليهودية. لكنه كان أشدّ سخطاً على قادته، بسبب كيفية خوضهم المعركةَ كما بسبب قبولهم بالهزيمة. ومنذ 14 آب 1949 أي بعد أقلّ من شهر على توقيع اتفاق الهدنة، حصلَ في سوريا انقلابٌ أطاح بالرئيس السوري وبرئيس وزرائه، اللذين أعدما دون محاكمة. وفي لبنانَ أقدمَ ناشطون قوميون على اغتيال رئيس الوزراء السابق رياض الصلح، الذي كان يترأس الحكومةَ إبان الحرب وتوقيع الهدنة، وذلك في تموز 1951
وبعد مضي خمسة أشهر، سقطَ ملك الأردن عبد الله بدوره برصاص أحد القتلة. وشهدت مصرُ أيضاً موجةً من الاعتداءات والانتفاضات الدموية، ابتدأت باغتيال رئيس الوزراء النقراشي باشا وانتهت بانقلاب تموز1952. وفي غضون أربع سنوات كان جميعُ القادة العرب الذين وافقوا على الهدنة قد خسروا الحكمَ أو الحياة.
بروز جمال عبد الناصر.. المهدي المنتظَر:
في هذه الظروفِ، استقبل مجيءُ عبد الناصر بترحيبٍ عظيمٍ بعد طول انتظار. وأثارَ خطابه القومي الحماسةَ بسرعة. كان العربُ يحلمون من زمانٍ طويل بظهور رجلٍ يقودهم بيد واثقة نحو تحقيق أحلامهم- الوحدة، الاستقلال الحقيقي، التطوّر الاقتصادي، التقدّم الاجتماعي، واستعادة الكرامة قبل كلّ شيء. أرادوا أن يكون عبد الناصر هذا الرجل، فآمنوا به وساروا وراءه وأحبّوه. ثمّ صدمهم فشله حتى الأعماق، وجعلهم يفقدون كلَّ ثقة بقادتهم كما بمستقبلهم إلى أمدٍ طويل.
كان العالمُ العربي في بداية الخمسينات خارجاً للتو من العصر الاستعماري؛ كان المغربُ لا يزال تحت السلطة الفرنسية، وإماراتُ الخليج خاضعةً للتاج البريطاني. وإذا كانت بضعةُ بلدانٍ قد نالت استقلالها، فإنه كان شكلياً صرفاً بالنسبة إلى بعضٍ منها. كانت هذه حالُ مصرَ، حيثُ كان الإنكليزُ يؤلّفون الحكومات ويسقطونها دون كثير من المراعاة للملك فاروق، هذا الذي كانت مكانته لا تكفّ عن الانحدار في عيون شعبه. كان الملكُ يثيرُ النقمةَ بأسلوب عيشه وبفساد محيطه وبتساهله المفرط مع الإنكليز، وكذلك بسبب انهزام جيشه المخزي أمام إسرائيل منذ سنة 1948
” الضباطُ الأحرارُ” الذين استولوا على الحكم في القاهرة عام 1952 كانوا يعدون بالتعويض عن كلّ تلك الإهانات دفعةً واحدة: وضع حدّ للنظام السابق، واستكمال الاستقلال عن طريق التخلّص من النفوذ الإنكليزي، واستعادة فلسطين من اليهود. كانت هذه أهدافاً متطابقة مع طموحات الجماهير المصرية كما مع طموحات كل الشعوب العربية.
لقد جرى الانقلابُ بهدوء، وحتى بشيء من الشهامة، إذ إنّ الانقلابيين واكبوا الملكَ حتى يختهِ وأدّوا له مراسم التكريم العسكرية. لم يُقتَل أيّ من كبار رجال النظام السابق، ولا سُجن مدة طويلة. لقد جرى التعرّضُ لممتلكاتهم وألقابهم وامتيازاتهم، لكن ليس لأشخاصهم. وإذا كان بعضهم آثرَ الرحيلَ، فإنّ معظمهم ظلوا في ديارهم دون أن يتعرّضوا لأية إساءة.
الجمهورية المتّحدة:
أصبحَ عبدُ الناصر معبودَ الجماهير العربية في سنة1956، لدى نشوب أزمة السويس، لأنه أقدمَ على تحدّي الدول الاستعمارية الأوروبية، وخرجَ من هذا التحدّي ظافرا. ففي تموز من تلك السنة، وخلال تجمّع في الإسكندرية للاحتفال بالذكرى الرابعة لقيام الثورة، أعلنَ بصورةٍ مفاجئة، في خطابٍ بُثّ مباشرة على كلّ الموجات، تأميمَ شركة قناة السويس الفرنسية- البريطانية، رمز الهيمنة الأجنبية على البلاد. كان سامعوه في حالة هذيان، وكان العالمُ كلّه في حالة صدمة، وراحت لندن وباريس تستنكران الأمرَ بكثير من الضجيج وتتحدّثان عن قرصنة، وعن عملٍ حربي، وتحذران من مخاطر اضطراب التجارة الدولية.
هكذا بين ليلةٍ وضحاها وجدَ العقيدُ المصري الشاب ذو الثماني والثلاثين سنة نفسَه مدفوعاً إلى مقدمة المسرح العالمي. وبدتِ الأرضُ كلها منقسمةً بيم مؤيدين له ومناوئين. كان في أحد المعسكرين شعوبُ العالم الثالث، وحركة عدم الانحياز والكتلة السوفياتية، كما تلك الشريحة المتعاظمة من الرأي العام الغربي، التي كانت تتمنى وضعَ حدٍّ لزمن الاستعمار، لأسباب مبدئية، أو للكفّ عن الانفاق. وكان في المعسكر الآخر بريطانيا العظمى وفرنسا وإسرائيل. كما كان فيه بعضُ القادة العرب المحافظين، الذين كانوا يخشون تأثيرَ عبد الناصر الضّار بالاستقرار داخلَ بلدانهم. كان من بين هؤلاء رئيسُ الوزراء العراقي نوري السعيد، الذي يقالُ إنه نصحَ نظيره البريطاني أنطوني إيدن قائلاً:” اضربوه فوراً وبقساوة”.
في الواقع كان قرارُ الضرب قد اتّخذَ، وفي آخر تشرين الأول بوشرت عملية ذات شقّين: هجومٌ بري إسرائيلي في سيناءَ، وإنزال مظليين بريطانيين وفرنسيين في منطقة القناة.
كان عبد الناصر مهزوماً على الصعيد العسكري، لكنّ مصادفات تاريخية لم يتوقّعها ساعدته. فرئيس الحكومة البريطانية ونظيره الفرنسي سحبا قواتهما من مصر، فكانت هزيمتهما السياسية كاملة بالرغم من نجاحهما العسكري. وبما أنّ الدولتين تصرّفتا كما لو أنهما لا تزالان تملكان أمبراطوريتين عالميتين واسعتين، فإنهما قد تلقّتا صفعةً مدمّرة. لقد دقّت أزمةُ السويس ناقوسَ وفاة العصر الاستعماري، وبات العالمُ يعيش في عصرٍ آخرَ، مع دول أخرى، وأصول لعبة أخرى.
وبما أنّ عبدَ الناصر كان الكاشفَ لهذا التحوّل، ولأنه خرج منتصراً من تلك المبارزة، فقد تحوّل بين ليلة وضحاها إلى وجهٍ كبير على المسرح العالمي، وبالنسبة إلى العرب أحد أبطال تاريخهم الكبار.
في شباط 1958 أي بعد مرور خمسة عشر شهراً على معركة السويس، دخل عبدُ الناصر إلى دمشقَ دخولَ الظافرين، فقد كانت شعبيته في سوريا قويةً إلى حدٍ جعل قادتها يقدّمون له الحُكم. وأعلن قيامَ” جمهورية عربية متحدة” تتألف من قسم جنوبي هو مصر وآخر شمالي هو سوريا. ولاحَ أنّ حلمَ الوحدة العربية القديم يسير في طريق التحوّل إلى واقع. كان هناكَ أكثر من ذلك، إذ إنّ الجمهورية الناصرية الجديدة تتطابق تماماً مع المملكة التي بناها صلاحُ الدين لثمانية قرون خلت: كان هذا قد وصل إلى الحكم في القاهرة سنة 1169 واستولى على دمشق سنة 1174، مطبقاً هكذا بفكّي كمّاشته على مملكة الفرنج في القدس. ومن قبيل المصادفة أنّ لفظةَ “الناصر” كانت لقبَ صلاح الدين.
في الأشهر التي تلت إعلان الجمهورية العربية المتحّدة، انفجرت في بيروت حركة تمرّد على الرئيس شمعون، الذي اُتّهمَ بأنه ساندَ الفرنسيين والبريطانيين إبانَ أزمة السويس، وطُلبَ منه أن يستقيلَ، كما ذهبَ بعضُ الناصريين حتى إلى المطالبة بانضمام لبنان إلى الدولة المصرية- السورية. وأخذت تشهدُ عدّةُ بلدان أخرى غلياناً قومياً متفاوت الحدّة.
لأجل مواجهة هذه التحديات، قرّرت مملكتا العراق والأردن أن تعلنا بدورهما قيامَ مملكة عربية متحدة. لكن هذا (الاتحادَ المضاد) لم يدم سوى بضعة أسابيع، إذ إنه حصل في 14 تموز 1958 انقلاب دموي قضى على هذا المشروع، بإطاحته النظامَ الملكي في العراق، وقتل كل أعضاء الأسرة الملكية، كما قامتِ الجماهيرُ بشنق عدوّ عبد الناصر القديم(نوري السعيد) في شوارع بغداد.
ولاحَ أنّ القوميةَ الناصرية في طريقها إلى اكتساح العالم العربي قاطبةً. كانت كلّ العروش تترنّح وتوشك أن تسقطَ، خصوصاً عرش الملك حسين، الذي كان يبدو مصيره معرضاً لمثل مصير ابن عمّه العراقي. وتشاورت واشنطن ولندن، واتّفقتا على القيام بردّ سريع. وفي اليوم التالي نزلَ مشاةُ البحرية الأمريكيون على الشاطيء اللبناني، وبعد يومين نزلت قواتٌ خاصة بريطانية في الأردن. كان هذا يعني القول لعبد الناصر إنه إذ أقدمَ على خطوةٍ إضافية فسيكون في حالة نزاعٍ عسكري مباشرٍ مع الغرب.
عام 1961 حصل انقلاب عسكري في دمشق، وأُعلن عن نهاية الاتحاد مع القاهرة واستعادة سوريا استقلالها. ندّد القوميون العرب بهذا العمل” الانفصالي” واتهموا الانقلابيين بالعمالة للاستعمار والصهيونية وممالك النفط. غير أنه لم يكن أحدٌ يجهل في تلك الحقبة أن السكانَ في سوريا كانوا يضيقون ذرعاً أكثر فأكثر بالتسلّط المصري، لا سيما وأنه كان يُمارَسٌ من خلال الأجهزة السرية.
نهايةُ عبد الناصر وتبخّر حلمه:
الضربةُ الأولى التي ضربتها إسرائيلُ محقتِ الطيرانَ المصري. هذا ما حصلَ صبيحةَ يوم الاثنين في 5 حزيران 1967. فقد حلّقت القاذفاتُ الإسرائيليةُ على علوّ منخفض جداً، وهاجمتْ في لحظة واحدة جميعَ المطارات العسكرية، فعطّلتِ المدارجَ ودمّرتِ الطائراتِ على الأرض. بقي الجيشُ الأرضي سليماً تماماً وكان في وسعه أن يقاتلَ طويلاً في سيناءَ ويتيحَ للرئيس بأن يستعيدَ روعهُ، وأن يستبدلَ الطائرات التي دُمّرت ويستعدّ لهجومٍ مضادّ. لكنّ المارشالَ عبد الحكيم عامر أصيبَ بالهلع والارتباك، فأمرَ بانسحابٍ عامّ تحوّلَ إلى هزيمةٍ نكراءَ. بعد إخراج الجيش الإسرائيلي مصرَ من ساحة القتال، توجّهَ إلى القدس والضفة الغربية اللتين استولى عليهما عقبَ حرب شوارع قصيرة، ثمّ إلى الجولان السوري الذي سقط بلا مقاومة كبيرة. توقّف القتالُ بعد أسبوع، وأطلقَ المنتصرون على تلك الحرب اسمَ( حرب الأيام الستّة)، أما بالنسبة إلى المغلوبين فكانت النكسةُ، ثمّ أمست ببساطة(حرب حزيران).
إنّ هذه التسميات البسيطة ليست كافيةً لحجب ضخامة الصدمة التي حلّت بالعرب في تلك الأيام. ولا نبالغ إذا قلنا إنّ هذه الحرب القصيرة كانت ولا تزال حتى اليوم بالنسبة إليهم الفاجعة الأساسية التي تؤثّر في رؤيتهم للعالم وفي سلوكياتهم.
غداةَ الهزيمة، وجدَ كلُّ العرب وعددٌ كبير من المسلمين عبرَ العالم أنفسهم محاصرين بسؤال كان كل واحدٍ يصوغه على طريقته ويأتي بأجوبته الخاصة، لكنّ الجوهرَ كان واحداً: كيف أمكنَ أن تحصلَ مثل هذه الهزيمة؟
قال عبد الناصر في بادىء الأمر، كي يجدَ عذراً لهزيمته، إنّ الهجومَ لم يأت من إسرائيلَ وحدها، بل جاء من الأمريكيين والبريطانيين أيضاً. كان هذا غير صحيح، لكنه كان مفيداً على المدى القصير للتخفيف من يأس المصريين والعرب بالإجمال. فالهزيمةُ أمامَ دولةٍ كبيرة كانت مدعاةً للغيظ، لكنها كانت من طبيعة الأمور، وأقلّ عاراً على كل حال من الهزيمة أمام دولة صغيرة عمرها عشرون سنة، وعدد سكانها أقلّ عشر مرات من عدد سكان مصر، وجيشها أقلّ عديداً من جيش مصر.
كانت يجبُ أن تمحو حربُ 1967 إهانةَ نكبة 1948، حين صمدت الدولة اليهودية الوليدة أمامَ جميع جيرانها المتحالفين. كان يُفترضُ بها أن تثبتَ أنّ العربَ استعادوا الثقةَ بأنفسهم واسترجعوا مجدَ الزمن الغابر، وبدلاً من ذلك فإنّ تلك الهزيمةَ المدوّية سلبتهم احترامَ ذاتهم، ووضعتهم إلى أمدٍ طويل في علاقة ارتياب عميقٍ مع العالم، الذي راحوا يرون فيه مكاناً معادياً، يسوسه أعداؤهم، وليس لهم مكانٌ فيه. وهم يحسّون بأنّ كل مقوّمات هويتهم مكروهةٌ ومُحتقرة من جانب بقية العالم. والأدهى من ذلك أنّ في نفوسهم شيئاً يقول لهم إنّ هذه الكراهية وهذا الاحتقارَ ليسا بلا مبرّرٍ تماماً. إنّ هذا الحقدَ- على العالم وعلى الذات- يفسّرُ بقدرٍ واسعٍ السلوكيات التدميرية والانتحارية التي تطبعُ بدايةَ القرن الواحد والعشرين.
بعدَ أن أعرضَ السّاداتُ عن إرث عبد الناصر العروبي، أمسى هذا الإرثُ مطمعَ آخرين كثيرين، خصوصاً بين مَن بدا أنّ الثروةَ النفطية توفّر لهم وسائلَ طموحٍ كبير. كان بين هؤلاء( معمّر القذّافي )، الذي رسمَ مشاريعَ اتحادية عديدة، قبلَ أن يسأمَ من المشاحنات العربية ويتحوّل بتصميمٍ نحو إفريقيا. و(صدّام حسين)، الذي تمكن من الارتقاء إلى قمّة الحكم في بلاده، التي كانت تحوزُ في آنٍ واحدٍ عدداً هاماً من السكان وثروات طبيعية كبيرة، وقامةً تاريخية مماثلة لقامة مصرَ؛ إذ إنها كانت مهدَ عدّة حضارات تاريخية- من سومر إلى أكاد إلى آشور وبابل- ومقرّ إحدى أشهر الإمبراطوريات الإسلامية في العصر العباسي. لقد علّلَ النفسَ هو أيضاً بأن يحلّ محلّ عبد الناصر، لكنه لم ينجح، وكانت الخاتمةُ الكارثية التي نعرفها.
لقد كان هذان المرشّحان لخلافة الزعيم العروبي قد وصلا كلاهما إلى الحكم غداةَ هزيمة حزيران. لكنّ العربَ لم يروا يوماً فيهما عبد الناصر آخر، وهما لم يحوزا يوماً تأييداً شعبياً حقيقياً، لا في بلديهما ولا في باقي المنطقة.
إنّ الهزيمتين اللتين نزلتا بصدّام حسين، قد أفضتا إلى ختم مصير الإيديولوجيا السياسية التي سيطرت على ساحة الشرق الأدنى منذ أكثر من قرن، أي القومية العربية.
هل كان عصرُ عبد الناصر ذهبياً؟
تتوزّعُ المسؤوليةُ عن إخفاق عبد الناصر بين جهاتٍ متعدّدة. فقد شُنّت عليه- دون ريب- حربٌ عنيفة من جانب الدول الغربية وإسرائيل والممالك النفطية والإخوان المسلمين والأوساط الليبرالية…. إلاّ أنه ما من أحدٍ من هؤلاء الأعداء أسهمَ في إفلاس الناصرية بمقدار إسهام عبد الناصر بالذات.
فالرجلُ ما كان ديمقراطياً، وكان قد أنشأ نظامَ الحكم الواحد، وفاز في استفتاءاتٍ بنسبة 99 بالمئة، وأنشأ شرطةً سريّة كانت حاضرة في كلّ مكان، وسجوناً كان يلتقي فيها الإسلاميون والماركسيون والمحكومون بجرائم عادية. وكانت قوميته مشوبةً كثيراً بكره الأجانب، الأمر الذي عجّل في نهاية مساكنة قديمة جداً وخصبة بين العديد من القوميات المتوسطية- إيطاليين، يونان، مالطيين، يهود، مسيحيين… وكانت إدارته للاقتصاد نموذجاً في العبئية والتقصير. وكان من بين ممارساته المألوفة أن يعيّن على رأس المؤسسات المؤممة عسكريين يرغب في مكافأتهم أو في إبعادهم بهدوء. أما الجيشُ الذي بناه عبد الناصر بتكاليف عالية مستعيناً بالسوفيات، والذي كان يبدو مرهوب الجانب، فقد انهار خلال بضع ساعات في 5 حزيران 1967 أمام الإسرائيليين، ويومها كان الرئيس المصري قد وقع في فخّ نصبه له أعداؤه ولم يحسن تحاشيه.
حين وصلَ عبد الناصر إلى الحكم في بلدٍ تسوده حياةٌ ديمقراطية ناقصة جداً، كان في وسعه أن يصلحَ النظامَ؛ بفتحه أمامَ طبقاتٍ اجتماعية أخرى، بإقامة دولة القانون حقّاً وبوضع حدّ للفساد والمحسوبية والتدخلات الخارجية. ولو أنه فعلَ هذا فمن المرجح أن كل الطبقات وكل تيارات الرأي كانت ستسير معه. لكنه آثرَ أن يلغي النظامَ بكامله ويقيم نظام الحكم الواحد، بذريعة أنه يجب جمع صفوف الأمة حول أهداف الثورة، وأنّ من شأن كل انقسام وكل اختلاف أن يفتحَ فجوةً يستفيد منها الأعداء.
لم يكن عصرُ الناصريّة طويلا، فهو لم يدم أكثر من ثماني عشرة سنة. من تموز 1952 إلى أيلول 1970، أي من تاريخ انقلابه حتى وفاته. وإحدى عشرة سنة إذا قصرناها على الفترة التي شهدت إيمان جماهير الشعوب به من تموز 1956 إلى حزيران 1967، أي منذ تأميم قناة السويس حتى حرب حزيران.
هل كان هذا عصراً ذهبياً؟ كلاّ بالتأكيد، إذا ما نظرنا في حصيلته. إذ إن الرئيس المصري لم يستطع أن يخرجَ بلاده من التخلّف، ولم يحسن إقامةَ مؤسسات سياسية عصرية، وإنّ مشاريعه الاتحادية مع دول عربية أخرى لم تعرف سوى الفشل، وتوجّت كل هذا هزيمة عسكرية مدويّة أمام إسرائيل. ومع ذلك، فإنّ الانطباعَ الذي ما برح قائماً عند العرب هو أنهم في تلك الحقبة كانوا هم صانعي تاريخهم، ولم يكونوا مجرّدَ كومبارس عاجزين، تافهين ومحتقرين، وإنهم وجدوا زعيماً يرون فيه ذواتهم، حتى وإن كان هذا الرئيسُ غيرَ ديمقراطي، وأنه وصل إلى الحكم بواسطة انقلاب عسكري، واستمرّ فيه بوساطة انتخابات مغشوشة. فقد كان يبدو شرعياً حتى خارج حدود بلاده، بينما كان القادةُ المعارضون له يبدون غير شرعيين، حتى ولو تحدّروا من الأسر الحاكمة ومن أحفاد النبي.
مع عبد الناصر أحسّ العربُ بأنهم استعادوا كرامتهم، وباتوا قادرين مجدداً على السير بين الأمم مرفوعي الرأس.
طلبَ عبد الناصر من إخوانه أن يرفعوا رأسهم، وباسمهم تحدّى الدولَ الاستعمارية وتصدى للعدوان الثلاثي، وباسمهم انتصر. كان عشراتُ الملايين من العرب لا يرون إلاّه، ولا يحلفون إلاّ باسمه. كانوا يباركونه حين يحرزُ نجاحاتٍ ويلعنون أعداءه حين يصابُ بالفشل.
كان هناك في الواقع نجاحاتٌ وإخفاقات، ومع تباعد الزمن، تتبدّى سنواتُ عبد الناصر شبيهةً بمباراة شطرنج، حيث يحتلّ اللاعبون مربعاً ثم يخلونه تحت الضغط، ويعودون إلى احتلاله مجدّداً. ويخسرون أحياناً قطعةً كبيرة فيكبّدون الخصمَ على الفور خسارة قطعة مماثلة- حتى المجابهة الأخيرة التي أسفرت عن” الملك مات” مذهلة.
خاتمة:
كانت تتداولُ غداةَ هزيمة حزيران 1967 روايةٌ، مفادها أنّ مسؤولاً مصرياً رفيعاً أغاظهُ ما حصلَ، فصاح في وجه السفير السوفياتي قائلاً:” كلّ هذا السلاح الذي بعتمونا إياه لا قيمةَ لهُ!” فأجابه الدبلوماسي قائلاً ببساطة:” لقد أعطينا السلاحَ إيّاه للفيتناميين”.
هذه الروايةُ تطرحُ المشكلةَ جيداً، أكانت صحيحة أم باطلة. إذ أنه كيف يمكن أن نفسّرَ كون شعب استطاعَ بالأسلحة إياها أن يصمدَ أمامَ أقوى جيشٍ في العالم، فيما أنّ شعباً آخرَ انهزمَ أمامَ جارٍ صغير؟ الجوابُ في نظر بعضهم واضحٌ كالشمس: يجبُ التخلّصُ من القوميّة التقليدية، أو البرجوازية الصغيرة، واعتناق الإيديولوجيا الثورية المتماسكة، إيديولوجيا الشعوب التي تنتصر.
إنّ غيابَ الشرعية، بالنسبة إلى كل مجتمع بشري، هو شكلٌ من أشكال انعدام الوزن الذي يخلخلُ كلّ السلوكيات. فمتى كانت أية سلطة، أية مؤسسة، أية شخصية، لا تستطيع أن تحوزَ صدقيةً معنوية حقيقية، ومتى بلغَ الأمرُ بالناس إلى حدّ الاعتقاد بأنّ العالمَ غابةٌ يسودها الأقوى، وكلّ الضربات فيها مباحةٌ، لا يعودُ هناك بدّ من الانجراف نحو العنف القاتل، والطغيان والفوضى.
لذا ليس يمكنُ اعتبار تفتّت الشرعية في العالم العربي موضوعَ تأمّل عادي عند الاختصاصيين؛ فإنّ إحدى العبر التي تُستخلص من 11 أيلول 2001 هي أنه ما من اختلالٍ يبقى محلياً صرفاً، وهو حين يصيب المشاعر، ورؤية الذات، والحياة اليومية لمئات ملايين الناس، تظهر مفاعيله في طول الأرض وعرضها.
المصادر والمراجع:
- محمد جمال باروت، العقد الأخير في تاريخ سوريا: جدلية الجمود والإصلاح.
- فيليب حتّي: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، بيروت- دار الثقافة.
- أمين معلوف: اختلال العالم، دار الفارابي- بيروت.