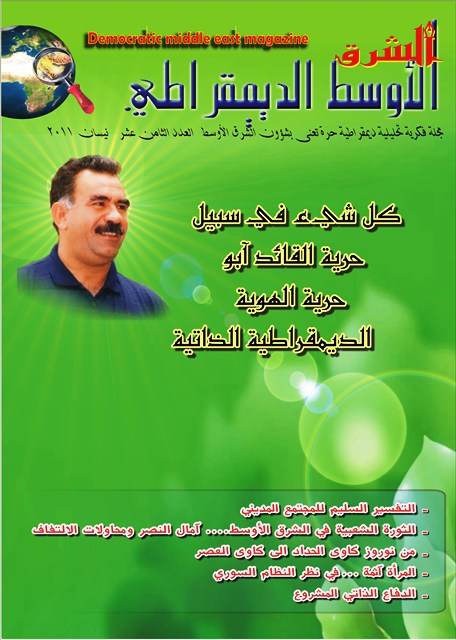شهد العالم العربي في أواخر عام (2010) موجة من الاحتجاجات التي خرجت إلى الساحات العامة مطالبة بإسقاط الأنظمة الحاكمة, ولكن اختلف الكثيرون في تسميتها, وكلّ أسماها حسب انتمائه السياسي أو منظوره الإيديولوجي, فمنهم من أطلق عليها تسمية ثورة, ومنهم انتفاضة, والبعض منهم أسماها بالحراك وآخرون بالأزمة, فيما سمّاها قسم آخر بالمؤامرة الكونية. هذه الاحتجاجات لم تظهر من العدم, فالمنطقة تعيش منذ بدايات القرن العشرين وإلى يومنا هذا, في ظل نظم مسماة (بالدولة الحديثة) متشبهةً بدول أوروبا بعد عصر التنوير, لكنها لم تستطع أن تُقلد النسخة الأصلية من الدولة الحديثة, بسبب عمق وتجذر مفهوم السلطة والتسلط في المنطقة, وبالرغم من توجه الكثير نحو بناء نماذج الجمهوريات في الشرق الأوسط, التي تمنح للشعب نوعاً من حق اختيار السلطة, إلا أن هذا الأمر لم يتجاوز حدود الشكل والخيال, ولم نصادف أي تغير حقيقي للحكومة منذ بداية القرن العشرين حتى يومنا هذا من خلال هذه العملية أو “التمثيلية” كما يجب أن تسمى, وإن تم تغيير حكومة ما, فتكون عبر انقلابات عسكرية دموية يكون فيها الخاسر الأكبر كالعادة هو “المواطن”, فينفجر هذا الانقلاب دون خطة مدروسة. ولكن في العقود الأربعة الأخيرة لم تعد هذه الانقلابات تجدي نفعاً كمحاولة للتغيير وكأن الهمّ الأكبر لزعماء أو رؤساء هذه (الجمهوريات) هو البقاء في السطلة والتشبث بالكرسي مهما كانت الطريقة, فقاموا ببعض التعديلات الدستورية التي من شأنها بقاؤهم المستمر والطويل في الحكم والسطلة, وتوريث الحكم لذويهم من بعدهم, وفي هذه الحالة لا يمكن أن نقول: إنه كان هنالك نظام جمهوري ديمقراطي بأبسط معاييره.
لذلك ولكي تضمن الأنظمة بقاءها على العرش حولت الدولة إلى نظام يعتمد بشكل كبير على النظام الاستخباراتي, فنرى أن المؤسسات الاستخباراتية في هذه (الجمهوريات) هي الأكثر فاعلية وقوة, ومهامّها هي أولاً وأخيراً هي حماية السلطة وأنظمة الحكم, فيتم التضييق على الحريات الشعبية والفردية والسياسية ويقع الاستغلال الاقتصادي, أما هذه الدولة فتصبح سجناً لأبنائها لا يطاق, وأحلامهم بالعدل والمساواة والحرية تتحول إلى كابوس.
فالاستغلال الاقتصادي الذي يقوم به من هم في السلطة تحت مسمّيات مختلفة منها (المال العام) أو(أملاك الدولة) شكلت طبقتين هما الطبقة الغنية القليلة العدد, والطبقة الفقيرة الكثيرة العدد, بينما اختفت تقريباً الطبقة الوسطى, فأنتج هذا الاستغلال عدداً كبيراً من الجياع والعاطلين عن العمل, ولكي تسيطر الحكومات على الشعوب بقبضة من حديد، تقوم على نشر الجهل والسعي لإضعاف التعليم وتوسيع الفجوة بين النخبة وبين المستويات الدنيا، بحيث يتم تغييب الشعوب عن كيفية هذا الاختلاف بين الطبقتين.
جميع هذه الأسباب, بالإضافة إلى شعور المواطن العربي بحاجته الملحة بعيش حياة كريمة حرة وديمقراطية, أدت إلى التمرد والعصيان والخروج إلى الساحات معلنة الثورة ضد هذه الأنظمة التي عاملت مواطنيها كسجناء, ومطالبة بإسقاطها.
إن أردنا أن نعتبر هذه الاحتجاجات ضد هذه السلطة المستبدة ثورة بكل ماهيتها, فلا بد لنا أولاً أن نتعرف على الثورة كمصطلح, وعلى بعض أشكال الثورة.
الثورة كمصطلح سياسي, هو الخروج عن الوضع الراهن إلى وضع أفضل من الوضع القائم, يقوم به الشعب في دولة ما. وقد عرّف الكثيرون مصطلح “الثورة” بأنها حالة انتقال التراكمات الكمية إلى التغييرات النوعية عند بلوغها المعيار اللازم. وقد قال في هذا الصدد المفكر عبد الله أوجلان: “تتكون الخاصيات الديالكتيكية في التحولات الاجتماعية على أساس القانون والشرائع, فالمتغيرات المبتدئة كتراكمات كمية خلال مدة طويلة من الزمن, تنفجر بشكل أسرع ومغاير في مرحلة نوعية أثناء الظروف الداخلية والخارجية لذلك, أو كضرورة من ضروراتها”. وللثورة تعريفات معجمية تتلخص بتعريفين ومفهومين، التعريف التقليدي القديم الذي وُضع مع انطلاق الشرارة الأولى للثورة الفرنسية وهو قيام الشعب بقيادة نخب وطلائع من مثقفيه لتغيير نظام الحكم بالقوة, وقد طوّر الماركسيون هذا المفهوم بتعريفهم للنخب والطلائع المثقفة بطبقة قيادات العمال التي أسماهم البروليتاريا, أما التعريف أو الفهم المعاصر والأكثر حداثةً فهو التغيير الذي يُحدثه الشعب من خلال أدواته كالقوات المسلحة أو من خلال شخصيات تاريخية لتحقيق طموحاته بتغيير نظام الحكم العاجز عن تلبية هذه الطموحات, ولتنفيذ برنامج من المنجزات الثورية غير الاعتيادية. والمفهوم الدارج أو الشعبي للثورة هو الانتفاض ضد الحكم الظالم. وقد تكون الثورة شعبية مثل الثورة الفرنسية عام 1789 وثورات أوروبا الشرقية عام 1989 وثورة أوكرانيا المعروفة بالثورة البرتقالية في نوفمبر 2004، أو عسكرية وهي التي تسمى انقلاباً مثل الانقلابات التي سادت أمريكا اللاتينية في حقبتَي الخمسينيات والستينات من القرن العشرين، أو حركة مقاومة ضد المستعمر مثل الثورة الجزائرية (1954-1962). أما الانقلاب العسكري فهو قيام أحد العسكريين بالوثوب للسلطة من خلال قلب نظام الحكم، بغية الاستئثار بالسلطة والحصول على مكاسب شخصية من كرسي الحكم.
أما عن أشكال الثورة فلها أشكال وأنواع كثيرة, تحددها التناقضات الأساسية الموجودة حينها, وتكمن اختلافاتها حسب أهدافها, فمثلاً هناك ثورة المرأة ضد المجتمع الذكوري والتي تهدف إلى إزالة الفوارق والتمييز بين الجنسين, ويتميز طابع هذه الثورة بالتغيير والتطور التدريجي. وكذلك الثورات الثقافية و ثورة المعلومات في مجال التكنولوجيا العلوم التطبيقية.
من خلال هذا العرض البسيط لمصطلح وأشكال الثورة, نصل إلى نتيجة مفادها أنه ليس بالضرورة أن يرتبط اسم الثورة مع العنف والتسليح والقتل, وأن ما يحدد استخدامات الثورة هو الديالكتيك (قانون التطور) المتّبع حينها, في حين أن الثورات التي اتخذت النهج الماركسي وتبنّت ديالكتيكيتها كانت على الأرجح أكثر الثورات دموية, وذلك لتبنيها الكفاح المسلح والعنف للوصول إلى السطلة, وعدّ العنف الثوري السبيل إلى ذلك, حسب قانون (نفي – النفي) في الديالكتيك الماركسي الذي كان السبب في تبنّي ثورات الكفاح المسلح والعنف في حقبة من الزمن كمحاولة لنفي القديم وإحلال الجديد. بعكس الديالكتيك الهيغيلي أو “الجدل الهيغيلي”, فمفاده لا ينفي وجود القديم, حتى وإن كان وجوده ضعيفاً في أحشاء التركيبة الجديدة, وهذه المعادلة تلغي عملية الإنكار والنفي الكامل للقديم باستخدام العنف, وبالتالي تفتح الطريق أمام ثورات مستدامة تهدف إلى التغيير الشامل في بنية النظم السياسية والاجتماعية.
مما سبق كيف لنا أن نقيم الربيّع العربي وفق مصطلح الثورة؟
الصرخة التي أطلقها محمد البوعزيزي كانت الشرارة الأولى للربيع العربي, كانت صرخة للإعلان عن التمرد والعصيان أمام النظم الديكتاتورية في الشرق الأوسط, صرخة الجياع ضد البطون المتخمة, صرخة المظلوم أمام ظلم استمر دهراً فنهب خيرات البلاد وسلبها حريتها وكمَّ أفواهها بأبشع الأساليب الممكنة وغير الممكنة, سرعان ما وصلت هذه الشرارة إلى دول الجوار “ليبيا ومصر واليمن وسوريا” وانتشرت كالنار في الهشيم.
فلم تكن إلا انطلاقة سلمية دون أي نوع من أنواع التسليح أو العنف من قبل الشعب, ولكن بطبيعة الحال فقد كان الرد من قبل أنظمة الأمن عنيفاً وقاتلاً في كثير من الحالات, وبينما لم تكن المطالب بسيطة في نظر الحكام, لم تكن كبيرة بنظر الجماهير فجملة (الشعب يريد إسقاط النظام) التي وصلت المحيط بالخليج كانت وليدة مقولة, “الضغط يولد الانفجار” وعلى ما يبدو أن الحكّام قد نسوها أو تناسوها ظناً أن الشعب قد استسلم للأمر الواقع, فخلال الحقبة الممتدة لعقود قبل الربيع العربي، كانت معظم أو جميع الدول العربية تحكمها أنظمة استبدادية لا تؤمن بالتداول السلمي للسلطة إلا في نطاق الأسر الحاكمة أو الحزب الواحد، وهي في غالبها أنظمة عسكرية.
ولا يزال مصطلح الربيع العربي متداولاً على نطاق واسع في أدبيات القوى السياسية العربية ووسائل الإعلام العربية والعالمية، على الرغم من أن تلك الثورات لم تنجز أيّاً من أهدافها تقريباً, فهي لم تحقق الديمقراطية ولم تُرسِ أسس الانتقال السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.
ولو تمت مقارنة بين مكاسب الربيع العربي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية, فسوف نجد أنها خجولة لدرجة كبيرة, ولكن بالمقابل سنجد أنها أنتجت عنفاً وصراعات داخلية وتهجيراً قسري ونزوحاً جماعياً وتدميراً للمدن والبنية التحتية وغير ذلك. وخلال موجتَي الربيع العربي، الأولى بين عامي (2010 و2013) والثانية في (2018 و2019)، شهدت معظم الدول العربية حراكاً جماهيرياً لم يؤدِّ إلى تغيير أنظمتها، مثل لبنان والعراق منذ عام 2018، والمغرب والأردن وموريتانيا وسلطنة عمان. في حين شهدت الأنظمة في تونس ومصر وليبيا واليمن تغييراً في قياداتها بدرجات متفاوتة، حيث انتقلت السلطة من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، قبل أن تسيطر جماعة “أنصار الله” (الحوثي) على العاصمة صنعاء في 2014 ويدخل البلد في حرب أهلية لا تزال مستعصية على الحل بسبب تدخّلات إقليمية ودولية.
ما لا يختلف عليه أحد حيال انطلاقة الربيع العربي, هو أنها كانت انطلاقة عفوية رافضة للواقع المذلّ المليء بالمآسي, فانفجرت دون تحضيرات مسبقة, ولم تكن تمتلك توجهات صائبة, لذلك نرى أنها كانت عشوائية بحتة وتفتقر إلى التخطيط والبرنامج, وهذه الفوضى لها أبعاد وأسباب, حيث أن الدولة لم تمنح المجتمع يوماً ما حق حرية التنظيم, وكل من حاول ذلك كان يعتبر خارجاً عن القانون. وأيضاً إحدى الاشكاليات الأساسية تكمن في عدم وجود الطليعة التي تأخذ زمام المبادرة بيدها وتوجّه هذه القوة المتدفقة نحو السبيل المؤدي للنجاح, فلم نلاحظ دوراً يذكر للمثقف الثوري الذي يعتبر من الطليعة, فالربيع العربي عرّى الواقع المرّ الذي ترزح تحت وطأته الأمة وكشف العديد من الحقائق التي أُخفيت قسرًا طوال عقود من الاستبداد، ورفعت الستار عن حقيقة النخب المثقفة التي فاجأتها شرارة اشتعال الثورات العربية التي لم يكن لهم أي مساهمة في صنعها وتوجيهها بقدر ما كشفت الهوّة التي تفصل هذهِ النخبة عن الجماهير وغربتها عن المجتمع الذي يُفترض أن يكون محل اهتمامها ومجال نشاطه، وأنّ هذه الثورات جاءت يتيمة بلا مثقفين يسهرون على التخطيط والتأطير لتحقيق التغيير المنشود منها, سواء على صعيد تغيير الأنظمة أم في الجوانب العلمية والأدبية التي تعيش انتكاسة منذ قرون أضحى فيها حاضر الشعوب العربية ومستقبلها بأيدي غيرها بعدما نفض العالم يده من كلّ ما هو عربي، وأن المثقف العربي غاب عن مشهد الثورات في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، لأنه نسي رسالته الإنسانية, وربط نفسه بالأنظمة الدكتاتورية التي رحلت وسترحل وتترك له تركة ثقيلة ووزرَ الدماء التي أراقتها تلك الأنظمة في ظل تأييده لها طوال سنوات حكمه, وأن غياب المثقف العربي وتأثيره الفاعل في مشهد الثورات يعزى أيضًا إلى أنّ العديد من الدول رمت الثقافة الواعية والمنصفة في مجاهيل وزوايا النسيان, وحاصرت هذه الثقافةَ وقمعتها واضطهدت المثقفين، وتعاملت الحكومات معهم بصورة غير منتجة للثقافة الحقيقية, وصنعت ثقافات معوقة ومشوهة غير قادرة على التغيير الحاسم، ولم تترك هامشًا صغيرًا كما في الدول المتقدمة, وبذلك حسب هذا الاتجاه فقد هزم الفعل التاريخي للثورات العربية خطاب المثقفين العرب، من دون أن يكون لخطابهم دور فيها.
وأيضاً نستطيع أن نلاحظ غياب الأحزاب السياسية، وعجزها المهول عن الانخراط في دينامياتها المختلفة، في مقابل حيوية غير مسبوقة لشبيبة متحمسة ومتطلعة نحو التغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي, التي أخفقت هذه الأحزاب على اختلاف أطيافها واختياراتها الفكرية والإيديولوجية، في بلورة مشاريع متكاملة بشأنه.
أظهرت التحولات التي واكبت الأحداث في الأعوام الخمسة المنصرمة، الإفلاسَ التنظيمي والفكري والسياسي لهذه الأحزاب، حيث عجزت عن الانخراط بإيجابيةٍ في أسئلة الواقع المستجدة، والتفاعل معها بشكل واعٍ ومنتج ومسؤول، وأظهرت تخبّطاً كبيراً عكسته خطاباتها المتخشّبة، وتكلّس بنياتها وهياكلها الناتج عن عدم تجديد نخبها وكوادرها. وإذا كان من المفروض أن تشكل أداةً فعالةً للتأطير والتنشئة والتنمية السياسية وبناء الديمقراطية وإشاعة ثقافة الاختلاف، والتعبير الحيّ عن الاستقطابات المجتمعية الحقيقية، فقد تحولت إلى مؤسساتٍ مغلقةٍ لإنتاج وتداول المنافع والامتيازات والريع السياسي، وإعاقة كل أشكال الحراك الحزبي والاجتماعي، وتكريس الشيخوخة السياسية، وتغذية الاستبداد والفساد، باستنادها إلى شرعية زعمائها وقادتها التاريخيين، عوض شرعية ديمقراطية تتيح تجديد النخب والأجيال والكفاءات، فأضحت بذلك نسخة هجينة من السلطوية العربية في أزمتها البنيوية.
في الصدد نفسه، كانت مسؤوليتها جسيمةً فيما يخص تدبير المرحلة الانتقالية بكل قضاياها وأسئلتها المعقدة. وتنبئنا مختلف تجارب الانتقال الديمقراطي أنه كلما أبانت النخب الحزبية نضجاً في هذه المرحلة، سواء على مستوى قراءة موازين القوى أو بناء خياراتها السياسية على أساس التوافق الوطني، أمكن تأمين العبور نحو برّ الأمان الذي لا يعني غير تجنّب الانزلاق إلى احترابٍ أهليٍّ يُجهِز على مشروع التحول نحو الديمقراطية. وبالرجوع إلى ما حصل في الأعوام الفائتة، يمكن القول إن غياب هذا النضج قد ساهم في تعطيل مسار الثورات العربية، وفتح المجال أمام القوى المضادة الداخلية والإقليمية، للتربّص بها وتصيّد أخطائها القاتلة، والإجهاز الممنهج على أحلام الشعوب وتطلعاتها صوب الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وفي غياب هذه الطليعة أُتيح المجال أمام الإسلاميين لتسلق الاحتجاجات وخطفها من الشعب.
خطف الربيع العربي وأسلمته
ما كاد بن علي يفرّ من تونس حتى كان الآلاف يرحّبون بعودة الزعيم الإسلامي المنفي راشد الغنوشي. وفي غضون فترة قصيرة، استُبدل حظر لمواقع الأنترنت بحظر آخر أوسع نطاقًا، وتعرضت النساء للهجوم لعدم ارتداء الحجاب، وجاب المتعصبون الشوارع بحثًا عن العصاة. وكل هذا على الرغم من دعوة الغنوشي نفسه إلى مجتمع إسلامي أكثر اعتدالًا. أما في مصر، فقد أطيح بمبارك، فحُرقت الكنائس، وهُدمت أضرحة الصوفية المعتدلين، وعيون يتطاير منها الشرر، وطالبوا بمنع بيع المشروبات الكحولية. إضافة إلى جملة من الأمور الأخرى. وكان هذا حال ليبيا واليمن أيضاً, أما في سوريا، فقد تم خطف الحراك في وضح النهار أمام أعين الشعب والنظام والمجتمع الدولي.
فما إن اتّسعت رقعة الحراك المعارض للنظام السوري في صيف عام 2011، ولحق ذلك تكوّن مناطق خارجة عن سلطة حكومة دمشق, وإثر ذلك كانت البيئة مواتية لنشوء توجّهات إسلامية مختلفة داخل التجمّعات المعارضة للنظام السوري، بشقّيها المدني السلمي أوّلًا ثم العسكري، بعد بداية العمل المسلّح المعارض في المناطق السورية. ويمكن ببساطة ملاحظة وجود رأيَيْن مختلفَيْن كليًا ضمن التجمّعات المعارِضة للنظام السوري منذ انطلاقة الحراك المناهض للنظام. الرأي الأول يرفض توصيف الحراك بأنه إسلامي، وهو صادر عن تجمّعات وأفراد معارضين ذوي توجّهات ليبرالية أو يسارية أو غير مؤدلجة بأي أيديولوجيا, أما الرأي الثاني فيؤكّد إسلامية الحراك متمسكًا بانطلاقه من المساجد، وبترديد المتظاهرين شعارات ذات مرجعيةٍ إسلامية. ويقودنا تعدُّد الآراء للقول إن الحراك لم يكن مُنَظَّمًا تحت قيادةٍ واحدة ذات مرجعية محدّدة. كما أن بداية إيجاد هياكل مدنية وعسكرية منظّمة خارج نطاق سيطرة النظام السوري، هو ما قاد بشكل طبيعي إلى وجود توجّه إسلامي واضح في بعضها, وتعود أسباب ذلك إلى أن غالبية المعارضين كانوا ينتمون لمناطق سنّية محافظة، ويتعرّضون لقصفٍ وحصارٍ من قِبَل النظام السوري. وفي ما بعد، وصل الحال بالتوجّه الإسلامي إلى أن يسيطر على المشهدين السياسي والعسكري.
بداية الأسلمة
بعد مرور حوالي ستة أشهر من اندلاع الاحتجاجات ضد النظام السوري في مختلف الشوارع السورية، تأسّس كيان سياسي معارض تحت اسم المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية (فيما يلي: المجلس الأعلى). وهو من أوائل الأجسام السياسية التي أُحدثت إثر الثورة، وكان سابقًا للمجلس الوطني السوري, وبعد فترةٍ قصيرةٍ من تأسيسه، تعاون المجلس الأعلى في نهايات عام 2011 مع فصائل مسلّحة ذات توجّه إسلامي، كانت قد بدأت بالتشكّل في مناطق من حمص وريف دمشق, فضمّ المجلس أعضاء ذوي خلفية إسلامية، ما أدى إلى دعم المجلس لفصائل متشدّدة.
وعزّزت القوى الإسلامية المسلّحة والتي ازداد حضورها وقوّتها مع دخول عام 2012، من التوجّه الإسلامي المتشدّد بشكل عام, ويعود هذا الحضور بدرجة أساسية إلى أن دعم تلك القوى جاء من دولٍ ذات توجّهات إسلامية محافظة مثل قطر والسعودية وخاصة تركيا ، حيث كان كل منها يدعم فصائل عسكرية, كما كانت هناك أحزاب وأفراد موجودة في تلك الدول تدعم بعض القوى الإسلامية في سوريا, وتدرّجت الفصائل في مستوى تشدّدها بين إسلامي محافظ وجهادي متشدّد. وساعد على ذلك أيضاً إطلاق النظام السوري سراح شخصيات إسلامية متشددة كانت تقبع في سجونه، حيث أصبحت تلك الشخصيات في ما بعد قيادات عسكرية متشدّدة في مناطقها.
معارضة سياسية لا تمثّل الحراك
شهد العمل السياسي المعارض في سوريا بعد بداية الثورة جسمَيْن معارضَيْن أساسيَّيْن، بُنِيَ ثانيهما على أنقاض الأوّل, ومن الانتقادات التي وُجِّهَت للجسمَيْن في ما بعد أنهما تكوّنا خارج سوريا وبعيدًا عن مركز الصراع الأساسي.
الجسم الأوّل كان المجلس الوطني السوري الذي تأسّس في أكتوبر عام 2011. والجسم الثاني كان (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية) فيما يلي (الائتلاف الوطني) الذي تأسّس في نوفمبر عام 2012، ويستمر حتى اليوم. ولاقى الكيانان انتقادات شديدة من مختلف القوى المعارضة في الداخل السوري، فضلًا عن اتّهامات باتّباع أجندات خارجية، والسعي وراء المكاسب الشخصية, وكان ذلك في ظلّ تزايد أزمات الداخل، من قصفٍ يستهدف المدن الخارجة عن سيطرة النظام، إلى تزايد أعداد النازحين واللاجئين، وتعرضّهم لظروفٍ إنسانيةٍ قاسيةٍ لم تستطع القوى السياسية التصدي لها.
ومن أهمّ مهام الائتلاف الوطني المعارض هو إشرافه على عمل الفصائل العسكرية المندرجة ضمن الجيش السوري الحر, وبدأت الفصائل بالتزايد مع ازدياد أعداد المنشقّين عن الجيش السوري، وتشكُّل مجموعات مسلّحة محليّة تضم شباناً من أبناء المناطق التي تتعرّض للقصف والحصار، وأبناء المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام. وفي مارس عام 2012، أنشِئ مكتب عسكري ضمن الائتلاف المعارض لدعم الجيش الحرّ وتنظيم عمله, وبدأت مهمّة تمويل وتسليح الجيش الحرّ تبدو أحد أهم مهام التجمّع المعارض. وكانت مشكلة تأمين الدعم العسكري واحدة من أكبر المشاكل التي واجهها، متضمّنةً إقناع الداعمين بقدرة المجلس على السيطرة على الفصائل العسكرية، وتوجيه السلاح إلى مكانه الصحيح، الذي يرضي الداعم.
ولم يستطع الائتلاف السيطرة على جميع الفصائل المُشكَّلة، خاصةً في الشمال السوري، حيث كانت تنشأ بشكل مستمر فصائل أغلبها ذات طابع إسلامي, وتبنّت هذه الفصائل أدبيّات ذات مرجعية إسلامية، من أسماء الفصائل، إلى شعاراتها، وأسماء المعارك التي تخوضها، وأسماء القياديين ومظهرهم. كما قامت بتصنيف الأعداء بناءً على مرجعيةٍ شرعيةٍ، بين مرتدّين وزناديق وكفّار. والأهم من ذلك كله، كانت نظم الإدارة التي صنعتها هذه الفصائل في ما بعد تعتمد الشريعة الإسلامية المحافظة.
ومارست الفصائل أعمالها العسكرية من دون إشرافٍ أو تنسيقٍ مع الائتلاف، ومن دون تنسيق في أغلب الأحيان مع قيادات المكاتب العسكرية التابعة للجيش الحر. وحتى داخل الجيش الحر بدأت انقسامات بين الفصائل، حيث وُجِّهت اتهامات للائتلاف بأنه يقوم بإمداد بعض الفصائل أكثر من غيرها، خاصةً تلك الإسلامية المقرَّبة من دولة قطر. وبذلك بدأ مشهد الانقسامات بين الفصائل يظهر للعيان، وتسارعت قوّتها الإسلامية، وبدأت تظهر بأنها الأقدر على المواجهة العسكرية ضد الجيش السوري.
وفي تلك الأثناء، كانت هناك قوّة جهادية إسلاميّة يتزايد حضورها في مناطق من سوريا وهي” جبهة النصرة” التي سيصبح اسمها في ما بعد “جبهة فتح الشام”، ثم “هيئة تحرير الشام”. والجبهة هي قوّة جهادية تأسّست في شهر يناير عام 2012، ثم بدأت بالتنامي. وكان حضور هذا الفصيل يتزايد في الإعلام وعلى ألسنة الناس بالتزامن مع عملياتٍ انتحارية كان ينفّذها ويستهدف فيها مقارَّ تابعة للنظام السوري في حلب ودمشق ودير الزور وغيرها من المناطق السورية.
وفي الجانب المدني أيضًا، بدأ يتوضّح حضور القوى الإسلامية في المناطق الخارجة عن سيطرة النّظام، والتي كان من المطلوب تنظيم العمل المدني فيها سريعًا, وكان ذلك يجري في ظل الفراغ السياسي والأمني والقانوني الذي بدأت تعيشه بعد خروج النظام منها. وهذا ما أدى في أحيان كثيرة إلى تسليم زمام الأمور لفئاتٍ وأشخاصٍ غير مؤهّلين من أبناء المناطق.
وعلى الصعيد القانوني، بدأ ظهور محاكم إسلامية تتّبع الشريعة في بعض المناطق، يرأسها أحياناً شيوخ محليّون، وتستعين بالفصائل الإسلامية المتواجدة في تلك المناطق لتطبيق قراراتها. وبدأت تلك المحاكم بالاصطدام مع التشكيلات المدنية التابعة للائتلاف, وبذلك بدت صورة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام بشكل عام، ضبابية مضطربة، توحي باصطدامات قادمة, وظهر أن رايات جديدة سوف تُرفَع، لكل منها انتماء، وتعبّر جميعها عن مستقبل لم يكن ينتظره أبناء تلك المناطق.
2013 عام الفصائل الإسلامية
منذ أواخر عام 2012، بدأت سلطة الفصائل ذات التوجّه الإسلامي بالتزايد, وبدأت تظهر على وسائل الإعلام اجتماعات بين قاداتها, وغالبًا ما تعرّضت الفصائل لانتقاداتٍ من قِبَل جهات متعدّدة ترفض إظهار الثوّار ضدّ النظام السوري على أنهم فصائل متشدّدة, ومن بينها الائتلاف الوطني المعارض الذي انتقدته الفصائل الإسلامية المشكّلة ولم تعترف به, وكانت تلك الفصائل ترفض قيادة الائتلاف وتمثيله للشعب السوري, وجاء ذلك على لسان أكبر قيادات الفصائل علنًا. وفي الوقت ذاته، بدأت تظهر للعيان الخلافات بين الفصائل المعارضة، على شكل اشتباكات متقطّعة أصبحت في ما بعد معارك حامية الوطيس. وتعدّدت أسباب الخلافات بين عدم الاتفاق على مناطق السيطرة، واختلاف الجهات الداعمة لكل فصيل عن الآخر، بالإضافة إلى محاولة كسب فصيل لمزيد من الدعم من خلال القضاء على الآخر. وببساطة، يمكن القول إن الحرب ضدّ التنظيمات الأشد تطرّفًا ستأتي بدعمٍ عسكري للفصيل الذي سيحارب تلك التنظيمات.
وكانت تلك الاشتباكات بين فصائل الجيش السوري الحرّ وجبهة النصرة، التي كانت قد أعلنت في أبريل عام 2013 مبايعتها لتنظيم القاعدة الجهادي, كما كانت هناك معارك بين كتائب إسلامية محافظة وبين النصرة، التي بدأت تظهر كأقوى فصيل، خاصةً في الشمال السوري. وأثارت قوّة الجبهة مخاوف مختلف القوى، سواء الجيش الحرّ أو الفصائل الإسلامية الأخرى، حيث بدأ يظهر للعيان أن اشتباكات جانبية تحوّلت لتصبح معارك أساسية في مناطق عدّة من سوريا, وكانت فوّهات البنادق حينها غير متّجهة للنظام السوري كما هو مفترض.
وفي 22 نوفمبر عام 2013، توحّدت كبرى الفصائل الإسلامية المعارضة تحت اسم “الجبهة الإسلامية”، وذلك من خلال بيان نُشر على وسائل الإعلام, وكان من اللّافت أن الجبهة أعطت نفسها توصيفًا سياسيًا، إلى جانب التوصيف العسكري, ويشير هذا إلى أن دورها لا يقتصر على القتال فحسب، بل ستكون متواجدةً في حكم المناطق التي تنتشر فيها فصائلها، والتي تكاد تغطي مجمل مناطق سيطرة المعارضة في الجغرافيا السورية, ولم تعلن تلك الجبهة موقفًا واضحًا من الائتلاف الوطني حينها، ما فُسِّر بأن بعض فصائل الجبهة ما زالت مرتبطة بقيادة أركان الجيش الحرّ التي يديرها الائتلاف، والتي تلقى دعمًا أمريكيًا وسعوديًا.
لم تخضع المناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام لحكمٍ موحّد، بل كان لكل فصيل سلطة شبه مطلقة على منطقة تواجده, فجيش الإسلام أحكم السيطرة في غوطة دمشق الشرقية بريف العاصمة, وحركة أحرار الشام ولواء التوحيد وجبهة النصرة أحكموا سيطرتهم في مناطق من حلب وإدلب وحمص وحماة, وكذا بقية الفصائل كانت لها سلطتها على مناطق تواجدها. وكانت تلك السلطة مباشرة حينًا وغير مباشرة أحياناً أخرى، تقوم على ارتباطات لمجالس الحكم المحلية بقادة القوى العسكرية المسيطرة, وفي هذا السياق، اختلفت طُرُق الحكم نسبيًا بين حكم إسلامي محافظ، وآخر متشدّد، وغيره أكثر تشددًا.
حرب الفصائل
مع اشتداد قوّة الفصائل الإسلامية وتعدّدها، واختلاف المصادر التي تعتمد عليها في اقتصادها وتسليحها، ووجود خطوط تماس وتداخل بين مناطق سيطرتها، كانت لأخبار المعارك بينها عناوين شبه يومية في الوسائل الإعلامية, وبرز ذلك واضحًا خلال عامَي 2013 و 2014، حين لم يكن قد حُسِمَ بعد أمر القوى الأكثر قدرة على الاستمرار، والأقوى عسكريًا.
وفي الشمال السوري، سنجد فصائل مثل جبهة ثوار سوريا, وهو فصيلٌ معارض يوصف بالاعتدال وعلى خلاف مع جبهة النصرة, وقد تطوّرت المعارك بين الفصيلَيْن لتحسم النصرة الأمر وتسيطر على مناطق جبهة ثوار سوريا بشكل كلّي. وسنجد معارك شنّها تنظيم الدولة الإسلامية, وكان هذا الأخير قد انتشر بقوّة في المنطقة الشرقية، ومناطق أخرى من سوريا في عام 2013، ضدّ مجموعة من القوى الأخرى مثل جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية المنتمية للجبهة الإسلامية, وخسرت تلك القوى مناطق سيطرتها تباعًا، خاصةً شرق البلاد، لصالح التنظيم الأكثر تشدّدًا في الخارطة السورية.
وفي ظلّ المعارك، وتقدُّم القوى المتشدّدة في مناطق سيطرة القوى الأقل تشدّدًا، واضمحلال فصائل الجيش الحرّ الموصوفة بالاعتدال، كانت مناطق سيطرة المعارضة تخضع لسلطة قوى إسلامية, وأدى هذا بشكل تصاعدي إلى هجرةِ من استطاع إلى خارج سوريا، أو النزوح داخلها إلى المخيّمات الحدودية. واتّجهت التحليلات السياسية والعسكرية للقول إن النظام السوري كان مستفيدًا من خلافات ومعارك الفصائل، التي وبلا شك خفّفت من وطأة الهجمات ضده في ظلّ معاركها ضد بعضها. بينما كان النظام السوري ينظر إلى المعارك القائمة بين قوى المعارضة بأنواعها في الشمال السوري وتنامي قوّة تنظيم “الدولة الإسلامية” في الشرق، على أنها تصب في مصلحته.
وكلّ ذلك كان سيلفت نظر الغرب إلى أولوية الحدّ من نفوذ المتشدّدين, وقد يظهر النظام أيضاً كقوّة تحاول محاربة التطرّف, وكان إعلام النظام يتحدّث منذ الأسابيع الأولى لشن الحرب في المناطق الثائرة ضد النظام، عن أنه يحارب التطرّف, كل ذلك سيمنع بالتأكيد الدعم العسكري الغربي عن تلك الفصائل.
الاحتلال العثماني يعود
حينما يذكر الدور التركي في الحراك السوري, يتبادر إلى الأذهان سلبية هذا الدور الذي لعبته بدعمها للمسلحين المتطرفين على كافة المستويات, فَتحْتَ ذريعة محاربة تنظيم داعش وتحجيم أي دور للكرد, اتسعت رقعة النفوذ التركي في شمال سوريا على نحو غير مسبوق, منذ أن أطلقت أنقرة ما يسمى بعملية (درع الفرات) في آب 2016, ودخلت دباباتها التي تحترف قتل المدنيين لأول مرة إلى الأراضي السورية, مستندة على وثائق عثمانية عفا عليها الزمن لتبرير سيطرتها على جرابلس, الباب وأعزاز, كما تذرّعت بوجود مقابر تعود لقادة عثمانيين لبسط نفوذها في الشمال السوري.
وبالنظر إلى وقائع الأرض والسياسات التركية فإننا ندرك جيداً بأن أهداف تركيا ليست مساندة الفصائل المعارضة كما تدعي, ومحاربة طفلها المدلل داعش, وليس أيضاً إيواء اللاجئين وحمايتهم, بل وبحسب المعطيات وكما هو واضح هي محاولة إفشال مشروع الإدارة الذاتية, وجمع جميع المرتزقة في منطقة واحدة لاستغلالهم والزجّ بهم في معارك مميتة كما في عفرين وأذربيجان وليبيا, وعلى غرار شمال قبرص تحاول السيطرة على منطقة نفوذ دائمة وتتريكها. وبغية القيام بتغيير ديموغرافي في الشمال الشرق السوري ذي الأغلبية الكردية, فوصلت مساحة المناطق التي تحتلها تركيا في سوريا إلى (8835 كم²) وتضمّ أكثر من (1000) بلدة. بالإضافة الى آلاف الشهداء والسجناء والترحيل القسري والمجازر التي كان آخرها مجزرة جنديرس.
بعد مضي 13 عاما على تفجّر الربيع العربي، لا بد لنا أن نقول إن الربيع قد رحل وحلّ الشتاء, لهذه المقولة ما يبررها قطعاً من الأحداث التي وقعت على مدى هذه السنوات الدموية، فالشعوب العربية ازدادت فقراً، فهي تعاني من الفقر الغذائي والمائي وتدهور مجالات الصحة والتعليم، أكثر من أي وقت مضى. لقد ازداد القمع وكبت الحريات، وكممت الأفواه وتعمقت الطبقية في هذه المجتمعات، لقد أعلنت الأنظمة الديكتاتورية والشمولية والعسكرية انتصارها على شعوب ثورات الربيع، وتعززت في أكثر هذه البلدان حتمية وجود الحكم العسكري، كما انخفض سقف طموحات هذه الشعوب من إزالة الأنظمة القمعية، إلى أمور أكثر أهمية بالنسبة لها، تتلخص في تخليص ما تبقى من بلدانهم من شبح الحروب الأهلية، التي أتت على الأخضر واليابس، وخلّفت أعداداً ضخمة من القتلى والجرحى والثكالى واليتامى والمشردين، أو الخروج من مقبرة الفقر المدقع الذي جعلهم في صراع يومي مرير من أجل القوت. لقد أصبحت أمنية أعداد ليست بالهيّنة من شعوب ثورات الربيع، أن تعود بهم الأيام إلى ما قبل ثورات الربيع، باعتبارها حقبة من الجحيم أهون بكثير من الجحيم الراهن، ونتائج المقارنات بين ما قبل وما بعد الثورة غالباً ما تكون لصالح ما سبق.
إنّ القول بأنّ الشتاء العربي قد حلّ، له ما يبرره؛ فالأحوال الراهنة توحي بأن الشعوب منهكة، نائية عن أية تطلعات ثورية يمكن أن تجرّها إلى مصير أكثر بؤساً مما هي عليه اليوم، ترى أن الأنظمة استوعبت الدرس جيداً، وأنها باتت أكثر حذراً واستعداداً للتعامل مع أي بادرة تمرّد أكثر من أي وقت مضى. وعلى الرغم من ذلك، قد حُفرت ثورات الربيع في ذاكرة الشعوب، وسوف تظل فكرة التحرر من الاستبداد راسخة في أذهان الجماهير، على طريقة «ما حدث من قبل، يقبل التكرار»، لكن ربما مخاوف تلك الشعوب تجعل الثورة فكرة يتم إرجاؤها إلى حين اكتمال مقوماتها وأدواتها، ولكن على سبيل التمني لا التخطيط. لقد تشكلت من جديد فكرة ضرورة بناء الإنسان قبل بناء الدولة، والتركيز على الثورة على الاستبداد الداخلي قبل الثورة على الاستبداد العام، ورغم أن هذا المنطق تعترضه عقبة تربّص المستبدين بوعي الجماهير، إلا أنه لا بديل عنه.
الثورة في القرن الحادي والعشرين تختلف عن الثورات التي سبقتها في القرون المنصرمة, فلا نستطيع تشبيه الربيع العربي بالثورة الفرنسية, وبالتأكيد لا تشبه الثورة الإنجليزية أو الأمريكية, فمجموعة التناقضات تختلف في القرن المعاش والقرن السابق وما قبله, وهذه التناقضات لا يمكن أن تجد لها حلولاً عن طريق ثورات غير مكتملة على كافة الأصعدة, ولكي تكون مكتملة وعميقة الأثر لا بد أن تكون هذه الثورات طويلة الأمد بطابعها, متسلحة بالطليعة المثقفة المتعلمة التي تُعنى بمشاكل الشعب وتخلق الحلول المناسبة دون التفكير بالمصلحة الشخصية والنأي بالنفس, وأيضاً بمجموعة من الأحزاب التي تضع مصلحة البلاد فوق مصالحها الشخصية.
___________
المراجع
- مانفيستو الحضارة الديمقراطية – عبدالله أوجلان – الثورة
- مركز الفرات للدراسات
- مركز مالكوم كير – كارنيجي للأبحاث
- المركز العربي للبحوث والدراسات
- تاريخ الثورة الفرنسية
- مجلة القدس العربي