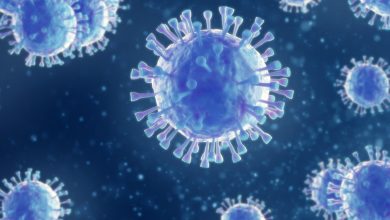العقلية المؤسساتية ما بين الكفاءة والولاء

بير رستم ( أحمد مصطفى)
سنحاول من خلال هذا البحث من خلال تناولنا هذا الموضوع الشائك، أن نقدم قراءة لواقع مجتمعاتنا ومنظوماتها ومؤسساتها ودورها في تنمية وتطوّر مختلف مسارات الحياة العامّة بجوانبها الاجتماعية الثقافية وكذلك العمل السياسي وهيمنة الأيديولوجيا والولاءات الحزبية ودورها في تلك المؤسسات، بدل الفكر العقلاني المدني الذي يجعل من تلك المؤسسات الركن الأساسي لأيّ تطوّر اجتماعي اقتصادي .. لكن وقبل الخوض في هذه القضايا الإشكالية دعونا نتعرف أولاً على بعض المفاهيم الأساسية مثل؛ مفاهيم المؤسسة والفكر المؤسساتي ومراحل تطورها إلى أن باتت علماً مستقلاً وركناً أساسياً في تنمية أي مجتمع أو دولة ما وبمختلف جوانب وفعّاليات تشكيلاتها المؤسساتية.
أولاً– تعريف الفكر المؤسساتي وتطوره
ربما لزاماً علينا أن نعرّف المؤسسة، وذلك قبل الخوض في الجانب الفكري والفلسفي للمعاني والدلالات التي رافقت المصطلح بدءً من التشكيلة الاجتماعية الأولى للمؤسسة والتي تعود إلى فترات سحيقة في التاريخ مع تأسيس ما يمكن تسميته بالمؤسسة الاجتماعية الأولى -ونقصد تشكيل مؤسسة الزواج والعائلة- حيث يمكن اعتبارها الخلية الجنينية الأولى للعمل المؤسساتي والذي سوف يتطور لاحقاً ليشمل كافة جوانب حيواتنا الاجتماعية والاقتصادية ولاحقاً السياسية بحيث تصبح الدولة بمختلف نظمها السياسية أعلى مؤسسة للمجتمعات والأمم، وبالتالي فإنّ تعريف المؤسسة سوف يضعنا على الطريق الصحيح للدخول في صلب الموضوع الذي نود تناوله في هذا البحث .. وهكذا وبخصوص المصطلح –أي مصطلح المؤسسة– يقول الكاتب أحمد عزت محمد في مقالة له بعنوان؛ “تعريف المؤسسة“، ما يلي: (المؤسسة (بالإنجليزيّة: Institution) مُنظّمة تمّ تأسيسها من أجل تحقيق نوع ما من الأعمال، مثل تقديم الخدمات وفقاً لمعايير تنظيميّة خاصّة في مجال عملها،[١] وتُعرَف المؤسسة أيضاً بأنّها تسعى إلى تحقيق هدف ما، سواءً أكان تعليميّاً أو وظيفيّاً أو اجتماعيّاً.[٢] من التعريفات الأخرى للمؤسسة هي إنشاء وتأسيس مكانٍ خاصّ أو عام من أجل تطبيق برنامج مُعيّن أو فكرة ما، ومن الأمثلة على ذلك مُؤسّسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصّة)(1).
وهكذا ومن خلال التعريف السابق نستنتج؛ بأن دائماً هناك ما نسعى إلى تحقيقه من خلال العمل المؤسساتي حيث وعندما تم تأسيس المؤسسة الأولى -أو الخلية الجنينية المؤسساتية- وذلك مع تشكيل مؤسسة الزواج، كان الهدف منها هو تجميع عدد من الأفراد في الخلية الاجتماعية بهدف الاستثمار فيهم من خلال الحصول على عملهم وتحقيق بعض الفائدة أو الحصول على “القيمة الفائضة”، كما يقولها ماركس. وهكذا فقد كان هناك هدفاً اقتصادياً، ناهيكم عن الجانب الاجتماعي والذي شكّلَ نوعاً من أنواع التنظيم والتراتبية الاجتماعية، بحيث بات مع تطور العائلة وتشكيلاتها ونموها تتشكل الطبقات وتزداد الفروقات بين تلك الخلايا الاجتماعية والتي سوف تفرز مستقبلاً النواة الأولى لمجتمع طبقي استغلالي والذي سوف يقسم المجتمع بين طبقتين؛ طبقة الأسياد والنبلاء والبعض الآخر سيصبحون عبيداً وأرقاء، ولتكون من نتائجها أن تشهد المجتمعات البشرية صراعات طبقيّة ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا، حيث تلك المسيرة الطويلة والكثير من الحروب والمآسي والدمار، وكذلك لتشهد تلك المجتمعات الكثير من الحضارات والممالك والدول التي سادت، ومن ثَمّ اندثرت بحكم امتلاك أسباب القوة من خلال الإدارة الرشيدة؛ أي بمعنى امتلاك المؤسسات القادرة على فرز بذور التقدم الحضاري المعرفي، إذاً كانت تلك المجتمعات تشهد تطوراً في جوانبها المختلفة لتبقى على رأس الهرم الحضاري، ولا تسقط عنها، وإلا ستكون هناك حضارات جديدة تولد لتحل ما كان قديماً وربما يمكننا القول هنا: إنّ تطور الدور والفكر المؤسساتي وما كانت تنتجها من إبداع في واقعها، كان لها الأثر الأول في انهيار القديم وبناء الجديد دائماً، وكمثال عن ذلك نورد فكرة إبداع العجلة والعربات ودورها في التفوق العسكري الكاشي على البابليين حيث يقول الكاتب دوست ميرخان في مقالة له بعنوان؛ “الكاشيون .. صانعو العربات ومربّو الأحصنة” ما يلي: (صنعوا العربات التي تجرها الأحصنة منذ الألف الثاني قبل الميلاد, واستخدموها في حملاتهم العسكرية إلى جانب فرق الفرسان (الخيالة) العسكرية، وحسب المصادر التاريخية برز قوتهم في ذلك. ففي عهد الملك الكاشي “سام سويلوم” شكل الكاشيون قوة عسكرية ضخمة تكونت بنيتها الأساسية من وحدات قتالية وعربات عسكرية تجرُّها الخيول، حيث لم تكن هنالك عربات عسكرية عند الممالك الأخرى في ميزوبوتاميا، وحتى في مصر الفرعونية)(2).
وبالتالي وتأسيساً وتطويراً للمؤسسة كان لا بدّ أن تنبثق مجموعة من الرؤى والأفكار والنظريات التي تنظّم عمل هذه المؤسسات وتساعد أفرادها على تنسيق العمل والأهداف ورسم سياساتها وبرامجها وفق خطط خمسية وصولاً لرسم بعض الخطط الخمسينية من قبل بعض المؤسسات ذات الدراسات الاستراتيجية، وبالتالي تحولت الأفكار والمفاهيم مع تطور المنظومات في العمل المؤسساتي إلى ما أطلق عليه فيما يعرف بالفكر المؤسساتي، والذي بات علماً بحد ذاته يدرس من أجل تطوير وتنمية تلك المؤسسات وذلك لتحقيق أفضل مردود قيمي ممكن، إن كان مردوداً ثقافياً فكرياً أو مادياً اقتصادياً أو سياسياً تهم مصالح الدولة وأمنها الوطني ويقول الدكتور عبدالرحمن تيشوري، بهذا الخصوص، في مقالة له بعنوان؛ “الفكر المؤسساتي المطلوب تعزيز دوره في سوريا” ما يلي: (إن الفكر المؤسساتي يشير إلى مفهوم ثقافة المؤسسة من خلال المفاهيم والقيم والاتجاهات والحقوق والواجبات التي يتعامل بها العاملون في مؤسسة محددة بما يشكل منظومة معيارية يسترشد بها العاملون فتتحدد قواعد وأنماط سلوكهم الوظيفي وترسم وسائل تعاملهم في البيئة الداخلية للمؤسسة ومع المتعاملين معها من المواطنين وبهذا المعنى فإن لكل مؤسسة ثقافتها الخاصة بها ( ثقافة المنظمة) والتي تحددها نوعية المؤسسة وفي مجال عملها ( اقتصادي – اداري- سياسي- اجتماعي- تعليمي- ثقافي – ……………. ). وهذه المنظومة حيوية ومستمرة وقابلة للنقل من مجتمع إلى آخر كما قابلة للنقل للأفراد القادمين الجدد للمؤسسة وتعتبر معايير للتقويم والعمل. ولذلك فإن المؤسساتية بالمعنى الثقافي وبمعنى محدود عملية تربوية لكونها تلقن الأفراد أفعالاً نمطية مخططة ومتوافقاً عليها وتعتبر كأحد أهم الروافع للتنمية والتحديث والتقدم ناجماً عن ملاحظة الانحراف والفساد الإداري الذي ينجم عن عدم الالتزام والتقيد بالمعايير العقلانية والأهداف التنموية التي ترسمها المؤسسة لنفسها أو التي ترسمها الحكومة لنفسها)(3)
وبالتأكيد فإن تلك الأفكار والقيم المعيارية والتي باتت تعرف بالفكر المؤسساتي لم تلد دفعة واحدة حيث بدأت بمجموعة من الملاحظات الأولية بهدف تطوير وتحقيق ما هو أفضل من حيث الواردات وظروف العمل وتقسيمه بحسب الإمكانيات والتخصص –فيما بعد– وما زال كل يوم تولد المزيد من الرؤى والنظريات المعرفية الجديدة في كل حقل من حقول العمل المؤسساتي. وهكذا فقد باتت حياتنا عبارة عن شبكات مؤسساتية حيث لا يخلو عمل ومنحى من مناحي الحياة في عالمنا المعاصر ولا يصنف ضمن إحدى التقسيمات الشبكية للمؤسسات بحيث بات الأمر؛ بأنّه لا يمكن لأحدنا أن يتحرّك في أيّ مسار وإيجاد الحلول المناسبة لأي قضية دون أن يكون وفق عمل وفكر مؤسساتي ويقول د. عادل حميد يعقوب في مقالة له تحت عنوان؛ “الفكر المؤسّسي والعالم العربي” بأن؛ (لا يمكن الحديث عن حل مشكلة كبيرة في دولة ما أو نجاحات تحققت في معالجة قضية مهمة، كانت اقتصادية أو اجتماعية، سياسية كانت أو بيئية، حديثاً أو في أي فترة من فترات التاريخ، بعيداً عن المؤسسية، فالمؤسسية بطبيعتها تبتعد عن الرأي الفردي الوحيد وتعمل في إطار الرأي الجمعي، لا تتأثر بالأهواء، تطبق النظام والقانون، ودائماً ما تحاول الوصول إلى تحقيق الأهداف المخطط لها فتصل في النهاية إلى بر النجاح)(4) ويضيف (فالحضارة الغربية عبقريتها في المؤسسات والتي استطاعت أن تحافظ على هذه الحضارة، كما أنّها قدّمت وما زالت تقدّم مردوداً اقتصادياً، ونموّاً كبيراً على المستوى المحلي والعالمي، يصعب على كثير من دول العالم مجاراته وإذا كان العالم قد تحول من اقتصاد الحقول، إلى اقتصاد العقول، فإنّ العالم العربي لم يستطع حتى الآن معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، مثل قضية المؤسسية (الفكر- والتطبيق) والتي أثّرت بدورها سلباً على قضايا الإنتاج والعدالة الاجتماعية والبطالة والفقر والتعليم والصحة والفساد وغيرها وأصبحت هذه القضايا تمثل شوكة في حلق الأمة العربية)(5).
ثانياً– البناء المؤسسي ومراحله:
إننا وبعد أن وقفنا على كل من تعريف المؤسسة وعلومها ومعارفها أو ما يعرف بالفكر المؤسساتي عموماً، سنحاول ومن خلال هذه الفقرة الوقوف على الجزء العملي من قيام أي مؤسسة والبدء به كمشروع تنموي بشري حيث وفي أي مجال واختصاص يكن لا بد من أن يبدأ بأساسيات ركائزية للمشروع والتي باتت متعارفة في العمل المؤسساتي بحيث يمكن إجمالها بما يلي:
1) وضوح الفكرة التي قامت من أجلها المؤسسة.
2) مشروعية المؤسسة, والحصول على الترخيص القانوني لبدء العمل وفق شروطه.
3) وجود قيادة مؤهلة ومحترمة وقادرة ومتحمسة ومتفرغة لهذا العمل.
4) توفر رأس المال الكافي.
5) إيجاد سمعة جيدة للمؤسسة.
6) قدرة المؤسسة على اتخاذ قراراتها دون تدخل خارجي, وتحقيق أهدافها, والتغلب على الصعوبات, وإجبار الآخرين على مسايرتها.
7) جذب عدد كاف من العاملين الأكفاء المنجزين والمتحمسين والمقتنعين.
8) وجود لوائح وأنظمة عمل محددة وواضحة ومتفق عليها وموثقة ومدونة ومعروفة لكل الجهات المعنية.
9) وجود خطط وبرامج محددة وواضحة ومدروسة ومتفق عليها وموثقة ومكتوبة ومعروفة للجهات المعنية.
10) وجود نظام للرقابة والمتابعة والتقويم المستمر للتأكد من سلامة التخطيط والتنفيذ.(6)
أما وبخصوص صفات العمل المؤسساتي فتقول الكاتبة “رزان صلاح” في مقالة لها بعنوان؛ “ما هو العمل المؤسسي” ما يلي: “الانفتاح على العالم الخارجي، وامتلاك عقلية ناضجة، بالإضافة إلى الابتعاد بشكلٍ تام عن عقليات السيطرة والتملك. اليقين والتأكد من النجاح. الثقة العالية. التخطيط والتنظيم السليم. امتلاك عقلية إيجابية في التفكير، والابتعاد عن اليأس والسوداوية. امتلاك المهارات الإدارية التخصصية اللازمة“(7). وبخصوص مراحل البناء وتطوير أي مؤسسة فهي تبدأ دائماً بمرحلة التأسيس والنشوء أو الانطلاق ورسم الأهداف والاستراتيجيات واستغلال الفرص وصولاً لمحطة التشغيل والبدء بالعمل المنتج وصولاً لتقييم النتائج والموارد ويضع الكاتب “محمد أكرم العدلوني” في مؤلفه “العمل المؤسسي” والمشار إليه في الفقرة السابقة استراتيجية بناء المؤسسة والتي تحدد لديه بما يلي:
| الوصف العام | المحطة |
| هي المحطة الأولى من محطات وضع الاستراتيجية، وفيها تطرح الأسئلة المهمة التالية: من نحن؟ وأين نحن الآن؟ وأين نريد أن نكون؟ وما سبب وجودنا؟ |
محطة البدء والانطلاق |
| وفيها تقوم المؤسسة باستكشاف الفرص المتاحة لها في كل مجال من مجالات تحركها، مستندة إلى النتائج والمعلومات التي توصلت إليها من خلال إنجازات المحطة الأولى. فبعد أن يتم تقويم شامل لواقع المنظمة, تأتي هذه الخطوة لتستكشف مجالات التحرك وانتهاز الفرص المتوفرة. وفي هذه المحطة يتم: تحديد المجالات الاستراتيجية, والأهداف الاستراتيجية، وأولويات المؤسسة، والنتائج المتوقعة. |
محطة البحث عن الفرص |
| وفيها تقوم المؤسسة بفرز المعلومات وتصنيفها وتبويبها، ومن ثم إعادة صياغتها على شكل أهداف كبرى للمؤسسة على المدى البعيد متعلقة: بالبنية التنظيمية,وبالفاعلية والكفاءة، وبالموارد البشرية والتقنية, وبالمعرفة بالجمهور والمنافسين والبيئة المحيطة. |
محطة تحديد الأهداف |
| وفي هذه المرحلة يتم وضع الأهداف والأولويات على شكل خطة تنفيذية، تنقل المؤسسة من عمل الخطة إلى خطة العمل، والتأكد من توفر الشروط الأساسية مختصرة بكلمة لتدل على صياغة محددة للأهداف ومعايير القياس وتحديد الأنشطة والوسائل وتحديد مسؤوليات التنفيذ وتحديد زمن التنفيذ |
محطة التشغيل والتنفيذ |
| إن الاختبار الحقيقي لخطة المؤسسة هو ما تحققه من نتائج, وتقدر قيمة هذه النتائج بمقدار الجهد المبذول للحصول عليها، وينبغي أن تضع المؤسسة معايير محددة (أو مواصفات للأداء) ومؤشرات للنجاح,يمكن استخدامها لقياس أو وزن القيم الحقيقية للنتائج, والتي على أساسها تستطيع المنظمة أن تقيس مدى نجاحها وأنها تسير بالاتجاه المرسوم وبشكل سليم نحو رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية (8). |
محطة تقويم النتائج |
ثالثاً– ما بين الكفاءة والولاء لإنجاح العمل المؤسساتي:
سنحاول من خلال هذه الفقرة أن نحدّد أين يكمن نجاح أي مؤسسة في تنمية إمكانياتها وقدراتها لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب والربح؛ إن كان ربحاً عقارياً مادياً أو ربحاً ثقافياً وسياسياً وسنحاول إسقاطها على واقع مجتمعاتنا وبالأخص في الجانب السياسي والإداري للمنظومات السياسية الحالية في روجآفاي كردستان ودور الكفاءات البشرية أم الولاءات العقائدية هي الأهم في إنجاح تجربة الإدارة الذاتية، لكن وقبل الدخول في حيثيات تلك القضية، دعونا نأخذ برأي تخصّصي في هذا الجانب حيث تقول دراسة بعنوان؛ (مفهوم المؤسسية) منشورة على موقع؛ “رؤيا للبحوث والدراسات” ما يلي:
((أما بالنسبة للاهتمام بدراسة المؤسسات في مجال العلوم السياسية؛ فقد شهدت تطورًا بدءًا من ظهور مدرسة “المؤسسية القديمة” Old Institutionalism في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، التي ركّزت على دور الأطر الرسمية والإدارية لمؤسسات الدولة الحديثة في التأثير على السلوك السياسي، وقد شهدت هذه المدرسة تداخلًا بين العلوم القانونية والإدارية، إلّا أنّ معظم إسهاماتها تميّزت بطبيعة وصفيّة للهياكل والمؤسسات الحكومية للدولة([5]). وقد امتدت إسهامات هذه المدرسة لمجال العلاقات الدولية مع الحديث عن دور المؤسسات الدولية في حفظ الأمن والسلم الدولي، وهو ما شكل الإطار النظريّ لنشأة عصبة الأمم([6]). وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية تراجع الاهتمام بدور المؤسسات وبدء التركيز على الجوانب غير الرسمية والتوزيع غير الرسمي للقوّة في المجتمع، وذلك من خلال التركيز على سلوك الفرد دون المؤسسة، في إطار سيادة المدرسة “السلوكية” التي نظرت للمؤسسات باعتبارها بمثابة صدفة خالية empty shell يقوم الأفراد بشغلها عن طريق أدوارهم المختلفة، ومن ثَمّ فالتفسير السياسي يخضع لحسابات الأفراد ومصالحهم، أكثر من القيود التي تفرضها الواجبات والالتزامات([7]).
ومع مطلع الثمانينيات عاد الحديث مرة أخرى عن أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات كعامل تفسيري للظواهر السياسية وهو ما تمثل في ظهور “المؤسسية الجديدة” New Institutionalism، والتي ارتبط ظهورها بأكثر من دافع يتعلق بسياقات الواقع والتي تمثلت في:
- تجدد الاهتمام بدراسة الدولة في إطار المدرسة التي سميت بـstatism
- الاستجابات المختلفة التي قدمتها الدول في التعامل مع التحديات والأزمات الاقتصادية خلال الـ 70 و80، والتي لعبت المؤسسات دورًا كبيرًا فيها.
- مراجعة السياسات العامة للدول الكبرى خلال الـ80، وما تطلّبته من الحديث حول إعادة البناء المؤسسي، وأثر ذلك على دور الدولة وإصلاح القطاع العام([8]).
وقد قدمت المؤسسية الجديدة أو ما يسمى أيضًا بالنظرية المؤسسية Institutional theory عددًا من الروافد المختلفة التي تتداخل مع علم الاجتماع والاقتصاد والقانون والإدارة معًا.
ففي إطار النظرية المؤسسية توجد 4 اقترابات مختلفة هي:
- المؤسسية الاجتماعية Sociological Institutionalism ، أو ما يعرف بالاقتراب الثقافي لدراسة المؤسسات.
- Rational Choice Institutionalism ، أو نموذج الاختيار الرشيد في دراسة المؤسسات.
- المؤسسية التاريخية Historical Institutionalism.
- المؤسسية الأمبريقية Empirical Institutionalism ، والتي تطورت من التركيز على الجدال حول الفرق بين مزايا النظم الرئيسية والبرلمانية، إلى التعامل مع المؤسسات بصورة عامة كحلقة وصل بين متطلبات المجتمع وقدرة النظام السياسي على الاستمرارية والتطور، وذلك في ضوء الإسهامات التي قدمها صموئيل هانتجتون([9]).
وعلى صعيد العلاقات الدولية عاد الاهتمام مرة أخرى بدور المؤسسات، سواء من خلال إسهامات المدرسة الليبرالية الجديدة واقتراب الاقتصاد السياسي خلال فترة السبعينيات، أو في ضوء مراجعة حالة علم العلاقات الدولية مع نهاية الحرب الباردة، وإعادة الحديث حول التداخل بين الأبعاد الداخلية والخارجية للسياسة الدولية([10])))(9). وهكذا وبعد هذه الاستفاضة حول مفهوم ودور المؤسسة السياسية ومختلف نظمها الوطنية، يمكننا القول: إنّ نجاح هذه المؤسسة يعتبر المؤشر الأوّل لانتصار أمّة وشعب، لكن ولإنجاح تلك المؤسسة والتي هي أعلى سلطة وطنية متمثلة بالإدارة التي تقود البلاد، لا بد من تضافر جهود كل المؤسسات الوطنية الأخرى والتي تشكل روافد تصب في الأخير لصالح المؤسسة السياسية القائدة لكل المؤسسات من خلال ما يعرف بمؤسسة الدولة.
ولكن يبقى السؤال المحوري الذي طرح في بداية هذه الفقرة وكعنوان له؛ هل الكفاءة أو الولاء يقف خلف نجاح هذه المؤسسة الوطنية القائدة للبلاد أو لأي مشروع سياسي؟ حزباً كان أم دولة أم تكتلاً سياسيّاً معارضاً .. وبتوضيح أكثر: – هل علينا أن نضع على رأس هذه الدوائر والسلطات السياسية أشخاصاً ذوي كفاءات وخبرات وطنية؟ أم علينا أن نسلم القيادة لأولئك الأكثر ولاءً لمنهجيات وأيديولوجيات تلك المنظومات والتي هي صاحبة المشروع السياسي؟ وهنا تبرُز فكرة دور حكومة التكنوقراط، فهل هذه الحكومات ستكون ناجحة في ظل سياسات الدول العقائدية الأيديولوجية؟ أو يلزمنا لإنجاح التجربة السياسية فريق عمل يدينون بالولاء للمشروع السياسي و “أخوّة الشعوب” و “الأمّة الديمقراطية” في تجربة الإدارة الذاتية مثالاً، بما إننا أردنا إسقاط الفكرة على تجربة حية من واقعنا ..
طبعاً تشير تجارب الشعوب المجاورة ومنها التجربة العراقية مثالاً؛ بأنها ما زالت تعاني من هذه الإشكالية حيث تلجأ القوى السياسية العراقية إلى إفشال كلّ حكومة لا تدين بالولاء للمرجعية الشيعية وذلك بحكم الأحزاب الشيعية الموالية لإيران والتي هي الأكثر نفوذاً وهيمنة على القرار السياسي في بغداد، وبالتالي فقد أفشلت عدد من الحكومات التي كانت بالإمكان أن نجد فيها الكثير من الخبراء التكنوقراط ومن خيرة الأكاديميين العراقيين، بينما نجد بأن هذه الحكومات في الدول الديمقراطية تحقّق نجاحات سياسية تنموية لبلدانها وبالتالي فإن قضية الديمقراطية هي المقياس في نجاح الحكومات التكنوقراطية، فهي ناجحة في المناخات الديمقراطية، بينما الاستبداد يكون سبباً لفشل تلك الحكومات الوطنية التكنوقراطية.
طبعاً وبالإضافة إلى قضية الكفاءة والخبرة الفنية يجب أن تتوفر شروط أخرى كثيرة وبالمناسبة هي تأتي مع هذه الخبرات والكوادر التكنوقراطية أو هي جزء من وجودها على رأس المؤسسة وإننا نقصد بتلك الشروط؛ قضايا التخطيط المستقبلي ووضع خطط التنمية والإصلاح ومحاربة الفساد والفوضى .. وذلك ضمن خطط خمسية أو خمسينية بحسب القدرات التنموية البشرية للبلد، وهنا يقول د. عادل حميد يعقوب وبهذا الخصوص ما يلي: (وينسب الكثيرون في الوطن العربي سائر وجوه الفوضى، وغياب التخطيط المستقبلي والقصور في الأداء وفقدان الاستراتيجية والارتباك في اتخاذ القرارات أو اتخاذ القرارات بشكل مرتجل وغير موضوعي، وفشل خطط التنمية والإصلاح الإداري بالشكل المأمول، وتراجع كل محاولات النهضة والتقدم، كل ذلك يرده الكثيرون، إلى فقدان المؤسسة والفكر المؤسسي، وقد يضيف البعض إلى ذلك انتشار الرشوة والمحسوبية والتحيز إلى تلك الأمور التي يعتبرونها معوقات النهضة وتجاوز الأزمات). ويضيف؛ (فلا يستطيع أحد إغفال الأهمية الكبيرة للمؤسسية، فالإنسان طوال التاريخ وهو يتطور، بل إنه يمكن القول: إنّ آخر مراحل التطور التي يعيشها الإنسان الآن تؤكد أن المؤسسية عامل رئيسي فاعل فيها، حيث أنّ تطور الإنسان في المجالات السياسية يكمن دعمه ورشده ووجوده بوجود المؤسسية، وهكذا الحال في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمالي والواقع المعاصر، يشهد بالآتي حيثما وجدت المؤسسية وجد التقدم وحيثما وجد التقدم وجدت المؤسسية، وعلى ذلك فإن الأمر على هذا النحو يجعل القول الآتي صحيحاً، التقدم والمؤسسية، حلقة لا يعرف أين بدؤها ومنتهاها، هذا التلازم بين التقدم والمؤسسية يستلزم على كل مواطن حسب مستواه وحسب عمله فكرياً وتنفيذياً، أن يهتم بموضوع المؤسسية تأصيلا وتطبيقاً)(10).
وأخيراً يمكننا التأكيد على أن إنجاح أي مؤسسة ومنها المؤسسة السياسية لا يكفي الوقوف على جانب واحد، بل علينا أن نوفر عدداً من المقدمات والمستلزمات الضرورية حيث وعلى الرغم من دور ومكانة وأهمية عامل الخبرة والكفاءة في نجاح أي مؤسسة، لكنه ليس الكفيل لوحده بإنجاحها ولا بد من دعمه بقضية الإيمان بها وبدورها كإحدى المؤسسات الوطنية التي تهمه وتهم مصالح شعبه، كون مهما كان ذاك المسؤول ذا كفاءة علمية وخبرة فنية، لكن عندما لا تكون له قناعة بالمشروع السياسي فبكل تأكيد لن يقدم الأفضل لنجاح المؤسسة، بل ربما وبتخطيط -وبما إنه يملك المعرفة- يمكن أن يضع العراقيل أمام المشروع وذلك بهدف إفشاله، بينما وبالمقابل لا يعني وضع الموالون على رأس المشروع أو المؤسسة يعني النجاح، بل ربما يكون أضرار ذاك أسوأ بكثير من أضرار الخبير والكفوء الغير موالي وبالتالي فسيكون الأفضل لو جعلنا الكفاءة والولاء يجتمعان معاً داخل المؤسسات أي ما يمكن القول بدمج التكنوقراط مع الأدلجة وذلك من خلال حكومات وطنية عقائدية وذات خبرة فنية بنفس الوقت، لكن ربما في ظرف ما يستحيل تحقيق الشرطان معاً وبالتالي أن نجبر إلى اللجوء لأحد الخيارَين المتوفرين؛ إمّا الكفاءة أو الولاء العقائدي وهنا وبحسب تجارب الآخرين، فالأفضل اللجوء للخبرة مع وجود رقابة قدر الإمكان على تلك المؤسسات وربما هذه ما دفعت بالإدارة الذاتية إلى وضع ما يعرف ب”الكادر” في كل مؤسسة من مؤسساتها، لكن وللأسف فقد تحوّل بعض هؤلاء “الكوادر” لقوى العطالة وذلك من خلال منحهم سلطة “الآمر الناهي” بحيث باتوا يشكلون فرملة حقيقية لنجاح بعض مؤسسات الإدارة الذاتية، وللأسف ولذلك لا بد من وضع أسس وضوابط وقوانين لكل من الكادر والخبير الفني الإداري ورسم الحدود الفاصلة بينهما بحيث يعرف كل منهم صلاحياته ودوره وإلا سيكون لدين مؤسسات بمديرين؛ مدير فني غير مقرر وكادر أيديولوجي مسيطر والنتيجة فشل شبه مؤكد لتلك المؤسسات، كون أن يكون لديك جسد برأسين مختلفين؛ فكرياً وفنياً، فبكل تأكيد سيكون مصيره الكثير من المطبات والوقوع فيها، أما في حال التوافق والتخطيط الاستراتيجي، فبكل تأكيد ستكون هناك الإنجازات الحقيقية على الأرض مستقبلاً وقريباً!
………………………………………………………………………….
المصادر والمراجع
- مقالة بعنوان؛ “تعريف المؤسسة” للكاتب أحمد عزت محمد منشورة في موقع موضوع بتاريخ 14 مارس 2017
- “الكاشيون .. صانعوا العربات ومربو الأحصنة” مقالة للكاتب دوست ميرخان منشورة في موقع حزب الاتحاد الديمقراطي بتاريخ 29/11/2016
- د. عبدالرحمن تيشوري مقالة بعنوان؛ “الفكر المؤسساتي المطلوب تعزيز دوره في سوريا” بتاريخ 2019 في موقع الرابطة الثقافية المعرفية.
- د. عادل حميد يعقوب مقالة بعنوان؛ “الفكر المؤسسي والعالم العربي” منشورة في موقع لوسيل.
- المصدر السابق.
- مقالة بعنوان؛ “البناء المؤسسي” منشورة على موقع د. عبدالله بن سالم باهمام حيث المقال منقول بتصرف يسير من كتاب العمل المؤسسي (محمد أكرم العدلوني، العمل المؤسسي).
- الكاتبة “رزان صلاح” في مقالة لها بعنوان؛ “ما هو العمل المؤسسي” منشورة في موقع موضوع.
- مقالة بعنوان؛ “البناء المؤسسي” منشورة على موقع د. عبدالله بن سالم باهمام حيث المقال منقول بتصرف يسير من كتاب العمل المؤسسي (محمد أكرم العدلوني، العمل المؤسسي).
- دراسة بعنوان؛ (مفهوم المؤسسية) على موقع؛ “رؤيا للبحوث والدراسات” منشورة بتاريخ 29 سبتمبر 2017
- د. عادل حميد يعقوب مقالة بعنوان؛ “الفكر المؤسسي والعالم العربي” منشورة في موقع لوسيل.