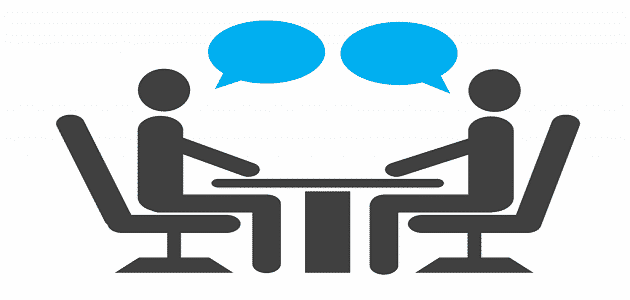
أحمد مصطفى – بير رستم

1- تاريخية الصراع ما بين الشرق الأوسط والغرب، وتداعيات هذا الصراع منذ مئة عام حتى الآن، وتحوّل نوعية هذا الصراع منذ القدم حتى بداية القرن الواحد والعشرين، وهل استطاعت ثورة روجآفا أن تغيّر من هذه الآلية في التعامل الغربيّ مع الشرق، والتعامل الشرقي مع الغرب؟ وما هي خطط السلام والديمقراطيّة في الشرق الأوسط؟
بكل تأكيد تاريخ الصراع بين الشرق والغرب لا يتوقف عند الاحتلال الغربي الأخير مع بداية القرن العشرين وانهيار الخلافة العثمانية، بل يمتد بجذوره إلى عمق التاريخ حيث الصراعات الدينية بين كل من الإمبراطوريتين الدينيتين؛ الإسلامية والمسيحية وما عرف بالحروب الصليبية التي أرادت استعادة القدس وفلسطين مع المشرق العربي عموماً من السيطرة والاحتلال الإسلامي، وذلك لما لهذه الجغرافية من “قداسة دينية” وذلك بعد أن سيطر عليها المسلمين. لكن وكما يخبرنا التاريخ فقد تكسرت تلك الحملات تحت ضربات قائد عسكري محنك ونقصد الفاتح “صلاح الدين الأيوبي” والذي استطاع إعادة ما كان قد فقده المسلمون مجدداً ويلحق الهزيمة بتلك الجيوش الصليبية و”ريتشارد قلب الأسد” حيث يخبرنا التاريخ بأن “حروب الفرنجة أو الحملات الصليبية أو الحروب الصليبية بصفة عامة اسم يطلق حالياً على مجموعة من الحملات والحروب التي قام بها أوروبيون من أواخر القرن الحادي عشر حتى الثلث الأخير من القرن الثالث عشر (1096 – 1291)، كانت بشكل رئيسي حروب فرسان، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الذين اشتركوا فيها، وكانت حملات دينية وتحت شعار الصليب من أجل الدفاع عنه وذلك لتحقيق هدفهم الرئيسي وهو السيطرة على الأراض المقدسة كبيت المقدس، ولذلك كانوا يخيطون على ألبستهم على الصدر والكتف علامة الصليب من قماش أحمر “.
وتضيف تلك المصادر: “كانت الحروب الصليبية سلسلة من الصراعات العسكرية من الطابع الديني الذي خاضه الكثير من أوروبا المسيحية ضد التهديدات الخارجية والداخلية. وقد خاض في الحروب الصليبية ضد المسلمين، وثنية من السلاف، والمسيحيين الروسية والأرثوذكسية اليونانية، والمغول، والأعداء السياسيين للباباوات. كان الصليبيون يأخذون الوعود ويمنحون التساهل. هدف الحروب الصليبية في الأصل كان الاستيلاء على القدس والأراضي المقدسة التي كانت تحت سيطرة المسلمين، وكانت القاعدة التي أطلقت في الأصل استجابة لدعوة من الإمبراطوريه البيزنطيه الأرثوذكسية الشرقية لمساعدتهم ضد توسع المسلمين السلاجقة في الأناضول“. وهكذا فإن الصراع بين الشرق والغرب يعود بجذوره للصراع بين حضارتين حاولت كل منها التمدد في عمق الحضارة الأخرى وغلبتها. وفي مراحل سابقة استطاع الإسلام أن يغزو قلب أوربا والغرب، حيث وصلت الجيوش الإسلامية لكل من فرنسا وإسبانيا. وبالتالي فإن الصراع قديم بقدم التاريخ الديني لكل من الشرق والغرب، لكن ومنذ قرن وما يزيد وبعد أن تجاوز الغرب قرون الظلام والحروب والصراعات الداخلية واستطاع تحقيق الثورة الصناعية البخارية وامتلاك القوة الهجومية فقد شنت حملاته باتجاه الشرق وكان الاستعمار الغربي الحديث، حيث وجد الشرق نفسه خاضعاً للجيوش الاستعمارية لكل من الإمبراطورية البريطانية والفرنسية والجيوش الإيطالية في المغرب العربي.
وهكذا فقد انتقل الغربُ من محتلّ مستضعف إلى دولة أو دول احتلال واستعمار لمن كان يحتل أراضيه- ونقصد العرب والمسلمين عموماً- . وقد شكل الاحتلال الغربي صدمة وعي لدى الإنسان الشرقي، وهو الذي يعتز بقيم البطولة والفروسية، ولذلك لم يدم فترة على دخول القوات الأجنبية للشرق حتى وجدنا عشرات الانتفاضات والثورات في وجه القوات الغازية المستعمرة، فكانت الثورات العربية وكذلك حركة الكماليين ضد كل من الخلافة العثمانية وكذلك الاستعمار الأوربي، فكانت حصيلتها حصول تلك الأمم والشعوب على حقوقها وتشكيل كياناتها السياسية الوطنية، لكن وللأسف فإن شعبنا ونتيجة تقاطع المصالح الغربية الاستعمارية مع عدد من الدول الإقليمية الناشئة حديثاً من جهة، وكذلك لضعف العامل المجتمعي الكردي سياسياً وتنظيمياً، فقد تم التضحية به وبحقوقه ليكون “كبش فداء” لتلك المصالح. وهكذا حُرم شعبنا من أي امتيازات سياسية في معاهدة لوزان 1923 بعد أن كانت الدول الاستعمارية قد وعدت في سيفر 1920 بمنحه حقوقه، بل وتشكيل دولة كردية خلال عام واحد من تلك المعاهدة وباستفتاء في المناطق الكردية، لكن الكمالية ونجاح الثورة البلشفية في روسيا قضت على الحلم الكردي حينذاك، لتتوالى بعدها الثورات الكردية في مختلف الجغرافيات الكردستانية، ابتداءَ بثورات الشيخ سعيد ومحمود الحفيد وسمكو آغا الشكاكي وصولاً لثورات البارزانيين وأخيراً لانتفاضة وثورة حزب العمال الكردستاني مع حلول عام 1984 واللجوء للكفاح المسلح بعد أن سدت الحكوماتُ التركية المستبدة كل الأبواب في وجه الكرد للحوار السياسي.
لكن وللأسف فإن أغلب الثورات والانتفاضات الكردية في القرن الماضي باءت بالفشل نتيجة عاملي الخارج والداخل، كما قلنا سابقاً، حيث تقاطع المصالح الغربية مع الدول الغاصبة لكردستان من جهة، ومن الجهة الأخرى غياب الحركة المجتمعية والسياسية القادرة على تنظيم إرادة الجماهير الكردية في حركة وطنية قادرة على قيادة المرحلة. لكن ومع نمو الوعي الوطني والقومي داخل المجتمع الكردي وضرورات المصالح الغربية لبروز لاعب إقليمي جديد قادر أن يكون شريكاً مع الغرب وعلى الأخص الأمريكان، فقد برز الكرد كلاعبين إقليميين في المعادلات السياسية حيث وجدنا تشكيل كيان سياسي في جنوب كردستان؛ إقليم كردستان (العراق) والتي في طريق إعلان استقلالها التام عن الدولة العراقية وكذلك في “روج آفاي” كردستان برزت حركة وطنية كردية قادرة أن تستفيد من الظروف الإقليمية والدولية وتأسس كيان سياسي وإدارة ذاتية تدير شؤون المناطق الكردية، بل تؤسس عدداً من الأقاليم والكانتونات في الشمال السوري؛ ومن دون أن ننسى ما أنجزته منظومة العمال الكردستاني من تغيير في المعادلة السياسية في شمالي كردستان (تركيا)، حيث ولأول مرة يدخل حزبٌ يحمل هموم الكرد للبرلمان التركي ويكسر حاجز العشرة بالمائة .. وبالتالي ومع تحقيق هذه المشاريع السياسية أو ما يمكن اعتباره من منجزات وطنية وخاصةً في روج آفاي كردستان وما سجلته قوات حماية الشعب من بطولات في دحر الفكر الداعشي والإسلاموي المتطرف عموماً، فقد شكل نقطة انعطاف في الرؤية الغربية للمسألة الكردية وتعاطفه مع حقوق شعبنا، بل بدأ الغرب عموماً يجد في الشعب الكردي شعباً قريباً له فيما يحمله من ثقافة حرة ديمقراطية بعيدة عن قيم العنف والتطرف والتوحش المعروفة كصورة نمطية عن الشعوب الشرقية.
2- نظريّة الاستشراق وما حققه المستشرقون من إيجابيات وسلبيات في الشرق؟ وما كانت مصداقيتهم؟ وأهدافهم؟ وهل استطاعوا أن يفهموا هذه الروح الشرقيّة؟ وهل عالجوا هذه الروح الشرقيّة بطريقة شرقيّة أم بمقاييس الغرب؟ ولماذا لم يدركوا أن الشرق يُدرس بأساليب شرقيّة؟
نلاحظُ من صيغة السؤال تلكَ الخاصية السلبية عن مسألة الاستشراق حيث وللأسف تتميز بنوع من الاستعلاء الغربي على الشرق وحضارته وثقافته. وبكل تأكيد هذا الاستعلاء ترسّخ نتيجة ظروف وواقع سياسي، فقد كانت تعبيراً صارخاً عن تغير مركز القوة والحضارة من الشرق للغرب، فحينها كانت الثورة الصناعية قد حققت منجزها في الغرب، بينما كان الشرق والخلافة العثمانية يعيش حالة الضعف والتفتت والمرض، ولم يأت توصيف “الرجل المريض” عبثاً، بل واقعاً كانت تعاني منها الدولة الإسلامية. وهكذا فإن مفهوم الاستشراق بني أساساً على فكرة التفوق. وتعريفاً وبحسب ويكيبيديا هو “دراسة كافّة البنى الثّقافيّة للشّرق من وجهة نظر غربية” ويضيف المصدر السابق ويقول عن الاستشراق والمسشترقين عموماً: “وأحيانا يكذب المستشرقون عن حال العرب والمسلمين، فهم مصدر غير موثوق للمعلومات”. وتستخدم كلمة الاستشراق أيضاً لتدليل تقليد أو تصوير جانب من الحضارات الشرقية لدى الرواة والفنانين في الغرب. المعنى الأخير هو معنى مهمل ونادر استخدامه، والاستخدام الأغلب هو دراسة الشرق في العصر الاستعماري ما بين القرن الثامن عشر والتاسع عشر. لذلك صارت كلمة الاستشراق تدل على المفهوم السلبي وتنطوي على التفاسير المضرّة والقديمة للحضارات الشرقية والناس الشرقيين. وجهة النظر هذه مبيَّنة في كتاب إدوارد سعيد” الاستشراق“. وبالتالي ومع هذه الأسس التي بني عليه الاستشراق، لا يمكن بحال من الأحوال أن يدرس القيم الحضارية الشرقية برؤية موضوعية قادرة على التعبير عن واقع اجتماعي ثقافي، بل سيقدم رؤية قزمة مبتورة غير قادرة أن تتماهى مع الواقع الحضاري لمجتمعات تضرب بجذورها في عمق التاريخ الإنساني.
وهكذا فقد جاءت أغلب تلك الدراسات الاستشراقية وللأسف غير دقيقة، بل متحاملة في أغلب الأحيان على الشرق وقيمه الحضارية الثقافية وأعطت تلك الصورة النمطية عن الإنسان الشرقي بأنه “بدائي متوحش” وما زال الفكر الغربي يعاني من تلك الصورة النمطية عن الشرق وحضارته. وكما قلنا في المقدمة؛ فقد كانت لتلك الرؤية الغربية الاستشراقية أسبابها ومقدماتها الحضارية الاستعمارية حيث من جهة كان الغرب ينجز ثورته الصناعية بعد عصر النهضة الفكرية والثقافية، حيث تقول الموسوعة الحرة بخصوص الموضوع ما يلي: “شهدت بلدان أوروبا الغربية خلال القرن الثامن عشر نهضة علمية شاملة فتنوعت الأبحاث والتجارب لتشمل مختلف فروع العلم ولتؤدي إلى اختراعات واكتشافات مهمة كانت السبب المباشر في قيام الثورة الصناعية خلال القرن التاسع عشر. وهي ثورة كان لها الأثر البالغ على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سواء في أوروبا أو خارجها” وتضيف كذلك: “ظهرت الثورة الصناعية باختراع الآلة البخارية في إنجلترا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وانتقلت بعد ذلك إلى دول غرب أوروبا ومن ثم إلى جميع أنحاء العالم . وقد كانت إنجلترا الدولة الأولى التي ظهرت فيها الثورة لعدة أسباب ,منها أنها كانت قوية اقتصاديا وأنها تتوفر على موقع جغرافي هام كما أنها كانت منعزلة عن المشاكل داخلها”. وهكذا فإن روح التفوق هذه كرست في الذهنية الغربية بأن الشرق هو التخلف والوحشية وهم وبحكم “تقدمهم الحضاري” مؤهلون لأن ينتدبوا على شعوبها وجغرافيتها. وبالتالي ومع امتلاك هكذا ذهنية لا يمكن بحال من الأحوال قراءة الشرق وفق الذهنية الشرقية، كونك بالأساس ترفض بأن هناك وعي أو وعاء فكري شرقي قادر على القراءة والتحليل والاستنباط .. وهكذا وقع الشرق والغرب ضحية هذه الذهنية الاستشراقية الاستعلائية. وللأسف وما زال الطرفان يعاني من آثارها وتبعاتها حيث لم يتخلص كل منهما من ملحقاتها وآثارها السلبية على العلاقة بينهما حيث العداوة والكراهية، بدل الحوار والتلاقح.
3- فكرة صراع الحضارات وتصادمها حسب هنتغتون، وما أدّى ذلك إلى ويلات على الشرق الأوسط، ولماذا الصدام والصراع؟ كيف ستكون الغاية نبيلة إذا كان الأسلوب غير أخلاقي يعتمد على العنف والظلم والقتل والتهجير..
للأسف إن السياسة الغربية عموماً- وبعد عصور من الحروب والصراعات المذهبية الدينية وحربين عالميتين راحت بنتيجتها ضحايا بالملايين- ما زالت تعتمد في سياقاتها عموماً على الماكيافيلية حيث “الغاية تبرر الوسيلة” وبالتالي فلا وجود لقيم ومبادئ وأخلاق مع هكذا مفهوم سياسي للعلاقات الدولية. ولو عدنا قليلاً إلى الوراء والشخصية الماكيافيلية والتي تأسست مع نشر الفيلسوف الإيطالي “نيقولا ميكافيللي” كتابه بعنوان “الأمير” في عام 1513م ومتضمناً بعض المبادئ التي يري أنها تمكن الفرد من السيادة والسيطرة على الآخرين ومن بين تلك المبادئ:” لا تظهر أبداً بمظهر المتواضع فالتعالي أكثر فاعلية عند التعامل مع الآخرين. التمسك بالقيم والأخلاق يؤدي إلى الضعف أما القوة تحتاج أحيانا إلى الكذب والخداع. من الأفضل أن يخافك الآخرين بدلاً من أن يحبوك”، إذاً ومن خلال معرفة الشخصية السياسية الغربية “الماكيافيلية” سوف تتشكل لدينا لوحة السياسة الغربية عموماً، بأنها تعتمد على عنصر التفوق ولم تأت تلك النظرة الاستشراقية عن عبث. وكذلك اعتبار “نيتشه” أهم فيلسوف أوربي إلى هذا العصر حيث اعتماد فلسفة القوة، وقد ترجمها مؤخراً عدد من فلاسفة العصر الحالي ومن بينهم صامويل هنتغتون في كتابه “صدام أو صراع الحضارات”.
وهكذا ولو عدنا لفكرة مشروع هنتغتون في كتابه “صدام الحضارات أو صراع الحضارات” (The Clash of Civilizations) أو بعنوان “صدام الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمي”، فإننا سوف نجد بأن فكرة الكتاب تقوم على “صراعات ما بعد الحرب الباردة” وبأنها “لن تكون بين الدول القومية واختلافاتها السياسية والاقتصادية، بل ستكون الاختلافات الثقافية المحرك الرئيسي للنزاعات بين البشر في السنين القادمة” وتعود فكرة الكتاب والمشروع كما نعلم لعام 1993 حيث “أثار هنتغتون جدلاً كبيراً في أوساط منظري السياسة الدولية بكتابته مقالة بعنوان صراع الحضارات في مجلة فورين آفيرز، وهي كانت رداً مباشراً على أطروحة تلميذه فرانسيس فوكوياما المعنونة نهاية التاريخ والإنسان الأخير .. جادل فرانسيس فوكوياما في نهاية التاريخ والإنسان الأخير بأنه وبنهاية الحرب الباردة، ستكون الديمقراطية الليبرالية الشكل الغالب على الأنظمة حول العالم”، لكن “هنتغتون من جانبه اعتبرها نظرة قاصرة، وجادل بأن صراعات ما بعد الحرب الباردة لن تكون بين الدول القومية واختلافاتها السياسية والاقتصادية، بل ستكون الاختلافات الثقافية المحرك الرئيسي للنزاعات بين البشر في السنين القادمة”. وبعدها توسع هنتغتون في مقالته وألف كتاباً بعنوان “صراع الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمي” حيث جادل فيه بأنه وخلال الحرب الباردة، كان النزاع إيديولوجياً بين الرأسمالية والشيوعية، ولكن النزاع القادم سيتخذ شكلاً مختلفاً ويكون بين حضارات محتملة وهي .. من جهة الحضارة الغربية ومن الجهة الأخرى بقية الحضارات كالبوذية والإسلامية والصينية والأفريقية، لكن أهم الصراعات ستكون مع الإسلام وفق قراءتهم الاستشراقية.
وبالتالي ووفق السياقات الفكرية والجذور التاريخية يمكننا القول؛ بأن كل من صامويل هنتغتون في “صراع الحضارات” وتلميذه فرانسيس فوكوياما في كتابه “نهاية التاريخ” يعيدان الاستشراق بطريقة أو بأخرى حيث الغرب المتفوق والشرق المتوحش .. وللأسف ما زالت هذه الثنائية هي التي تتحكم في العلاقة بين الطرفين. ولذلك فإن لم يتم تصحيح هذه الفكرة في الذهنية الحضارية، فإن العلاقة ستبقى مرهونة بالقوة والخضوع وكسر الإرادات، مما يفقد شعوبنا عموماً في الشرق والغرب، أرضية الحوار والتلاقي؛ كون العلاقة أساساً تنطلق من فكرة خاطئة بينهما وبالتالي ومن هنا يمكننا القول: بأنه مهما ادّعى الغربُ من قيم حضارية وإن رسالته للشرق هي رسالة حضارية إنسانية ديمقراطية أو ليبرالية علمانية، فإنها ستكون فاقدة للمعاني الأخلاقية الحقة؛ كون هي تأتي من خلال نظرته الاستعلائية على الشرق وتريد أن تفرض قيمها من خلال مبدأ القوة وليس الحوار والتلاقح حيث وللأسف لا تجد في الشرق ما تحاوره فيه وفق نظرتها الاستشراقية، كون الشرق- في قراءتهم- هو الفوضى والوحشية البدائية وعلى الغرب أن “يحضّره ثقافياً” وبالضرورة عن طريق القوة والغلبة والصراع حيث تكون “نهاية التاريخ” وتفوق الليبرالية الغربية، كما نظّر وبشر بها فوكوياما في كتابه المشار إليه ..
باختصار شديد يمكن الاستدراك والقول: بأن على الغرب أن يحاور الشرق لا أن يسيطر ويقضي عليه، وذلك لكي يُكتب نهاية التاريخ؛ كون تلك النهاية ستكون نهاية كل الحضارات وليس فقط نهاية الحضارة الشرقية حيث وببساطة العالم لا يقوم على رجل وحضارة واحدة، بل على تنافس الحضارات ثقافياً ومادياً وفكرياً.
4- نظريّة الدولة القوميّة المستوردة من الغرب ومدى نجاحها وفشلها، وماذا استطاعت أن تحقّق الدولة القومية في الغرب حتّى تحقّقه في الشرق؟ وتآكل هذه النظرية في الغرب، والبحث عن بديل آخر يحقّق التوازن في الغرب نفسه، ولماذا لم يتخلَّ معظم المفكرين في الشرق عن نظرية الدولة القوميّة مع أنّها السبب الرئيس لكلّ مآسي الشرق الأوسط؟
إننا وقبل الدخول في سجال حول أهمية ودور الدولة القومية وضروراتها المرحلية وعدم التخلي عنها في الشرق، لنقف وبشكل سريع على مفهوم تطور الدولة تاريخياً، حيث يقول الكاتب منصور الجمري في مقالة له بعنوان “ما الدولة القومية” بخصوص القضية ما يلي: إن ((المفكرون اختلفوا بشأن الدولة، وإذا ما كان لها شخصية اعتبارية أم لا. فهناك من قال إنها قامت في الأصل على أساس غير أخلاقي (الفيلسوف نيتشه)، على حين قال آخرون بأهميتها إلى حد التأليه (مثل هيغل). غير أن الآراء التي عمت الفكر الإنساني في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين تقول إن «الدولة» هي التعبير القانوني للأمة أو الوطن، وإن أي اعتداء على الدولة هو اعتداء على الأمة والوطن، لأنها مستمدة من إرادة جماعية)) ويضيف؛ ((في عهد الرومان كان يطلق على من يخالف الدولة الرومانية مرتكب جريمة «المساس بالعظمة». وعندما نشأ العهد الإمبراطوري الروماني (بعد العهد الجمهوري) أصبح مفهوم «المساس بالعظمة» يعني أي شخص يخالف القيصر .. بعد انهيار العهد الروماني ومجيء عهد الإقطاع في أوروبا أصبح مفهوم الدولة يعني الأراضي التي يملكها سادة الإقطاع. وكلمة الدولة بالإنجليزية «STATE» قريبة من كلمة «ESTATE»، التي تعني العقار وقطعة الأرض، ولهذا لم يكن التفريق بين الإقطاع والدولة في تلك الفترة واضحا)).
ويستكمل المؤلف الفكرة ليقول: بأن ((الملوك الأوروبيون دخلوا في صراع مع الإقطاعيين على السلطة وحدودها، وانتصر الملوك على الإقطاعيين بعد أن لجأ الملوك للمفهوم الروماني نفسه الذي يرى «المساس بالعظمة» هو «المساس بالملك» وهي جريمة يعاقب عليها. وقد طوّر الملوك المفهوم الروماني وضمّنوه الاعتداءات المباشرة ضد شخص الملك أو أولاده أو امتيازاته بالإضافة، إلى أي اعتداء غير مباشَر على سلطة من سلطات الملك. ثم تغير الأمر بعد الثورة الفرنسية في العام 1789م، إذ أعطت مفاهيمُ الثورة الدولةَ شخصية معنوية أو شخصية قانونية مستقلة عن شخصيات الحكام سواء كانوا ملوكا أو أمراء أو رؤساء. ومفاهيم الثورة الفرنسية قامت على أساس أن الحكام أداة من أدوات الحكم، أو جهاز من أجهزته، يتبدل ويتغير تبعا للحاجات والظروف. أما الدولة ذاتها فتبقى؛ لأنها «ظاهرة اجتماعية»، أي وليدة للتعامل بين أفراد المجتمع. وعلى هذا الأساس تم استبدال جرائم «المساس بالعظمة» بالجرائم المخلة بـ«أمن الدولة»)).
وهكذا نلاحظ بأن الدولة تطورت من أن تكون تعبيراً عن سلطة الملك والإمبراطور لتنتهي إلى اعتبار إن لها شخصيتها المعنوية أو القانونية المستقلة عن الحاكم وهكذا ومع الثورة الفرنسية فقد ((انتشرت الأفكار القومية الأوروبية في القرن التاسع عشر بصورة ألهبت المشاعر وأعطت قدسية وربما ألوهية لفكرة «الوطن» و«الأمة» و«القوم». وقد أدى ذلك اللهب القومي لاحقاً إلى نشوء حركات عنصرية ووصول الحكم النازي في ألمانيا والحكم الفاشي في إيطاليا بعد الحرب العالمية الأولى. وقام هؤلاء الحكام بتحوير مفهوم حماية أمن الدولة ضد جميع المعارضين واعتبروا المعارض السياسي مجرماً وعدوا للشعب؛ لأنه يعادى نظام الحكم القائم)) ويضيف الكاتب نفسه؛ ((مع تطور «الدولة القومية» واحتلالها الموقع الأساسي في تركيبة الأمم المتحدة العام 1945م تعزز كيان الدولة وأصبح بإمكان الحكومات المستبدة أن تصدر القوانين الاستثنائية، أو أحكام الطوارئ بحجة محاربة الإرهاب والتطرف… إلخ، وأنشأت الدولة محاكم أمن دولة ومحاكم استثنائية لمعاقبة المخالفين لها..)). إننا أردنا من هذا السرد التاريخي أن نقف على مفهوم تطور الدولة ومراحلها والتي تقوم أساساً من خلال الوعي الاجتماعي الحضاري لأمة ومجتمع ما مع مبدأ تشكل الوعاء السياسي الحاضن لذاك المجتمع أو تلك الأمة.
وبالتالي ومن خلال مقارنة بين المجتمعات الغربية الأوربية ومجتمعاتنا الشرقية، فإننا نلاحظ بأن هناك فارق حضاري زمني بين هذه المجتمعات؛ ففي حين ما زال الإقطاع يسود بعض الجغرافيات بالشرق أو بالكاد أزيل تأثيراته في واقع مجتمعاتنا، فإن الغرب عاش تلك التجربة قبل ما يربو على قرنين من الزمن، حيث انتهى مع الثورة الفرنسية عام 1789 ولتكون بداية الفكر القومي والدولة القومية. وهكذا فهناك فارق حضاري زمني بين كلا المجتمعين -الشرق والغرب- ما يقارب قرنين أو أقل بقليل ولكون الدولة بصفتها تعبيراً أو الشخصية القانونية التي تعبر عن واقع اجتماعي فهي بكل تأكيد محكومة بدرجة تطور تلك المجتمعات. وبما أن مجتمعاتنا ما زالت في طور ما بعد الإقطاع والملكية، فإن الفكر القومي.. وبالتالي الدولة القومية ستجد لها المناخ والأرضية الملائمة، وأي قفز فوق المرحلة ستكون مغامرة بهلوانية قد تودي بذاك المجتمع لهاوية الفوضى والصراع، وقد رأينا ذلك مع التجربة الشيوعية في البلدان الاشتراكية حيث عادت تلك البلدان إلى تشكيل الهويات والدول القومية ومن ثم تدخل في تكتلات ما بعد الدولة القومية كالاتحاد الروسي أو الأوروبي.. ولذلك وبحكم التطور المجتمعي الحضاري، فإن الغرب يبحث عن تعبيرات سياسية تلائم واقعه الأكثر تطوراً بعد أن كون الدولة القومية لمرحلة ما كتعبير وتشكيل عن هويته وكانت بنفس الوقت سبباً لحروبها وكوارثها، بينما ما زال الشرق بمفكريه وسياسييه وأحزابه الوطنية يتوق لتكوين هوياته الأقوامية تلك، حيث وبالأخير فإن الوعي السياسي تعبير عن الواقع المجتمعي والحضاري للأمم والشعوب.
5- سياسة القطبين قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، وسيادة القطب الواحد قبل الثورة السوريّة وثورة روجآفا، والتوافق الروسي الأميركيّ وما نوعيّة هذا الاتّفاق؟ وما هي الآفاق المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط عبر هذا الاتفاق؟ ولماذا كلّ هذا الصراع على خط كركوك – البحر المتوسط في الأراضي السوريّة؟
ربما الكثير من المفكرين والكتاب روجوا في مرحلة ما لسياسة القطب الواحد؛ التفوق الأمريكي الغربي ووجدوا فيه نوع من تحقق “نبوءة” فوكوياما وبأن نهاية التاريخ باتت حقيقة وأمراً واقعاً، لكن وكما ذكرنا في قضية الصراع بين الشرق والغرب وبأن لا يمكن الحديث عن أي غلبة و”موت” للشرق حيث وقتها ستنتفي كل ما يمكن أن تعرف بحضارة بشرية على كوكبنا، فإن قضية القطبية هي الأخرى تعبير سياسي عن الحالة، حيث إن كانت في الحالة الأولى؛ صراع الحضارات تعبير ثقافي فهنا تتجلى كتعبير سياسي ومثل الحالة الأولى لا يمكن لقطب نسف قطب آخر مثلما لا يمكن لحضارة نسف كل الحضارات الأخرى. طبعاً ذاك لا يعني بأن العالم محكوم ببقاء هذين القطبين؛ الروسي والأمريكي وإنما الحياة والكون قائمة على مفهوم جدلية الصراع أو “وحدة الأضداد” والتي تعتبر من أهم ما كشفت عنها الفلسفة الماركسية؛ أي أن العالم والحضارة البشرية عموماً مرتبطة بهذا الصراع والوحدة بين الشيء وضده .. وبالتالي فإن الثنائية القطبية – وربما في مراحل ما التعددية القطبية- هي الشرط الضامن لحضارتنا وتطورها، حيث الاستفراد والتوحد سيعني التآكل والاجترار. وعندها قد نتحدث عن نهاية الحضارة، بل الفناء والموت الحضاري والوجودي ولذلك لا أحادية قطبية في العالم، لكن ربما تتغير مراكز الحضارة مستقبلاً كما تغيرت في الماضي بين عدد من المراكز الحضارية.
أما بخصوص سياسات هذه الأقطاب- قبل وبعد الاتحاد السوفيتي- وتأثيراتها على واقع مجتمعاتنا وبلداننا وعلى الأخص في المرحلة الأخيرة وتفجر الأوضاع في المنطقة مع ما عرف بـ”ثورات الربيع العربي” فيمكن القول: بأن هناك مبدأ واحداً يتحكم في السياسات الاستعمارية، ألا وهو المصالح الحيوية والاستراتيجية لتلك الدول الاستعمارية في منطقتنا. حيث كان في القرن الماضي الاستعمارين الفرنسي والإنكليزي، واليوم حل مكانيهما الروس والأمريكان، وبالتالي يمكننا القول: هو صحيح تغيرت الوجوه أو بالأحرى الأقنعة، لكن بقيت الأهداف والغايات الاستعمارية واحدة أو يمكن التعبير بما يلي؛ تغيرت الأقنعة الاستعمارية، لكن بقيت المصالح الاستراتيجية نفسها تحكمها. وهكذا فإن كلا الدولتين الاستعماريتين الجديدتين وقد حلتا مكان القديمتين، فإنهما تريدان إعادة تقسيم تركات تلك السابقتين مع بعض الإضافات الجديدة التي توافق مشاريعهما وتنسجم معها وذلك بحسب القدرة الاستعمارية لكلا البلدين ونفوذهما التوسعي وما يرتبط بها من مصالح حيوية ترتبط أهمها بقضايا الطاقة كما أشرتم وإن كانت قضية خط كركوك – البحر المتوسط واحدة منها، لكن وبكل تأكيد ليست الوحيدة في مسار الصراع بين الدولتين في خرائط المنطقة، بل هناك أكثر من حقل للغاز والنفط وخطوطهما في المنطقة للصراع عليها ومحاولة الفوز بها دون الأخرى؛ كون الطاقة هي عصب وشريان التطور الصناعي والحضارة الحالية في أوربا، كما إنها سوف تكسر الاحتكار الروسي للطاقة فهي تعتبر – أي الروس- المورد شبه الوحيد للطاقة لكل الدول الأوربية.
إذاً هناك الكثير من الخطوط النفطية وكذلك السياسية المتشابكة في المنطقة وبالتالي فلا بد من التلاقي أحياناً والصراع في بعض الأحيان. ورغم أن الدولتان السياديتان؛ الروس والأمريكان تتحكمان بتلك الخيوط والخطوط النفطية والسياسية، لكن يبقى لعدد من اللاعبين المحليين على الأرض دورهم وحظوظهم بالفوز ببعض المكاسب والامتيازات. وقد استطاع الكرد في دائرة الصراع أن يثبتوا ومن خلال “ثورة روج آفا” بأنهم لاعب محلي قادر أن يكون فاعلاً على الأرض ويحقق بعض التوازنات المهمة مع القوى الدولية وعلى الأخص في محاربة قوى التكفير والتطرف، فإنه أصبح جزءاً من المعادلة السورية وبقوة ولا يمكن تجاوزه وذلك مهما حاولت بعض القوى الإقليمية والمحلية مثل تركيا وملحقاتها الإخوانية من المطالبة بذلك. حيث بات وضع روج آفا جزءاً من الحل السوري الشامل والذي لن يكون دون تحقيق دولة فيدرالية ديمقراطية، وهذه واحدة من الأوراق التي تم التوافق عليها من تحت أو فوق الطاولة بين الروس والأمريكان؛ كون لكلا الدولتين مصالحهما الاستراتيجية والحيوية في المنطقة وأي منهما لن يرحل كما يتوهم البعض، ولذلك لا بد من توافقات وربما فعلاً تم التوقيع على هكذا تفاهمات وإن كان “الشيطان يكمن في التفاصيل” كما يقول الإنكليز ولذلك نجد أحياناً نشوب الخلاف والصراع في قضايا ومناطق محددة.
وهكذا وختاماً يمكننا القول: المنطقة عموماً تتجه نحو شرق أوسط جديد قائم على مبدأ المشاركة والفيدراليات ونهاية حقب الاستبداد والديكتاتوريات وحكومة العسكر، لكن لن تكون بين ليلة وضحاها، بل سوف يلزم التنفيذ بعض الوقت وربما أكثر من عقدين آخرين، لكن وفي نهاية المطاف فإن المنطقة والشرق عموماً هو الآخر سوف يتجاوز الفكر القومي الانغلاقي المتعصب، وبالتالي تشهد نهاية الدولة القومية وولادة كيانات وكارتلات اقتصادية على غرار تجربة الاتحاد الأوربي أو النمور الآسيوية وعلى أساس المشاركة بين كل المكونات المجتمعية الأقوامية الأثنية والدينية ودون تهميش مكون أو طغيان مكون على آخر، بل تحقيق كيانات وطنية فيدرالية تحقق الحد المقبول من الحريات العامة والديمقراطية وكرامة المواطن. وبكل تأكيد فإن التجربة الحالية في “روج آفا” سوف تعتبر رائدة في هذا الحقل السياسي، ربما تفشل في مرحلة ما لكن الخط والمنحى العام لتطور مجتمعاتنا سوف يأخذ هذا المنحى الحضاري. وهي تجربة قريبة من الطرح الأوربي الأمريكي في فدرلة الشرق ودمقرطته وإن كانت بخصوصية وفلسفة خاصة لتجربة سياسية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني وزعيمها أوجلان ومرافعاته الفكرية .. إذاً وبكلمة واحدة يمكننا القول: إننا نعيش نهاية حقبة الديكتاتوريات وولادة الدولة الفيدرالية الديمقراطية في شرقنا الأوسط وذلك بعد عصور من القمع والاستبداد وحروب طاحنة ووحشية شبيه بعصر الحروب المذهبية في القرون الوسطى والتي عاشتها أوربا لتشهد بعد ذلك ثوراتها الفكرية والمادية وبالأخير تنجز كياناتها السياسية المدنية.





