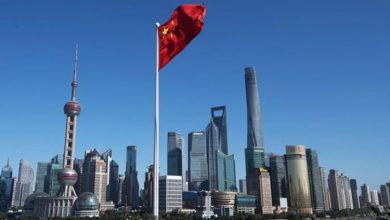عبد الرحمن حمادة
الأرض وطن الإنسان
كان الإنسان ومازال يبحث عن الأمان ورغد العيش والسعادة منذ وُجد على هذه الأرض، وكان ينجح أحياناً ويفشل أحياناً أخرى في طريق سعيه إلى تلك الجنة التي ينشدها والتي تسودها المفاهيم المثالية مثل العدالة والمساواة والرفاهية والسعادة.
وهذا البحث كان يتم في وسط ضبابي تلفّه الحيرة ويحيط به الخوف والمفاجآت تبعاً لتصورات حسية وعقلية لا تقوم على معطيات علمية مؤكدة، وكان يربط النتائج التي يحصل عليها بالمقدمات والأسباب ليراكم عبر الزمن تجاربه ويزداد معرفة بهذا العالم المحيط به ويتعاطى مع حقائقه ويبتعد عن الأوهام.
وقد أخذ ذلك البحث زمناً طويلاً جداً يكاد لا يُعرف له حدّ على وجه الدقة، فحدد لحياته أولويات عرفها من خلال التجربة، منها أنه لا يمكن البحث عن الرفاهية قبل الأمان ولا البحث عن القوة قبل الصحة ومقاومة الأمراض، وأن هناك بناءً يقوم على القاعدة، وتليه المداميك اللاحقة فينشأ البناء، وهذا هو النظام المنطقي لحياة الإنسان، فالأمان أولاً بكل أشكاله من أمان على الحياة وأمان على الغذاء وضمان تدفق وسائله، وبعد ذلك يأتي البحث عن الرفاهية وسبل تحقيقها، فلا رفاهية مع الخوف والجوع والمرض، وكذلك لا سعادة بلا حرية فكيف تكون هناك سعادة لسجين أو مستعبد أو مرتهن، والسعادة تبقى مؤجلة لحين تحقيق الحرية كشرط للبناء فوقه.
وقد حقق الإنسان في مسيرته بعض ما يصبوا إليه، ولكن الحقيقة أن المجتمعات البشرية لم تحظَ دائماً بذلك الاستقرار الذي يجعلها تحافظ على هذه المكاسب والإنجازات والتنعّم بها، فالكوارث والحروب والأمراض والتغيرات في دورات المناخ، كان يعيد العجلة إلى الوراء ليعود البحث عن السعادة المفقودة والنضال لإعادة ما خسره الإنسان الذي يعيد إحياء القيم دون أن يدري ودون أن يضع في ذهنه هذه المقاصد، وهو في الحقيقة يذهب باتجاه الغايات الكبرى من خلال التمسك بالطريق.
و قد أنتج إنسان هذه المنطقة “الشرق الأوسط” بكل مكوناتها عدة حضارات تكاد تكون السفر الأول من أسفار الحضارة الإنسانية منذ سومر و أكاد وبابل وآشور، و أعطى العالم الأبجدية الأولى و قدم التضحيات الكبرى والجهد العظيم، فأنتج القوانين واكتشف الزراعة وطوّرها، ووضع أدوات الإنتاج واخترع العجلة وبنى المجتمع الأول “القرى الأولى”، و عرف الاستقرار ولكن لإشباع قانون داخلي يحكمها، فالأشياء و الأمور العظيمة يكون ثمنها دوماً باهظاً، والحفاظ عليها يتطلب كذلك تضحيات كبرى، فقد كانت العيون شاخصة على هذه المنطقة من العالم لما حوته من رزق وفير وبيئة متعددة الخواص وإنسان متحضّر قياساً لغيره في أصقاع الأرض وتربة خصبة، فكانت تلك الثروات محرّك طمع لغزوها و الاعتداء عليها بطريقة همجية أسكنت الخوف في نفوس السكان وهجرتهم و دفعتهم لركوب الأخطار و الصعاب، أما لمقاومة الغزو و استعادة ما تم سلبه و احتلاله، أو البحث عن حياة أخرى في أمكنة أخرى ينشدون فيها الابتعاد عن الخطر و البحث عن الأمان و لو بمستوى أقل.
نتائج ذلك على الصعيد السياسي
لقد تم صياغة مفاهيم جديدة في سياسة منطقتنا بعد الاحتلالات، كان من أبرز سماتها السيطرة على القرار السياسي ونهب الثروات وقمع حركات التحرر وتغييب الحرية.
ولا يفوت أحدكم معرفة ما حصل في اللعبة السياسية الكبرى التي أحيكت في بداية القرن العشرين من تحالف بين دول أوروبا على الدولة العثمانية وطردها من المنطقة واحتلال المنطقة بدلاً عنها وفرض اتفاقية سايكس بيكو المشؤومة، والتي لا تزال تعاني من تبعاتها حتى اليوم، حيث أن المنطقة تحررت عسكرياً من الاحتلال و لكنها لا تزال محتلة سياسياً واقتصادياً إلى يومنا هذا، ولاتزال التقسيمات التي وضعها المحتل قائمة يعاني منها جميع سكان هذه المنطقة، فقد تجد أهلك خلف الحدود ولا يُسمح لك بالوصول إليهم بحجة هذا التقسيم الذي شمل الجغرافيا و الهوية، فهذا سوري و ذلك عراقي والآخر يمني و الرابع مصري، و المصيبة أن السلطات السياسية التي تصف نفسها بالوطنية و تصدع رؤوسنا هي من تقوم على فرض هذا التقسيم الزائف. أما على الصعيد الاقتصادي فإن هذا التقسيم كان سبباً في فشل هذه الأنظمة اقتصادياً وإبقائها تحت الهيمنة رغم الكم الهائل من الثروات التي توجد بها، ومردّ ذلك:
١ – فشل التعليم والبدائية وغياب التطوير والتحديث فيه على كافة المستويات، فلا معلم تم تطوير أسلوبه ولا وسائل تعليمه، ولا منهاج حديثاً قادراً على إحياء العقل، مما أبقى العملية التعليمية تقليدية تلقينية تعتمد على الحفظ وليس على الفهم وتحريض العقل.
2- غياب البحث العلمي وضعف أو انعدام مستويات تمويله من قبل السلطات، وغياب الحوافز في الإنتاج الصناعي، وتسليط الدول على العميلة الاقتصادية وحرمان الأفراد لعدم قدرتهم على منافستها في كثير من المجالات، والأمثلة كثيرة في سوريا مثل صناعة النسيج والخيوط والملابس تصدت لها شركات القطاع العام، وضيعت كلّ مصانع القطاع الخاص لعدم القدرة على المنافسة، وشركات التعمير والإسكان التي كانت عائدة للجيش وعمالتها شبه مجانية ولا يمكن للشركات الخاصة منافستها والأمثلة كثيرة.
3- الفساد المتفشي في مفاصل الاقتصاد على المستوى الوظيفي وعلى مستوى السلعة ومستوى الخدمة، والذي أدى إلى فقدان الثقة من قبل القائمين في الحقل الاقتصادي سواء كانوا مواطنين أو شركات.
4- غياب الخطط الاستراتيجية للعملية الاقتصادية واعتماد خطط قصيرة وارتجالية تنتج مشاكل كثيرة ومتعددة وغير متوقعة، ويتم البحث عن حلول لها بشكل بيروقراطي طويل الأمد وغير مجدٍ.
5- ربط العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقة بالمزاج السياسي، وكل خلاف وتغيير في المزاج السياسي البيني يؤدي إلى قطع العلاقات الاقتصادية وضياع الجهود والأموال والتعاون، ومن ثم العودة للبحث عن بدائل صناعية مشتركة، ما يلبث أن ينقطع لنفس الأسباب.
6- غياب النظم السياسية الحديثة المبنية على احترام الإنسان واعتباره الثروة الحقيقية والتنمية فيه ولمصلحته، وتطوير الحياة السياسية من دكتاتورية إلى ديمقراطية وتبادل سلمي للسلطة بدل التمسك بها والشمولية، واعتماد الحكم القبلي والديني بدل العلماني، والمشاكل كثيرة في هذا المجال وقد أعطيت نموذجاً عنها فقط.
7- إن كل هذه المشاكل أفقدت الإنسان الأمل بالإصلاح والتغيير، والواقع لا يوحي بشيء من التفاؤل، فلا أحزاب جادة في صناعة برامج تقترب من حياة الناس ولا سلطة واعية بحاجاتهم وتنمية المجتمع ليتمكن من التقدم إلى الأمام، بل يقتصر دورها على حكم الناس والسيطرة عليهم، وأحياناً منعهم من التقدم بطريقة القمع والإسكات والقضاء على كل منتقد لها بدل الاستفادة من التقدم والبناء عليه، ويبقى الجميع ساكتاً لا يريد إثارة المشاكل لنفسه ويتملكه اليأس وينتظر معجزة، وقد يتوقع بعضنا حدوثها لأننا نؤمن بالمعجزات.
النتائج التي يودي بها هذا الوضع
تجد أن المواطن منقطع الصلة مع مفهوم الوطن، فهو يهتم بمنزله ويحافظ على نظافته والاهتمام به فقط ولا يهتم بنظافة الشارع ولا الحديقة ولا المؤسسات، وهو غالباً يساهم في تخريبها ونهبها إذا سنحت له الفرصة وذلك لأنه يربط بينها وبين السلطة نفسياً، ويجد نفسه ناقماً على السلطة ويعبّر عن نقمته تلك من خلال الإضرار بالمفردات التي تحدثنا عنها، والواقع غير ذلك، فهذه المؤسسات والمرافق وجدت لأجل الناس ولخدمتهم والأولى أن يحافظوا عليها وألا يهدموا أوطانهم كما رأينا في العراق وسوريا واليمن وأماكن أخرى.
كذلك تهرّب الشبان من الخدمة العسكرية لأنهم يرون أو يسمعون أن أغلب أبناء المسؤولين لا يلزمون بها، ويتم تهريبهم بحجة الدراسة إلى خارج البلد أو لأسباب أخرى، و يتم التلاعب بمشاعر الناس تحت عناوين مثل الوطنية والتضحية بأنفسهم لحماية الفئة الحاكمة والدفاع عن بقائها في السلطة و توريث أولادهم رقاب الناس البيضاء.
من المؤسف أن نصل بعد تحليل وتفكيك هذه الأوضاع كحقيقة مرة و هي هجرة الشباب الباحث عن الحياة إلى أماكن بعيدة عن الشرور والسياسة والاستعباد والقهر، وترك كل الذكريات والانتماء للمكان والتاريخ والجغرافيا التي تربطهم، للبحث عن الكرامة و عزة ينشدونها و هذه ليست قضية نظرية، فحين يكون صوتاً مسموعاً و محترماً و فعله يخطى بالتقدير؛ يزيد ذلك من الارتباط بالمكان وبالأشخاص من حولك، عندما تجد من جيلك الرعاية و العناية و الدعم لتحقيق مشروعك الذي تؤمن به، سيعطيك هذا سبباً للتمسك بالمكان والأشخاص والاستقرار به و الدفاع عنه، وعن حياتك و مكتسباتك و مكتسبات الشركاء في هذا الوطن.
إن الإنسان يحيا مرة واحدة لا تتكرر، وهو يعرف مقدار أهمية هذه الحياة حتى مع المسعى بمقدارها غير المعلوم، ومع ذلك يتنقل هارباً و متخفياً من مكان إلى آخر باحثاً عن حياة أفضل، و يدخل أكبر تجربة يقلّد من هاجروا قبله أو يتخذ أساليب مبتكرة و يتحمل التبعات الكبيرة و الجسيمة في سبيل تحقيق هذا الهدف، من ضياع العائلات أو غرقهم و معاناة البشر الشاقة و مواجهة الموت عند كل مفترق و منعطف، على أمل الوصول إلى الأمان، و هو أمر ليس مضموناً للجميع حيث أن من وصلوا إلى بلد الاغتراب كثيراً ما واجهوا مشكلات أخرى متل عدم قبول اللجوء أو عنصرية المجتمع المستضيف.
و لقد عجزت بعض الدول عن استيعاب الأعداد الكبيرة للاجئين و المهاجرين، و هناك ظاهرة غريبة لم أجد لها تفسيراً في قضية بلدان مثل إنكلترا، وفرنسا وإيطاليا، لم تتحمل أدنى درجة من مسؤوليتها تجاه الشعوب التي احتلتها بينما، تحملت دول مثل ألمانيا و هولندا وكندا والنمسا مسؤولية كبيرة إنسانية و أعطت المثال و القدوة في هذه المضمار، ووافقت على حقوق المهاجرين و أعطتهم أسباب الحياة المطمئنّة لهم وأولادهم، وأمّنتهم من الخوف و الجوع و الضياع.
الإنسان هو غاية الحياة و حامل مجموعة قيمها العليا والمنادي بالعدل و المساواة والرفاهية وسيادة القانون على الحاكم و المحكوم، وهو الذي صنع الحضارة و اخترع الكتاب والموسيقا وغنى للحب والجمال، وبنى بيديه مجداً لا يزال شاخصاً يتحدى الطغاة، وإن حركة الزمن تقدمية لا عودة فيها للوراء وتاريخ الإنسان مليء بالتضحيات التي تبحث عن الخير و مقاومة الجهل والخوف والفقر والظلم، وما الأرض إلا مواطن الإنسان أين ما كان، وفي أي زمان أو مكان لا أحد يستطيع ادعاء الأحقية أكثر من غيره، والفرق فقط بين مكان وآخر هو النظام السائد عليه و مدى صلاحه، ولا بد أن يتم القضاء على الأنظمة الفاسدة التي تقهر الإنسان كيفما كانت وأينما كانت لتنعم الشعوب بالحياة السعيدة الآمنة والحرية والرفاهية، ولينعم الإنسان بوطنه الأرض.