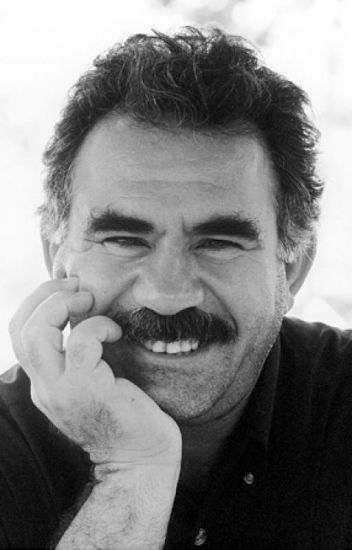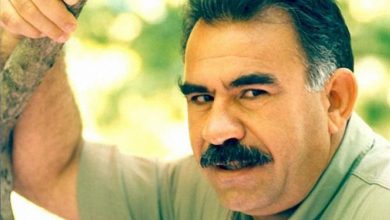في البراديغما الاستشراقيّة والعولمة الأيديولوجيّة للحداثة الرأسماليّة
عبد الله أوجلان

عبد الله أوجلان

في تعريف الاستشراق
الاستشراقُ هو التعبيرُ العلميُّ عن الهيمنةِ الأيديولوجيةِ التي طَوَّرَتها الحداثةُ الأوروبيةُ من أجلِ الشرقِ والشرقِ الأوسط. ويستمرُّ بوظيفتِه كهيمنةٍ فكريةٍ مُؤَثِّرةٍ جداً. أما عَولَمةُ الحداثة، فمُتَداخِلةٌ مع العَولَمةِ الأيديولوجية. بل وربما الهيمنةُ الأيديولوجيةُ أَولى منها. إذ ما مِن غزوٍ أكثرُ تأثيراً من غزوِ الأذهان. ولَطالَما تساءلتُ عن مدى تَجاوُزي للاستشراقية، حتى أثناءَ كتابتي هذه السطور. إني أَعلَمُ عِلمَ اليقينِ أنّ تفكيري بهذه العقليةِ لن يُنقِذَني من الدائرةِ الفاسدة للعبوديةِ الفكرية، بل بالعكس، سيَدُورُ ويَجُوبُ بي داخلَ الدائرةِ نفسِها وكأنه تعذيبٌ أليم. يُلِحُّ الإسلاميون التقليديون ممن يُناهِضون الحداثةَ منذ القرنِ التاسع عشر على الزعمِ بأنّ الإسلامَ نمطٌ فكريّ، وأنهم يُفَكِّرون بشكلٍ مستقلٍّ عن الغرب. الإسلامويةُ كلمةٌ نسبةُ الانخداعِ والضلالِ فيها مرتفعة. فمناهَضتُها للحداثةِ تَسري عن طريقِ الأطروحاتِ الاستشراقيةِ بكلِّ تأكيد. الأمرُ سَيّان لدى القوى الإسلامويةِ المتظاهرةِ والزاعمةِ بمناهَضتِها للحداثة، بدءاً من تنظيمِ الإخوانِ المسلمين إلى تنظيمِ القاعدة. كما أنّ التياراتِ المنساقةَ وراءِ اليساريةِ القطعية، بما فيها الفوضويون، غيرُ قادرةٍ على التفكيرِ دون وجودِ الفكرِ الحداثويِّ عموماً، ودون وجودِ الاستشراقِ فيما يتعلقُ بالشرقِ الأوسطِ خصوصاً؛ على الرغمِ من كلِّ أهدافِها المعارِضة. فالاشتراكيةُ المشيَّدةُ لَم تَكُ سوى حداثويةً هي الأكثر تطرفاً. أما حداثويةُ الصين، فهي نصرُ الاستشراق. هذا ولا يختلفُ الوضعُ بالنسبةِ للتيارِ المحافِظِ التقليديِّ في الهند.
مُناهَضةُ الاستشراقِ تَبدو لي مثيرةً وجذابة. وأُجَرِّبُ ذلك في هذه السطور. فحريةُ الفِكرِ لا تُعَبِّرُ بمُفردِها عن مناهَضةِ الاستشراق. أي أنّ تجاوُزَ الاستشراقِ ليس يَسيراً بقدرِ ما يُظَنّ. هذا وقد يَكُونُ رفضُ شرحِها من خلالِ ركائزِ الحداثةِ الرأسماليةِ الثلاثِ مناهَضةً للحداثوية. لكنّ ذلك لوَحدِه لا يدلُّ على تَخَطّي الحداثويةِ والاستشراقية. والأهمُّ هو ما سيُوضَعُ مكانَ ما يتمُّ رفضُه. كما أنّه بمقدورِ الإسلامِ أو أيةِ شريعةٍ أخرى أنْ تَرفضَ الحداثة. ولكن، عندما يأتي الدورُ على تَحَوُّلِها إلى بديل، فهي تَجِدُ أنْ لا خَيارَ أمامَها سوى الاستسلام لقوى الحداثة. هكذا تَخضَعُ للحداثةِ بوَعيٍ منها أنّ الاستسلامَ المكشوفَ أو المستورَ هو من ضروراتِ مصالحِها. فانهيارُ الاشتراكيةِ المشيدة، ودعكَ من أنْ يَكُونَ ثمرةً لتَخَطّي الحداثة، بل هو نتيجةٌ لتَبَعِيَّتِها المُفرِطة والتامةِ للحداثةِ عن طريقِ ركائزِها الثلاث. ذلك أنّ تكريسَ رأسماليةِ الدولةِ مكانَ الرأسماليةِ الخاصةِ لا يعني رفضَها. ونادراً ما يُعثَرُ على مثالٍ آخر يُؤَيِّدُ هذا الحُكمَ بنحوٍ ضاربٍ للنظر، بقدرِ ما هي عليه الصين. أما عجزُ الماركسيةِ والتيارِ الدينيِّ على السواء عن تطويرِ نظامٍ دائميٍّ ووطيدٍ في الشرقِ الأوسط، فهو يتأتى من عجزِهما عن تجاوُزِ الاستشراق، بل وحتى من كونهما مُطَبِّقتَين أكثر تَطَرُّفاً للاستشراق.
دَع تَخَطّيه جانباً، بل وحتى لَم تَخُضْ في صياغةِ التحليلاتِ بشأنِ هيمنةِ الفكرِ الحداثويِّ والاستشراقيّ. لقد شَرَع أنطوني غرامشي في تجربةِ تحليلِه، ولكنّه لَم يَستطعْ الذهابَ أبعدَ من التجربة. وبالرغمِ من توجيهِ الانتقاداتِ الجرئيةِ من مدرسةِ الفكرِ الفوضويّ، ولكنهم –هم أيضاً– لا يختلفون كثيراً عن أصحابِ الاشتراكيةِ المشيدةِ بخصوصِ إنتاجِ البديل. فرغمَ أنهم تَخَطَّوا الهيمنةَ المذكورةَ نظرياً، إلا أنه لَم تَكُن لديهم مشاكل جادة في موضوعِ العيشِ ضمن بُنيَوِيَّتِه. أما المتنورون الإيرانيون المنعكفون بالأكثر على الاهتمامِ بالفكرِ الحداثويِّ في الشرقِ الأوسط، فلَم يَتَمكَّنوا من الذهابِ أبعدَ من إنشاءِ شيعيةٍ حداثوية. وجميعُ الإسلامويين الآخَرين يُراوِحون في تَكرارِ قولِ أنّ كافةَ أقوالِ الحداثةِ قد ذَكَرَها الإسلامُ قبلَها بزمنٍ بعيد. أما الحدُّ الأقصى لِما نَجَحَت فيه جميعُ التياراتِ الأيديولوجيةِ والحركاتِ السلطويةِ الزاعمةِ بإلحاحٍ بأنها مناهِضةٌ للإمبرياليةِ والرأسمالية، فلا يُعَبِّرُ في فحواه عما هو أبعدُ من الترفيعِ أو تغييرِ المذهبِ من الليبراليةِ والرأسماليةِ الخاصةِ صوبَ الديمقراطيةِ الاجتماعيةِ والاشتراكيةِ المشيدةِ وحركاتِ التحررِ الوطنيّ.
التياران الحداثويُّ والاستشراقيُّ مُؤَثِّرٌ أكثر بكثيرٍ مما يُعتَقَد. وتوجيهُ انتقادٍ على الصعيدِ الثقافيِّ فحسب، لا يعني تجاوُزَ هذَين التيارَين. كما أنّ التغلبَ على إحدى قوى النظامِ المهيمنة، بل وحتى إنجازَ ثورةٍ مناهِضةٍ للرأسمالية؛ لا يُبَرهِنُ على أنه تمَّ توجيهُ الانتقادِ وصياغةُ البديل. فثورةُ أكتوبر كانت مناهِضةً للرأسمالية، ولكنها لَم تَكُ مناهِضةً للحداثوية. بل، وعلى النقيض، فقد قَدَّمَت مساهمةً كبرى في عَولَمةِ الحداثوية، بتَحَوُّلِها إلى أكثرِ المُطَبِّقين تَطَرُّفاً لصناعويتِها ودولتِيَّتِها القومية. هذا والثورةُ الصينيةُ نموذجيةٌ أكثر في هذا المضمار، حيث اعتَقَدَت باستمرارِها في الثورةِ بتطبيقِها أشكالَ الحداثةِ السائدةَ خلالَ القرنِ التاسع عشر. كما أنّ تداعياتِ الضلالِ المشابِهِ المُعاشِ في الثورةِ الفرنسيةِ أيضاً لا تَبرَحُ مستمرةً حتى يومنا الحاليّ.
اتخاذُ اللّبناتِ الأساسيةِ في الهيمنةِ الحداثويةِ والاستشراقيةِ الأيديولوجيةِ شرطٌ لا غنى عنه أثناء انتقادِها. ولدى قَبُولِنا بركائزِها الثلاثيةِ لبناتٍ أساسية، فستُدرَكُ أهميةُ الموضوعِ بمنوالٍ أفضل. هذا وبالمقدورِ الإشارة بأهميةٍ عُليا من حيث المبدئيةِ إلى إمكانيةِ توجيهِ أكثرِ الانتقاداتِ راديكاليةً بموجبِ هذه الأسس، وأنه ينبغي إيجاد البدائلِ بناءً على هذه الأسسِ بالضبط. والانتقاداتُ بحَدِّ ذاتِها يجب أنْ تَتَّخِذَ من الكُلّيّاتيةِ المتكاملةِ والفتراتِ البنيويةِ أساساً. ذلك أنّ انتقادَ الأدوارِ الشخصيةِ بموجبِ الأحداثِ القصيرةِ المدى والفتراتِ السياسيةِ فحسب، لن يَكفيَ لكشفِ النقابِ عن الحقيقة. فإذا لَم تُرَسَّخْ الكُلِّيّاتيةُ هنا إلى جانبِ مصطلحِ الفترةِ على أرضيةِ الانتقادات، فالنتائجُ التي ستَبرزُ للوسطِ ستحتوي عيوباً وأخطاءً فادحةً كأنْ تَكُونَ مُتَجَزِّئةً وفي غيرِ زمانِها، وبالتالي أنْ تَكُونَ بلا معنى أو جدوى، ولا تُعَبِّرُ عن الحقيقة. فأياً كان ما نَنتقدُه، فإنه يتعينُ علينا حتماً القيامُ بالتشخيصِ السليمِ لكُلِّيّاتياتِ وفتراتِ ما ننتقدُه. فإذ ما كانت الحداثةُ موضوعَ الحديث، فسيتوجبُ العملَ أساساً بموجبِ كونِها تُشَكِّلُ كُلّياتيةً متكاملةً على خلفيةِ ركائزِها الثلاثِ بأقلِ تقدير، وكونِها تَشملُ زماناً طويلَ المدى وبُنيوياً ونظامياً، تُقَدَّرُ فترتُه بخمسةِ قرون. من هنا، فالخطأُ الأوليُّ الذي ارتَكَبَه معارِضو النظام، وفي مقدمتهم الماركسيون، هو تأطيرُهم انتقاداتِهم المُوَجَّهةَ إلى نظامٍ طويلِ المدى ومستندٍ لركائزَ ثلاثية، بفتراتٍ قصيرةِ المدى، بل وحتى بغَضِّ النظرِ أحياناً عن الفترة، وبانتقادِه ضمن بُعدٍ واحدٍ منه؛ كأنْ يتناولوه ضمن بُعدِ الرأسماليةِ فقط. علماً أنّ التحليلاتِ المُصاغةَ بخطوطٍ عامةٍ في هذه المرافعةِ تُشيرُ إلى أنه كَي تُفهَمَ الرأسمالية، فمن الضروريِّ حتماً انتقادها ضمن صِلاتِها مع نظامِ المدنيةِ المركزية، ووفق مسارِ صعودِها الطويلِ المدى، وبِمَعِيّةِ ظاهرتَي الدولةِ القوميةِ والصناعويةِ اللتَين تُعَدّان بُعدَين آخرَين أساسيَّين.
يجب عدم النظرِ إلى الاستشراقِ بالمعنى الضيقِ على أنه يعني أفكارَ المُفكرين الأوروبيين بصدد مدنياتِ وحضاراتِ الشرقِ الأوسطِ ومجتمعاتِه. أما الاستشراقُ بالمعنى العامّ، فيعني تأمينَ تبعيةِ الطبيعةِ الاجتماعيةِ في المنطقةِ لهيمنةِ الحداثةِ الأيديولوجية، واتّخاذَ بُنيَتِها العلميةِ أساساً؛ بدلاً من تطويرِ الفكرِ العلميِّ بشأنِ تلك الطبيعةِ الاجتماعيةِ أو تأمينِ تنويرِها. ذلك أنّ غزوَ الحداثةِ الرأسماليةِ خلال القرنَين الأخيرَين لَم يَجْرِ في ميدانِ الثقافةِ الماديةِ فحسب، بل وسَرَى بنسبةٍ أكبر في ميدانِ الثقافةِ المعنويةِ أيضاً. فما التياراتُ الأيديولوجيةُ والحركاتُ والثوراتُ السياسيةُ البارزةُ للوسطِ سوى نُسَخٌ ممسوخةٌ ومُهَمَّشةٌ مما تَحَققَ في أوروبا. ولهذا السببِ ظلَّ تأثيرُها على المجتمعِ سطحياً. إذ أنّ المجتمعَ المنحصرَ بين تقاليدِه وأعرافِه والحداثة، يَحيا وضعَ أزمةٍ دائمةٍ حصيلةَ معاناتِه التوترَ المستمرَّ وعجزِه عن تحديثِ نفسِه.
مناهَضةُ الاستشراقِ ممكنةٌ بمناهَضةِ الحداثوية. هذا وبالمقدورِ تقييم الإسلامويةِ السياسيةِ الراديكاليةِ بناءً على الاستشراق، باعتبارِها الشكلَ الاستشراقيَّ للحداثوية. ولا قيمةَ لها في تكوينِ البديلِ قطعياً. حيث أنها لا تتعدى استخدامَ حجّةِ القومويةِ الدينيةِ كَرَدَّةِ فعلٍ على القومويةِ العلمانية. أما الثوراتُ العربيةُ والتركيةُ والفارسية، فهي ثوراتٌ استشراقيةٌ نموذجية. فقد حَدَّدَت هدفَها الأولَ في بناءِ صرحِ الدولةِ القوميةِ العصريةِ باللجوءِ إلى القومويةِ الدينيةِ والعِرقية، سواء بشكلٍ منفصلٍ أم متداخل. كما اعتَقَدَت أنها انتهَت من القيامِ بأدوارِها بتوحيدِها ذلك مع رأسماليةِ الدولةِ وصناعويتِها. أما تَخَلُّفُها عن أوروبا عدةَ قرونٍ في هذا المجال، فهو مكتوبٌ في قَدَرِها. لذا، فبلوغُ القِيَمِ الأوروبيةِ غدا عقدةً لديها من جميعِ المناحي.
الهيمنة الرأسمالية العصرية
لقد وَلَّدَ قيامُ قوى الهيمنةِ الرأسماليةِ المتصاعدةِ في أوروبا الغربيةِ كوارثاً مفجعةً بانتزاعِ زمامِ قيادةِ نظامِ المدنيةِ المركزيةِ ذاتِ الأصولِ الشرقِ أوسطية، وسعيُها إلى إعادةِ بناءِ هيمنتِها تأسيساً على ثقافةِ الشرقِ الأوسط. حيث أوصَلَت الثقافاتِ الاجتماعيةَ المُعَمِّرةَ آلافَ السنين إلى مشارِفِ التصفية، بتعريضِها إياها للمجازرِ والاستعمارِ وعملياتِ الصهرِ والإبادةِ والدَّمجِ القسريِّ الذي مارسَته مِراراً وتكراراً، وذلك من خلالِ تسليطِ هيمنتِها وهيمنةِ الدويلاتِ القوميةِ التي تتصدرُ لائحةَ مؤسساتِها العميلةِ على الثقافتَين الماديةِ والذهنيةِ في أجواءٍ تسودُها الحروبُ الدائمة. ولَكَم هو مؤسِفٌ حقاً أنّه لا يتم التفكيرُ حتى باستيعابِ كَنَهِ ومضمونِ تلك المؤسساتِ العميلةِ المهيمنةِ المُشادةِ بناءً على استثمارِ واستغلالِ التناقضاتِ البنيويةِ البارزةِ في غضونِ القرنَين الأخيرَين من تاريخِ الشرقِ الأوسط. إنّ بسطَ نفوذِ الحداثةِ الرأسمالية، ليس على الفكرِ الاستشراقيِّ وحسب، بل وعلى كافةِ مجالاتِ الحياة؛ لا يُمكنُ إيضاحُه إلا بتحليلاتٍ شاملةٍ ومعمَّقةٍ للغاية نظرياً، وبالتواجدِ داخلَ “القفصِ الحديديِّ” عملياً على سبيلِ المَجازِ والاستعارة.
فمثلاً؛ لَم يُنتَقَدْ بَعدُ دورُ الحداثةِ الرأسماليةِ بشأنِ إرثِ الآشوريين والأرمن والإيونيين والجيورجيين الذين يتصدرون لائحةَ الثقافاتِ العريقةِ الآهلةِ منذ آلافِ السنين، والذي يكاد يصبح تُحفةً نادرة. ولا يزالُ العجزُ يسودُ موضوعَ الاهتداءِ بالفكرِ الدياليكتيكيِّ لتسليطِ النورِ على المجازرِ والإباداتِ التي مرت بها تلك الثقافات. فرغم أنّ السلطاتِ الحاكمةَ ذاتَ الأصولِ العربيةِ والفارسيةِ والتركية، والتي أنشَأَت نفسَها كدولٍ قومية، تؤدي وظيفتَها كآلاتِ إبادةٍ مُسَلَّطةٍ حتى على ثقافاتِها الاجتماعيةِ ذاتِها؛ فإننا نرى هذه الحقيقةَ لا تزالُ مَتروكةً في أغوارِ الظُّلُمات. إنّ انهيارَ الدولةِ القوميةِ وبدءَ سقوطِ القناعِ عنها، قد بَيَّنَ كفايةً أنّها من حيثُ الجوهرِ ذاتُ بنيةٍ توتاليتاريةٍ فاشية، وذلك بسببِ “قانون الربحِ الأعظميِّ” لهذه المؤسسةِ التي تسعى لخلقِ “المجتمعاتِ القوميةِ النَّمَطِيّة”، ليس في المستعمَراتِ فحسب، بل وفي مناطق القوى المهيمنةِ الرئيسيةِ (المركز) أيضاً.
وعندما يَكُونُ الكردُ موضوعَ الحديث، فإنّ لوياثانَ الحداثةِ الرأسماليةِ المُستَحدَثَ ذاك يتقمصُ أقنعةً هي الأكثرُ خِفيةً عن الأنظار، ويُنشئُ شتى أنواعِ القرائن، ويَفرضُ إبادةً ثقافيةً متركزةً باضطراد؛ وكلّ ذلك تحت اسمِ “التقدم”. لا ريب في أنّ لإبادةِ الكردِ ثقافياً دوافعُ جذريةٌ نابعةٌ من نظامِ المدنيةِ المركزيةِ ذاتِ الأصولِ الشرقِ أوسطية، ولا يُمكنُ ردُّها إلى الحداثةِ الرأسماليةِ فقط. ولكن، ومن دونِ تسليطِ الضوءِ على الهيمنةِ الرأسماليةِ العصريةِ المنحدرةِ إلى أوروبا الغربيةِ ودورِها في المنطقةِ خلال القرنَين الأخيرَين؛ فلن يَكُونَ باستطاعتِنا صياغةُ المصطلحاتِ والمفاهيم والنظريةِ اللازمةِ لمعالجةِ الواقعِ الكرديِّ أو القضيةِ الكرديةِ التي باتت في حالةٍ سرطانية. لقد تمَّ تكوينُ النُخبةِ “التركيةِ البيضاء” الفاشيةِ من مجموعِ شتى العناصرِ غير القومية، والمُصابةِ بمَرَضِ السلطةِ أكثر من العنصرِ التركيِّ نفسِه؛ بحيث لا يُمكنُ عقدُ علاقةٍ بينها وبين الواقعِ التركيِّ البارزِ للوجودِ على أنقاضِ تقاليدِ الإمبراطوريةِ العثمانية، إلا من خلالِ النزعةِ السلطويةِ الضيقة. ومسؤوليةُ إنكلترا، ومن ثم ألمانيا وفرنسا وغيرها من قوى الهيمنةِ الأوروبيةِ المشهورة، بارزةٌ بوضوحٍ في توظيفِ تلك النخبةِ كآلةِ إبادةٍ مُسَلَّطةٍ على كافةِ ثقافاتِ شعوبِ الشرقِ الأوسط، بما فيها الشعبُ التركيُّ نفسُه أيضاً. فبينما بالمستطاع، وبكلِّ سهولة، إيضاحُ كيف أنّ هذه الفاشيةَ “التركيةَ البيضاءَ” أدت دورَها كمجردِ آلةٍ في مجزرةِ الأرمنِ التي باتت حديثَ الساعة؛ فإنّ تَمَلُّصَ قوى الهيمنةِ تلك من كشفِ النقابِ عن مسؤولياتِها، وإلقاءَها كاملَ مسؤوليةِ جُرمِ الإبادةِ على عاتقِ الأتراك، لا يُمكنُ تفسيره إلا بتزويرِ الحقائقِ المتعمَّدِ من قِبَلِها.
بالإمكانِ رصدُ هذا الواقعِ بوضوحٍ أكبر، وتسليطُ الضوءِ عليه، وخاصةً فيما يتعلقُ بإبادةِ الكردِ ثقافياً. وسأعملُ على شرحِ تعقيداتِ هذا الواقعِ في هذا المُجَلَّدِ الأخيرِ من مرافعاتي المُقَدَّمةِ إلى “محكمةِ حقوقِ الإنسانِ الأوروبية”. فمحاكمتي في جزيرةِ إمرالي، قد فُرِضَ إجراؤُها من حيث المضمونِ على يدِ الجمهوريةِ التركية، وذلك باسمِ نظامِ الدولةِ القوميةِ الأوروبيّ. أي أنها ليست محاكمةً متحققةً بقوةِ الدولةِ التركية. ودورُ النخبةِ السلطويةِ التركيةِ فيها لا يتعدى دورَ الدميةِ أو الوسيطِ الفرعيّ. لا شكّ طبعاً بأنّ هذا دورٌ شنيعٌ ومُشَوِّهٌ للعقول. وصياغةُ حقيقتِه صياغةً صحيحة، أمرٌ يتمتعُ بأهميةٍ كبرى. وذلك لأنّه يَسُودُ الإصرارُ على عدمِ رؤيةِ أو الاعترافِ بالألاعيبِ القانونيةِ والقمعِ السلطويِّ المُطَبَّقِ عَلَيّ. فحتى موضوعٌ مثلَ اعتقالي، والذي هو حصيلةُ تمشيطٍ مستورٍ إلى آخرِ حدٍّ على يدِ شبكةِ غلاديو (الناتو الخَفِيّ)، والذي يُدَلِّلُ على اختراقِ القانونِ العالميِّ وقانونِ الاتحادِ الأوروبيِّ علناً؛ تَدورُ المساعي لإنهائِه والبتِّ فيه ضدي داخلَ “محكمةِ حقوق الإنسان الأوروبية” أيضاً، والتي تقعُ تحت مسؤوليةِ المفوضيةِ الأوروبية، ومن المفترضِ أنها تتسمُ بالعدالة. فبشأنِ القرارِ المتعلقِ بي دُونَ غيرِه من بين القراراتِ التي تناهزُ المائتين، والخاصةِ بدَعوى “إعادةِ المحاكمة”، ورغم أنه مُصَنَّفٌ ضمن الملفاتِ المندرجةِ في نفسِ الحالة؛ فإنه انطلاقاً من الزعمِ بالبَتِّ في “الملف”، فقد أُعيدَ إلى محكمةِ حقوقِ الإنسانِ الأوروبية، دونَ أيِّ شعورٍ بالخجلِ أو عذابِ الضمير؛ وذلك بناءً على اتفاقٍ مُخزٍ وفاضحٍ أَبرَمَته المفوضيةُ الأوروبيةُ مع الدولةِ التركية، لِيُعتَبَرَ بالتالي أنّ أهمَّ جزءٍ في الدعوى قد فُضَّ منه. وهي تَنتَظرُ الموقفَ الذي ستتَّبعُه محكمةُ حقوقِ الإنسانِ الأوروبية حيالَ البرلمانِ التركيِّ الذي لا يزالُ يَختَرقُ كلَّ مبادئِ القانونِ الدوليّ، ويَسنُّ مواداً خاصةً بغية عدمِ تطبيقِ الأحكامِ القانونيةِ التي هي لصالحي؛ وكذلك حيالَ القضاءِ التركيِّ وممارساتِه وقراراتِه الخارجةِ عن القانونِ بكلِّ علانية. أما تواجُدي منذ اثنتَي عشرةَ سنةٍ تحت نِيرِ وضعٍ أقرَبُ ما يكونُ إلى الإعدام، والذي لَم يُطَبَّقْ على أيِّ مَحكومٍ عداي، وهذه المواقفُ غيرُ العادلةِ والمنافيةُ للقضاءِ التركيِّ ولمعاييرِ محكمةِ حقوقِ الإنسانِ الأوروبيةِ بِحَدِّ ذاتِها؛ فهو بمثابةِ بُرهانٍ على استمرارِ المؤامرةِ الدوليةِ المحبوكةِ حول الدعوى حتى في الميدانِ القانونيّ، وعلى أنّ شبكةَ الغلاديو لا تَبرحُ قائمةً على مهامِّها في هذا الشأن.
تيار النزعة العثمانية المؤسس لغرض الصهر والإبادة
لا تزالُ ثقافةُ الشرقِ الأوسطِ بعيدةً عن استيعابِ وفهمِ كيفيةِ غزوِها خلال القرنَين الأخيرَين. وبوِسعِنا استخلاصُ ذلك بأكثرِ حالاتِه شفافيةً من مأساةِ صَدّام حسين. فما يُزعَمُ أنها “حروبُ الاستقلال”، والتي دارت رَحاها في غضونِ القرنَين الأخيرَين، سواءً باسمِ الإسلامويةِ (السَّلَفِيّة) مجدَّداً، أم باسمِ القومويةِ العلمانية؛ هي في حقيقتِها حروبٌ ترمي إلى تصعيدِ الهيمنةِ الرأسمالية، لا غير. حيث طُوِّرَ هذان الأسلوبان (الإسلاموية، القوموية) كنسختَين مشتَقَّتَين من الأيديولوجيا الاستشراقية، واستُخدِما تأسيساً على احتلالِ الذاتِ بالذات تحت اسمِ الرأسمالية. أي أنّه، وفيما خلا بضعةٍ من الحروبِ الريادية، فقد حقَّقَ النظامُ المهيمنُ توسعَه ونموَّه في واقعِ الأمرِ بِيَدِ الشرائحِ النخبويةِ في ثقافةِ الشرقِ الأوسطِ بذاتِ نفسِها، عن طريقِ تلك الأجهزةِ الأيديولوجيةِ والسياسية (السلطة). هذه النقطةُ بالغةُ الأهمية. ومن دونِ فهمِها كما ينبغي، لن يَكُونَ بالمقدورِ تحليلُ أو حلُّ الوضعِ الراهنِ للشرقِ الأوسط. أو بالأحرى، فسيُبقى على المنطقةِ تتخبطُ في معمعانِ الفوضى عبر مشاريعِ النظامِ المهيمن (الشرق الأوسط الكبير)، سعياً إلى تفكيكِها وإعادةِ بنائِها على خلفيةِ المصالحِ الجوهريةِ للنظام.
لن نستطيعَ تحليلَ التطوراتِ الطارئةِ على الواقعِ الكرديِّ خلال القرنَين الأخيرَين، إلا على ضوءِ هذه المتغيراتِ الجاريةِ عالمياً وإقليمياً. حيث عُمِلَ على تضييقِ الخناقِ على كردستان تدريجياً في مطلعِ القرنِ التاسعِ عشر، من قِبَلِ الإمبراطوريةِ الإنكليزيةِ جنوباً عبر العراق، ومن قِبَلِ روسيا القيصريةِ شمالاً. في حين كانت الإمبراطوريةُ العثمانيةُ تخوضُ غمارَ حربِ الوجودِ أو العدمِ في سبيلِ الصمودِ والوقوفِ على قدَمَيها تحت ظلِّ حصارِ كِلتا القوتَين لها أيضاً. وما مساعي سليم الثالث ومحمود الثاني الإصلاحيةُ سوى بهدفِ تأخيرِ الانهيار. أما محاولاتُ والي مصر محمد علي باشا في تبديلِ الأسرةِ الحاكمة، فما كان بالمقدورِ إيقافُها، إلا بالتنازلاتِ المُقَدَّمةِ إلى الإمبراطوريتَين الإنكليزيةِ والروسية. وبينما كانت الحربُ الملليةُ الناشبةُ بين ثناياها تُبَعثِرُ الإمبراطوريةَ وتُشَتِّتُها، فقد وُجِدَ في الالتحاقِ بالنظامِ الغربيِّ عن طريقِ الإصلاحاتِ حلاً يُعَوَّلُ عليه لعرقلةِ الاضمحلال. وما ميثاق التحالف ، إلغاءُ الانكشارية، تأسيسُ الجيشِ النظاميِّ الجديد، فرمانُ الإصلاحِ والتنظيمات، المشروطية الأولى والمشروطية الثانيةُ سوى لهذا الغرض. وحصيلةَ تلك الإصلاحات، تحققَ الالتحامُ تماماً بالنظامِ الرأسماليِّ المهيمن. وهذا ما آلَ بدورِه إلى انفتاحِ بوابةِ ثقافةِ الشرقِ الأوسطِ على مصراعَيها أمام حملاتِ النظامِ القائمِ في الغزوِ والصَّهرِ مادياً ومعنوياً في آنٍ معاً. وتيارُ النزعةِ العثمانيةِ المُؤَسَّسُ لهذا الغرض، والتحديثُ البيروقراطيُّ الرامي إلى تحقيقِ ذلك؛ ليسا في جوهرِهما سوى بهدفِ وقفِ انهيارِ أجهزةِ السلطةِ التقليديةِ المُسَلَّطةِ على الشعب، وتصعيدِ الهيمنةِ الرأسمالية. وقد كانت إنكلترا المُوَجَّهَ الرئيسيَّ في هذا الشأن. في حين كان تأثيرُ فرنسا وألمانيا وروسيا أيضاً سيزدادُ طردياً.
عندما نَعكفُ على تحليلِ تمرداتِ القرنِ التاسعِ عشر وحركاتِ الاستقلالِ فيه، فمن الواجبِ الإدراكُ على أتَمِّ وجهٍ لحالةِ المَرَضِ الذي أَلَمَّ بالإمبراطورية، وأنّ الحُكّامَ الفعليين لها هم القوى الرأسماليةُ المهيمنة. فقد كان السلطانُ العثمانيُّ وبيروقراطيتُه يَحكمون الإمبراطوريةَ ظاهرياً، في حين أنّ هذا الحُكمَ لَم يَكُ يتميزُ بأيِّ معنى أكثر من كونِهم دُمىً ووسطاء هامشيين. لَم يقتصر الأمرُ على الإمبراطوريةِ العثمانيةِ فحسب خلال القرنَين الأخيرَين، بل إنّ اللاعبين الأُصَلاء المتلاعبين بالإمبراطوريةِ الإيرانيةِ أيضاً هم قوى النظامِ المهيمنة، وما عداها كانوا رموزاً صُورية. ذلك أنّ الاحتلالَ والغزوَ والاستعمارَ المباشرَ كان يُكَلِّفُها ثمناً باهظاً من جهة، ولا داعي له على صعيدِ مآربِها من جهةٍ أخرى. فبلوغُ المآربِ المهيمنةِ بِيَدِ الرموزِ الصّورية، كان يتطلبُ أقلَّ التكاليف، ويتحققُ بأوطدِ الأشكالِ على حدٍّ سواء. لكنّ جميعَ الشعوبِ (بما فيها الأتراكُ كأثنيةٍ مسيطرة) باشرَت بالانتفاضِ في وجهِ هذا النظامِ المهيمنِ الجديد. ما جرى حينها كان ردودَ فعلٍ عارمةً ومقاومةً شاملة. فقامَ النظامُ بتطويرِ مختلفِ الأساليبِ بغيةَ قمعِها ودَرءِ خطرِ الانشقاق. والاستشراقيةُ وحملاتُ التبشيرِ والنزعةُ الإصلاحيةُ كانت أساليباً رئيسيةً في هذا المضمار. كما أُضيفَت إليها التياراتُ المناديةُ بالمَلَكيةِ الدستوريةِ (المشروطية) والقومويةِ أيضاً. وكمحصلةٍ لجميعِ الأساليبِ المذكورة، فقد شيِّدَت دولٌ قوميةٌ صغيرةٌ في المنطقة، وأُعيدَ إرفاقُها بالنظامِ القائمِ اعتماداً على نزعةِ أمةِ الدولة. وإلى جانبِ كونِ الحركاتِ المناهِضةِ للنظام، والمتصاعدةِ على أرضيةِ ثورةِ أكتوبر، قد أَحرزَت مكاسباً ذاتَ شأن؛ إلا أنّ عجزَها عن تجاوُزِ الحداثةِ الرأسماليةِ وتطويرِ عصرانيةٍ جديدة، قد انتقلَ بها إلى أزمةٍ عميقة. هكذا، وبينما أُرفِقَ فريقٌ بالنظامِ القائم، بات الباقون معارِضين مشلولي التأثير.
علاقة ثقافة الشرق الأوسط مع الغزو الغربيّ
لا أَستَصغِرُ البتةَ الانتقاداتِ والممارساتِ المُوَجَّهةَ خلالَ القرنَين الأخيرَين إلى الثقافةِ الماديةِ والمعنويةِ للمدنيةِ المركزيةِ ذات الخمسةِ آلافِ سنة، بما فيها شتى أنواعِ الاشتراكية والفوضوية والمقاوماتِ الثقافيةِ أيضاً. فضلاً عن أنّ التياراتِ الأيكولوجيةَ والفامينيةَ التي ظهرَت مؤخَّراً تُعتبَرُ انفتاحاتٍ تستحقُّ التقدير. لكنْ مع ذلك، فإذا كان نظامُ السلبِ المترسخُ عن طريقِ السنداتِ الوَرَقِيَّة، والذي يُهَدِّدُ كلَّ النباتاتِ والحيواناتِ والناسِ بل وحتى الغلافِ الجويِّ بنحوٍ غيرِ مسبوقٍ في التاريخ؛ إذا كان لا يَبرَحُ واثقاً من نفسِه في بسطِ نفوذِه ككابوسٍ مرعبٍ يهددُ الحياة، فإنّ هذا الوضعَ برهانٌ قاطعٌ على وجودِ أخطاء ونواقص جادةٍ في الجبهةِ المضادة. حيث ما مِن مرحلةٍ من التاريخِ هُيِّئَت فيها البشريةُ إلى هذه الدرجةِ من الانفتاحِ على الظلمِ والاستغلال.
أما ثقافةُ الشرقِ الأوسط، التي خَضَعَت لهيمنةِ المدنيةِ الأوروبيةِ المتناميةِ تدريجياً في القرنَين الأخيرَين، فهي تسيرُ على نهجِ الانتحار، متخطيةً بذلك نقطةَ الإفلاس. هذا ليس مبالغة، فظواهرُ الانتحارِ اليوميةُ حقيقةٌ قائمةٌ في المناطقِ التي تَسودُ فيها هذه الثقافة، بدءاً من الهند والصين وأفغانستان، ووصولاً إلى شواطئِ المحيطِ الأطلسيّ. وعِوَضاً عن النظر إلى قِلَّةِ تلك الظواهرِ أو كثرتِها، فإنّ تحليلَ الثقافةِ المتواريةِ وراءَها قد يُوَضِّحُ ما يجري بصورةٍ أفضل. فالسرودُ الثقافيةُ التقليدية (الأديان الإبراهيمية التوحيدية) والشروحُ الاستشراقيةُ للمدنيةِ الغربيةِ لا تمتلك القدرةَ على إيضاحِ ظاهرتَي الأزمةِ والانتحارِ المذكورتَين. علماً أنها تُشَكِّلُ بمفردِها السببَ والنتيجةَ في آنٍ معاً لظواهرِ الأزماتِ والانتحارِ تلك، وتُعَدُّ جزءاً منها.
لا ريب في أنه من الصعبِ تحليلُ ثقافةِ الشرقِ الأوسطِ وأزمةِ الدولةِ والمجتمعِ الحاليةِ بتجاوُزِ هيغل وكارل ماركس. لقد وُجِّهَت الانتقاداتُ إلى تجربةِ بسطِ الهيمنةِ الرأسماليةِ على المنطقة، وأُبدِيَت مقاوماتٌ كثيرةٌ ضدها طيلة القرنَين الأخيرَين في الخارجِ والداخلِ على السواء. وكان الفشَلُ يشكِّلُ القاسمَ المشتركَ لتلك المقاومات. فقيامُ مختلف القوى بتحليلِ تاريخِ المنطقةِ ووضعِها الراهن، ونجاحُها في بناءِ أنظمتِها أمرٌ بعيدُ المنال، بدءاً بالقوى الإسلاميةِ الراديكاليّةِ إلى المعتدلةِ منها، ومن القوى الشيوعيّةِ إلى القوموية، ومن القوى الليبراليّةِ إلى المحافِظةِ المتزمتة. بالتالي، فشتى أنواعِ النقلِ والاقتباسِ من التاريخ، والتي قامت بها مختلفُ الشرائحِ والمجموعاتِ وفقاً لمصالحِها ومَشارِبِها عن طريقِ أنشطتِها الاستشراقيةِ المُستَورَدةِ والمُقتَبَسةِ من المدنيةِ الأوروبية، قد عَجِزت جميعاً عن تكوينِ تركيبةٍ جديدةٍ أو صياغةِ نظريةٍ سديدةٍ أو إحرازِ تطورٍ سياسيٍّ حرٍّ موفق.
سيَغدو ممكِناً إدراكُ القرنَين الأخيرَين في الشرقِ الأوسطِ بواقعيةٍ أكبر، إذ ما تمَّ تناوُلُ الحركاتِ الوطنيةِ الأرمنيةِ والرومية والآشوريةِ والعربيةِ والكرديةِ والتركيةِ والفارسية بهذا المَنظورِ الذي مَرَّ من مرحلةِ التحديث. والأيديولوجيا التي يجب استحداثُها دون التمييزِ بين يمينيٍّ ويساريٍّ أو بين دينيٍّ وعلمانيّ، هي وجهةُ النظرِ الاستشراقية، بل الاستشراقيةُ نفسُها، والتي تتوارى في أساسِها جميعاً. لقد عانى الشرقُ الأوسطُ في غضونِ القرنَين الأخيرَين من أزمةٍ غائرةٍ على صعيدِ السلطة، ليس في موضوعِ التبعيةِ المهيمنةِ فقط، بل ومن حيث تَجَزُّؤِ المنطقةِ بالدُّوَيلاتِ القوميةِ أيضاً. إذ تمَّ تقويضُ وهدمُ الإمبراطوريةِ العثمانيةِ في هذه الأزمة، وأُنشِئَ عِوَضاً عنها عددٌ جمٌّ من الدُّوَيلاتِ القومية. فبينما انقسمَ العربُ إلى اثنَتَين وعشرين دُوَيلةٍ قومية، فقد أُبقِيَ في الأجندةِ أيضاً تَجَزُّؤُ الشعوبِ الدائمُ من خلالِ مئاتِ القبائلِ والمذاهب. وبينما التَهى الأتراكُ، الذين يُشَكِّلون النخبةَ المسيطرةَ في الإمبراطورية، بدُوَيلةٍ قوميةٍ في بلادِ الأناضول، فقد تُرِكَت عشراتُ الأقلياتِ التركيةِ والتركمانيةِ في البلقانِ والقفقاسِ والشرقِ الأوسطِ تُواجِه مصيرَها بمفردِها. كما اجتُثَّ الأرمنُ ورومُ الأناضول والسُّريان والبونتوسُ من أماكنهم بالتطهيرِ الأثنيّ، فباتوا وجهاً لوجهٍ أمام فُقدانِ ثقافاتِهم المُعَمِّرةِ آلافاً من السنين. أما وضعُ اليهودِ كشعبٍ ومن ناحيةِ موقِعِهم الدينيّ على السواء، فقد أدَّوا دورَهم في المنطقةِ كديناميةٍ مهمةٍ أخرى على صعيدِ السلطةِ والفوضى، وكأنهم بذلك يُحيُون تاريخَهم مُجَدَّداً. حيث أنّ عودَتَهم المتكاثفةَ للمنطقةِ خلالَ القرنَين الأخيرَين قد جَذَّرَت حالةَ الفوضى، باعتبارِهم قوةً إنشائيةً متقدمةً في الحداثةِ الرأسمالية.
تَقومُ الهيمنةُ الأيديولوجيةُ بتحريفِ حقائقِ الاستشراق. ففترةُ القرنَين الأخيرَين قد مَرَّت بغَزوِ الشرقِ الأوسطِ من طرفِ الحداثةِ الغربية. أما الدُّوَيلاتُ القومية، وصناعاتُ المونتاج، ومُخاتَلاتُ الاقتصادِ المُؤَمَّمِ الزائفة؛ فلا تستطيعُ طمسَ الحقيقةِ الأصل. فما حَلَّ بِصَدّام حُسين، الذي أَبدى الجرأةَ في التمردِ على أمرِ الغزوِ لَحظةً واحدة، لا يُمكنُ مقارنتها إلا بوضعِ لويس السادس عشر، مَلِك فرنسا. فكيفما أنّه بَعدَ قطعِ رأسِ مَلِكِ فرنسا، وَقَعَت أوروبا بين ألسنةِ النار؛ فإعدامُ صَدّام، مَلِك الدولةِ القومية، كان سيُفِيدُ –بل أَفادَ– باستِعارِ حقيقةِ الحربِ الساخنةِ التي لَم تَغِبْ أصلاً عن الشرقِ الأوسط، وبانتشارِها في أرجاءِ المنطقة، واكتسابِها السيرورة.
وإذ قمنا بتحليلِ وتفكيكِ البراديغما الاستشراقية، فسنلاحظُ أنّ انتهاءَ “الحربِ الباردةِ” مع انهيارِ النظامِ السوفييتيّ، يعني بالنسبةِ للشرقِ الأوسطِ انتقالَ الحربِ الساخنةِ إلى مرحلةٍ أعلى. وتَزَامُنُ حربِ الخليجِ الناشبةِ في 1991 مع مرورِ عامٍ على انتهاءِ الحربِ الباردة، إنما يُؤَيِّدُ مصداقيةَ هذا الرأي. وإذ ما نَظَرنا للأمرِ من زاويةٍ “طويلةِ المدى”، فسنَجِدُ أنّ حربَ الحداثةِ هذه ضد الشرقِ الأوسط، قد بَدَأت منذ أنْ وَطَأت قَدَما نابليون أرضَ مصر في مَطلعِ أعوام 1800؛ لتَصِلَ ذروَتَها مع ابتِكارِ الدُّوَيلاتِ القومية، وإنشاءِ الوَكالاتِ الرأسمالية، ونهبِ المواردِ الاقتصاديةِ– الجيولوجيةِ يتصدرُها النفط من قِبَلِ الصناعوية. هذا هو السردُ العامُّ للحداثةِ بخطوطِه العريضة. وما يتبقى هو محضُ تفاصيل وحكاياتٍ قصيرةٍ كثيرةِ الدوامات.
لماذا نظريّة الأمّة الديمقراطيّة هي الحلّ
نظريةُ الأمةِ الديمقراطيةِ هي العنصرُ الحلاّلُ الرئيسيُّ في العصرانيةِ الديمقراطية. ففيما عدا نظريةِ الأمةِ الديمقراطية، ما من نظريةٍ اجتماعيةٍ أخرى قادرةٍ على إعادةِ توحيدِ صفوفِ المجتمعِ البشريِّ العالميِّ وإحيائِه ضمن أجواءٍ مفعمةٍ بالحرية، بعدَما قَطَعَت نظريةُ الدولةِ القوميةِ للحداثةِ الرأسماليةِ أوصالَه كالقَصّاب. فالنظرياتُ الاجتماعيةُ الأخرى لا تستطيعُ من حيث معناها الذهاب أبعد من أداءِ دورٍ هامشيٍّ إزاء القضايا الراهنةِ العالقة. أما النظرياتُ الليبراليةُ الرأسماليةُ، فهي غيرُ قادرةٍ على فعلِ شيء، عدا مُداواةِ المريضِ بالسرطانِ البيولوجيِّ بإعطائِه أدويةً لإطالةِ عمرِه؛ بدلاً من حلِّ الأمراضِ المزمنةِ والسرطانيةِ التي سَلَّطَتها الرأسماليةُ على البشرية، وتأمينِ الشفاءِ العاجلِ للمجتمع. بمعنى آخر، فجميعُ الحلولِ التي تقترحُها تلك النظريات، تُفاقِمُ من القضايا وتُضَخِّمُها، وتُطيلُ من عمرِ الحداثةِ الرأسماليةِ أكثر. والمتغيراتُ الحاصلةُ في الشرقِ الأوسطِ خلال القرنِ الأخير، تؤكدُ صحةَ حُكمِنا هذا بأحسنِ صورة. فمجتمعُ الشرقِ الأوسط، الذي أنشأَ حياةً مؤطَّرةً بتكاملٍ ثقافيٍّ يمتدُّ على مدى التاريخ، بل يَعودُ إلى ما قبل عشراتِ آلافِ السنين؛ قد قُطِّعَت أوصالُه في غمارِ اللهيبِ الحارِّ للحربِ العالميةِ الأولى على يدِ قوى الحداثةِ الرأسماليةِ الأشبَه بالقَصّاب، لِيُترَكَ بعدَها لإنصافِ الوحوشِ المسماةِ بالدولِ القومية. وفعلاً، وباعتبارِ الدولِ القوميةِ أكثرَ الحالاتِ العينيةِ لـ اللوياثان الذي يَرِدُ ذِكرُه في الكتابِ المقدس، والذي يُطابَقُ بينه وبين الدولة؛ فإنها لَم تتخطَّ في دورِها إطارَ تمزيقِ وابتلاعِ الحقائقِ الاجتماعيةِ عن طريقِ ممارساتِ الكذبِ والرياءِ المسماةِ بالسياسةِ الداخليةِ والخارجية. أما الشيءُ الذي أَطلَقوا عليه اسمَ “المجتمعِ القوميِّ الحديث”، فما كان إلا تمديداً للثقافةِ المجتمعيةِ ذاتِ الزخمِ الكبيرِ من إرثِ التاريخِ المتكاملِ على طاولةِ عملياتِ الإبادةِ والإنكار، بعدَ تشريحِها وتقطيعِها إرباً إرباً. وهكذا اعتَبَروا أنفسَهم ناجحين بقدرِ ما قاموا بتقطيعِ وإنكارِ وإبادةِ التاريخِ والثقافةِ المجتمعية. بمعنى آخر، فالدولُ القوميةُ التي أدت دورَ القَصّابين المُستَخدَمين لدى الحداثةِ الرأسمالية، اعتَبَرَت نفسَها موفقةً وسعيدةً إزاء أسيادِها الجدد، توازياً مع نجاحِها في إنكارِ الماضي وإبادتِه، وإحلالِ العقلياتِ الاستشراقيةِ والمؤسساتِ العمليةِ للنظامِ القائمِ محلَّه. أما انقساماتُ الدولةِ القوميةِ خلال القرنِ الأخيرِ على صعيدِ ثقافةِ الشرقِ الأوسط، والممارساتُ المسماةُ بالسياسةِ الداخليةِ والخارجية؛ فهي عبارة عن حركاتِ إبادةٍ على وجهِ العموم. فما فُرِضَ عيشُه بدءاً من الذهنيةِ وحتى عالَمِ الاقتصاد، إنما هو تمزيقٌ للواقعِ المتكامل، ومَضغُه من قِبَلِ عناصرِ الحداثةِ الرأسماليةِ كي يغدوَ جاهزاً للبلع. والأحداثُ الجاريةُ في عراقِ اليومِ فحسب، عامرةٌ بالعِبَرِ والعِظاتِ المُثلى من أجلِ تقييمِنا للقرنِ الأخير.
نظريةُ الأمةِ الديمقراطيةِ تعني قبلَ كلِّ شيءٍ وقفَ حركةِ تمزيقِ الوحدةِ الثقافيةِ وتقطيعِها على نمطِ القصّاب، أي وقفَ الدولتيةِ القومية؛ والتخطيطَ للعالَمِ الذهنيِّ اللازمِ لعودةِ البدءِ بالوحدةِ المتكاملة. هذا وتُضفي نظريةُ الأمةِ الديمقراطيةِ قيمةً مبدئيةً على توحيدِ العالَمِ الثقافيِّ للشرقِ الأوسطِ تحت ظلٍّ مصطلحِ “اتحاد الأمم الديمقراطية”، وتُنيطُه بالأولوية. أي إنّ عالَمَنا الثقافيَّ المُنشَأَ على مرِّ عصورِ التاريخِ قاطبة، والذي يتميزُ بالتكاملِ والوحدةِ بكلِّ ما تشتملُ عليه من تنوعٍ وفير؛ يتحتمُ عليه رصُّ صفوفِه وتوحيدُها في كنفِ هذا المصطلحِ كبديلٍ للحداثةِ الرأسمالية. فلنُلقِ نظرةً خاطفةً على القرنِ الأخير: لقد تحوَّلَ المجرى صوبَ التمزقِ والانقسامِ المستمر. فالقومُ العربيُّ لَم ينقسمْ إلى اثنتَين وعشرين دولةً قوميةً فقط. بل وانقسمَ إلى مئاتِ العقلياتِ والتنظيماتِ والقبائلِ والمذاهبِ المتضادةِ والمتنافرةِ فيما بينها، والمتجسدةِ ميدانياً كدوَيلاتٍ قوميةٍ بدئية. وهذه هي غايةُ الفلسفةِ الليبراليةِ بالمعنى الاستعماريّ. فآفاقُ الفرديةِ الرأسماليةِ وقدُراتُها لانهائيةٌ في تذريرِ المجتمعِ وتشتيتِه. بناءً عليه، فنظريةُ الأمةِ الديمقراطيةِ تُعَبِّرُ عن التكاملِ المبدئيِّ الأساسيِّ على الدربِ المؤديةِ إلى إعادةِ تكريسِ الوحدةِ العامرةِ بروحِ الحريةِ والديمقراطية.
يرتأي مفهومَ الأمةِ التي لا تتميزُ بالحدودِ السياسيةِ الصارمة، والتي تُمَكِّنُ من إنشاءِ مجموعاتٍ وطنيةٍ عليا مؤطَّرةٍ باتحاداتٍ متنوعةٍ من مختلفِ الأممِ التي تقطنُ نفسَ الأماكن، بل ونفسَ المدنِ أيضاً. وبهذا المنوالِ تجعلُ المجموعاتِ الوطنيةَ الكبرى والمجموعاتِ والأقلياتِ الوطنيةَ الأصغرَ منها، والتي أُلِّبَت على بعضِها بعضاً، تجعلُها متساويةً وحرةً وديمقراطيةً تحت لواءِ الاتحاداتِ الوطنيةِ عينِها. وتطبيقُ هذا المبدأِ لوحدِه، يكفي لإفراغِ سياساتِ “فرِّقْ – تَسُدْ” و”اهرب أيها الأرنب، وأَمسكْ به يا كلبَ الصيد” التي يتَّبِعُها النظامُ المهيمن. إنّ القيمةَ الباعثةَ على السلامِ والحريةِ والمساواةِ والديمقراطيةِ ضمن هذا المبدأِ الثابت، تُبرهنُ بجوانبِها هذه لوحدِها دورَها الحلاّلَ المتفوقَ القادرَ على إفراغِ جميعِ الممارساتِ الحربيةِ والاستعباديةِ والطبقيةِ والاستبداديةِ الفاشيةِ للدولتيةِ القومية. إذ لا يُمكنُ وضعُ حدٍّ نهائيٍّ لقومويةِ الدولتيةِ القوميةِ الواحديةِ وذاتِ الفكرِ المطلق، إلا بوساطةِ ذهنيةِ الأمةِ الديمقراطية. إنها النظريةُ والمبدأُ الأنسب، ليس فقط من أجلِ الحدِّ من انقسامِ العربِ وتمزقِهم اللامتناهي، بل ومن أجلِ وقفِ انقسامِ الأتراكِ وتجزؤِهم اللامتناهي أيضاً. فما شهدَه العالَمُ التركيُّ في العديدِ من أصقاعِ المعمورةِ من البلقانِ إلى القوقاز، ومن آسيا الوسطى إلى الشرقِ الأوسط، وما عاناه من انقسامٍ وتشتتٍ وعبادةٍ عمياء لإلهِ الدولتيةِ القومية، وتكالبٍ على بعضِه بعضاً على خلفيةِ العقلياتِ الميتافيزيقيةِ والوضعيةِ الاستشراقية؛ كلُّ ذلك لا يُمكنُ تخطيه، وبالتالي إعادةِ لَمِّ أشلائِه ورصِّ صفوفِه ضمن إطارِ المبادئِ العامرةِ بالمساواةِ والحريةِ والديمقراطية؛ إلا من خلالِ نظريةِ الأمةِ الديمقراطية.
إنّ الدولتيةَ القوميةَ بالنسبةِ إلى بلدٍ قابلٍ للانقسامِ والتجزؤِ في كلِّ لحظة مثل إيران، أَقربُ ما تَكُونُ إلى قنبلةٍ ذَرّيةٍ مزروعةٍ في قاعِه. ومثلما أنّ القومويةَ الشيعية، التي تُزيدُ من تأجيجِ النزعاتِ الدولتيةِ القوميةِ دون انقطاع، غيرُ قادرةٍ على الحدِّ من انقسامِ إيران وتشتتِها؛ فإنها بالمقابل تُسَرِّعُ من وتيرةِ ذلك. بالتالي، فنظريةُ الأمةِ الديمقراطيةِ بالنسبةِ إلى إيران على وجهِ التخصيص، هي بمثابةِ الدواءِ الذي ينبغي تناوُلُه يومياً. والشعبُ الإيرانيُّ الذي لَطالما تصدى بثقافتِه العريقةِ للحداثةِ الرأسمالية، لا يُمكنُ الارتقاءُ به إلى العالَمِ العامرِ بالمساواةِ والحريةِ والديمقراطية، والذي اندفعَ وراءَه وتعطشَ له على مرِّ التاريخ؛ إلا بواسطةِ ذهنيةِ الأمةِ الديمقراطيةِ القادرةِ على تطهيرِ دربِه من المؤامراتِ والاغتيالاتِ الدولتيةِ القوميةِ المشحونةِ بالنزعةِ الاقتتاليةِ والحربية، وإيصالِه بالتالي إلى سلامٍ مُشَرِّفٍ راسخ.
الثورة الذهنية في الشرق الأوسط
توغَّلَت الحداثةُ الرأسماليةُ في الشرقِ الأوسطِ من خلالِ الذهنيةِ التسلطيةِ أولاً، مثلما فعلَت على الصعيدِ العالميِّ أيضاً. فهيمنةُ الذهنيةِ المسماةِ بالاستشراقيةِ تَعودُ بماضيها إلى ما قبل قرونٍ عدة. ولَربما امتدَّت بجذورِها إلى عهدِ التوسعِ الثقافيِّ الإغريقيِّ – الرومانيّ. فالحروبُ الصليبيةُ الدائرةُ في العصورِ الوسطى، غالباً ما كانت حروباً ذهنية. لكنّ الغزوَ الفكريَّ الأصلَ حصلَ مع صعودِ الحداثةِ الرأسمالية. هذا وينبغي عدم الإغفالِ بأنّ العاملَ الأساسيَّ الذي فتحَ الطريقَ أمام صعودِ وازدهارِ أوروبا الغربية، هو تفوُّقُها في وعيِ الحقيقة. ولتكييفِ الخبرةِ الشرقيةِ مع ظروفِها الملموسةِ نصيبُه المُعَيِّنُ في ذلك. وهكذا، فإنّ عصورَ النهضةِ والإصلاحِ والتنويرِ قد مَكَّنَت من تفوقِ وعيِ الحقيقةِ لدى أوروبا الغربيةِ على صعيدِ العالمِ أجمع. فبقدرِ ما حلَّلَت نفسَها، تمكَّنَت بالمِثلِ من تحليلِ العالمِ عموماً، والشرقِ الأوسطِ على وجهِ الخصوص. وقد جعلَت الرأسماليةُ وعيَ الحقيقةِ حِكراً عليها، مثلما تبنَّت واحتكرَت أيضاً العديدَ من التطوراتِ الإيجابيةِ حديثةِ العهد. وهكذا، كانت أوروبا قد بسطَت احتكارَها على وعيِ الحقيقةِ منذ زمنٍ طويلٍ مع حلولِ القرنِ التاسع عشر. هذا وحقَّقَت دخولَها إلى منطقةِ الشرقِ الأوسطِ مُسجّلةً التفوقَ نفسًه في وعيِ الحقيقة. حيث باشرَ المبعوثون قبل كلِّ شيءٍ بعودةِ اكتشافِ المنطقة. ثم تحوَّلَت طريقةُ تناوُلِ الكشّافةِ الرُّحّالينِ والباحثين العلميين للمنطقةِ وكيفيةُ فهمِهم إياها إلى مدرسةٍ فكريةٍ سُمِّيَت “الاستشراقية”. بمعنى آخر، فالاستشراقيةُ هي الهيمنةُ الذهنيةُ لمدنيةِ أوروبا الغربية. وهكذا، فَقَدَ الشرقُ استقلالَه الذهنيُّ تدريجياً اعتباراً من القرنِ التاسع عشر، نظراً لبسطِ نفوذِ الأفكارِ الاستشراقية. وانضوى المتنورون الشرقيون والنخبةُ النابغةُ منهم تحت لواءِ حاكميةِ الفكرِ الاستشراقيّ. ونجحَت جميعُ المشتقاتِ الفكريةِ المنبثقةِ عن الليبرالية، وعلى رأسِها القوموية، في الاستيلاءِ على الذهنيةِ الشرقية. بل حتى إنّ التيارَ الإسلامويَّ الجديدَ والحركاتِ الفكريةَ الدينيةَ الأخرى، قد تصاعدَت مركونةً إلى القوالبِ الاستشراقية.
إنّ حركاتِ الدولتيةِ القوميةِ المتناميةَ بالتزامنِ مع القرنِ العشرين، لَم تَكُ في مضمونِها سوى بمثابةِ مؤسساتٍ عميلةٍ للفكرِ الاستشراقيّ. أي إنّ مؤسِّسي الدولةِ القوميةِ لَم يَكونوا قطّ أصحابَ فكرٍ استقلاليٍّ على حدِّ ترويجِهم الدائمِ لذلك، وما كان لهم أنْ يَكُونوا كذلك البتة. فجميعُ الصياغاتِ الفكريةِ البارزةِ في الشرقِ الأوسطِ خلال القرنِ العشرين، بما فيها الفكرُ اليساريّ، كانت ممهورةً بطابعِ الاستشراقية. وبالرغمِ من إطلاقِ تسميةِ “الحقائقِ العلميةِ العالميةِ” على الأفكارِ التي جرى تكييفُها ومحاكاتُها لواقعِ المنطقةِ باسمِ علمِ الاجتماع، إلا إنّ جميعَها كانت استشراقيةً في مضمونِها. وبطبيعةِ الحال، تستقي الاستشراقيةُ قوتَها من دنوِّها إلى الحقيقةِ بنسبةٍ أكبر بكثيرٍ من القوالبِ الذهنيةِ القديمة. ونظراً لتدني مستوى الحقيقةِ ووهنِها ضمن أفكارِ ناقدي الاستشراقيةِ مقارنةً مع ما هو عليه لدى الاستشراقيين، فإنهم كانوا عاجزين عن إحرازِ النجاح. هذا وبالمقدورِ قولُ الأمرِ عينِه بشأنِ النخبِ السلطويةِ الاستشراقيةِ أيضاً، كـ”تركيا الفتاة” و”جمعيةِ الاتحاد والترقي” على سبيلِ المثال، والتي كانت تنتهلُ قوتَها من ذهنيتِها الاستشراقيةِ الأقوى والأوطد نسبةً إلى الذهنياتِ القديمة. وهذا الوضعُ هو الدافعُ الأوليُّ وراء خروجِهم بنجاحٍ موفقٍ من صراعِ السلطة، سواء في عهدِ المشروطيةِ أم الجمهورية. كما ويتعينُ المعرفةُ يقيناً أنّ الاستشراقيةَ الغربيةَ تُشَكِّلُ منبعَ القوةِ الكامنةِ خلف نزعةِ الجمهورياتيّةِ التركية. أما السببُ وراء قيامِ النخبِ السلطويةِ منذ أمَدٍ بعيدٍ بتحويلِ اتجاهِ قِبلَتِها من مكة إلى باريس، فكان النجاحَ والمتانةَ والاستقواءَ الذي حقَّقَه الفكرُ الاستشراقيُّ فيها. ومع تأسيسِ الدولةِ القومية، بلغَ الفكرُ الاستشراقيُّ أَوجَه، وبسطَ احتكارَه على كافةِ الذهنياتِ الأخرى. إذ لَم يَبسطُه في الحقلِ الأيديولوجيِّ وحسب، بل وفي المجالِ الفنيِّ أيضاً. كما وفكَّكَ أواصرَ الأخلاقِ التقليدية، ممهداً السبيلَ إلى سيادةِ القوالبِ الأخلاقيةِ الغربية.
اعتباراً من النصفِ الثاني من القرنِ العشرين، بدأَت الاحتكاراتُ الذهنيةُ تُصابُ بالتآكلِ والتعريةِ ضمن الشرقِ الأوسط، مثلما كانت عليه في عمومِ أرجاءِ العالَمِ أيضاً. فالثورةُ الثقافيةُ المندلعةُ في 1968، باشرَت بفتحِ ثغراتٍ في احتكاراتِ الاستشراقية. وقد كانت تلك الفترةُ سنواتٍ بدأَت الأيديولوجيا الليبراليةُ والعلمويةُ الوضعيةُ تفقدُ فيها تفوقَها. والانهيارُ المتسارعُ للاشتراكيةِ المشيدةِ في عامِ 1990، قد زادَ من زعزَعَةِ سيادةِ الفكرِ الوضعيِّ الليبراليّ. ونخصُّ بالذِّكرِ أنّ العلمويةَ الاجتماعيةَ أُصيبَت بجروحٍ غائرة. كما أُصيبَ الاحتكارُ الذهنيُّ للحداثةِ الرأسماليةِ لأولِ مرةٍ بتزعزعٍ جديّ، فظهرَت إلى الوسطِ العديدُ من التياراتِ المسماةِ بما وراء الحداثة. وتصاعدَت التياراتُ الفامينيةُ والأيكولوجيةُ والثقافيةُ والمدارسُ الفكريةُ اليساريةُ الجديدة. وهكذا جرَت المعاناةُ من الأزمةِ البنيويةِ المستفحلةِ في الرأسماليةِ خلال أعوامِ 1970، بالتزامنِ مع الأزمةِ الذهنيةِ التي كانت تتجذرُ باستمرارٍ مع مُضِيِّ الوقت. فانهارَ الاحتكارُ الفكريُّ القديمُ لدرجةٍ باتَت إعادةُ تأسيسِه أمراً مستحيلاً. ونالَت الاستشراقيةُ أيضاً نصيبَها من ذاك الانهيار، باعتبارِها نسخةً مشتقةً من الأيديولوجيا الليبرالية، فتبدَّدَت حاكميتُها الفكريةُ على الشرق. وقدَّمَ عددٌ كبيرٌ من المفكرين إسهاماتٍ ثمينةً للثورةِ الفكرية التي كشَفَت النقابَ عن دورِ الشرقِ الأوسطِ من جهةِ كونِها مهدَ نظامِ المدنيةِ المركزية، يتقدمُهم في هذا المضمارِ كلٌّ من جوردون تشايلد، صموئيل كريمر ، وآندريه غوندر فرانك. وهكذا، فقد تمَّ عيشُ نهضةً فكريةً بكلِّ معنى الكلمة، مع الاستمرارِ في بسطِ حدودِ الحداثةِ الرأسماليةِ وتطورِ الشرقِ ارتباطاً بنُظُمِ المدنيةِ المركزية. أما أفكارُنا بشأنِ السياسةِ الديمقراطيةِ والعصرانيةِ الديمقراطية، والتي سعينا إلى رسمِ ملامحِها وصياغتِها في المرافعاتِ على شكلِ حلقاتٍ تزدادُ اتساعاً وعُمقاً بنحوٍ طرديّ؛ فقد أضحَت مُتَمِّمةً لأفكارِ أولئك المفكرين، ولو عن دونِ قصد. وفيما يتعلقُ بالتقييماتِ والشروحِ التي تناولَت موضوعَ ولادةِ نظامِ المدنيةِ المركزية، ومدى تأثيرِه ودورِه في صعودِ الحداثةِ الرأسماليةِ داخل أوروبا الغربية؛ فقد كانت صحيحةً وصائبةً بخطوطِها العريضة.
كان التأثيرُ المشتركُ لكافةِ هذه العواملِ الفكريةِ الثوريةِ قد أفضى إلى ثورةٍ ذهنيةٍ متسارعةٍ في وجهِ الذهنيةِ الليبراليةِ والاستشراقيةِ بدءاً من تسعينياتِ القرنِ العشرين. وبالرغمِ من التأثيرِ المحدودِ لتلك الثوراتِ الذهنية، إلا إنّ ما طغى على مرافعاتي كان بمثابةِ تدوينٍ مستقلٍّ لثورةٍ فكريةٍ وتطورٍ فكريٍّ تدريجيٍّ في آنٍ معاً. تتسمُ بعظيمِ الأهميةِ الثورةُ الذهنيةُ التي تخطَّت الاستشراقيةَ وتخلصَت من تَبِعاتِ المذاهبِ المركزيةِ واليمينيةِ واليساريةِ اللّيبراليةِ على حدٍّ سواء ضمن منطقةِ الشرقِ الأوسط. هذا وينبغي عدم التغاضي إطلاقاً عن أنه يستحيلُ عيشُ أيةِ ثورةٍ مجتمعيةٍ راسخةٍ ودائمة، ما لَم تُعَشْ الثورةُ الذهنية. والصياغةُ التي تحتوي عليها المجلَّداتُ الخمسةُ الأخيرةُ من مرافعاتي، تبسطُ للعيانِ مَرامَنا من مصطلحِ الثورةِ الذهنيةِ في الشرقِ الأوسطِ بخطوطِه العريضة. يتعينُ عليَّ التشديدُ على أهميةِ سكبِ ذلك في الممارسةِ العملية، عوضاً عن تكرارِ التنويهِ به. فأثمنُ الأفكار، أي تلك التي نصيبُها من الحقيقةِ جدُّ وطيد، لن تُعَبِّرَ عن أيِّ شيء، ما لَم تُطَبَّقْ عملياً. وحتى لو اتّحدَ العالَمُ كلُّه وأجمعَ على فكرةٍ خاطئةٍ أو نصيبُها من الحقيقةِ واهن، فإنّ شخصاً واحداً فقط قادرٌ على الوقوفِ في وجهِ العالَمِ برمتِه، والدفاعِ بنجاحٍ موفقٍ عن فكرةٍ نصيبُها من الحقيقةِ أرقى، وإحرازِ نصرِها المؤزرِ في نهايةِ المطاف، حتى ولو التَزَمَ بها لوحدِه دوناً عن غيرِه. والتاريخُ البشريُّ مليءٌ بالأمثلةِ على ذلك. وما يؤدي إلى ذلك هو قوةُ الحقائقِ الغالبةُ دوماً. قد تُقمَعُ الأفكارُ المُعَبِّرةُ عن الحقيقة، وقد تُجازى؛ ولكنها لن تُهزَمَ أبداً.
كنتُ، أو كنا قد باشَرنا بالممارسةِ العمليةِ محَصَّنين بأفكارٍ نصيبُها من الحقيقةِ كان جدَّ محدودٍ في بادئِ الأمر. وبتصعيدِ الممارسةِ العمليةِ بصدقٍ وإخلاص، ضاعَفنا من نسبةِ الحقيقةِ في الأفكار. ومع الانكبابِ على الممارسةِ العمليةِ مُحَصَّنين بالأفكارِ التي تضاعفَت نسبةُ الحقيقةِ فيها، بات لا مفرّ من خوضِ ممارساتٍ عمليةٍ أكثر توفيقاً. النتيجةُ الأوليةُ التي ينبغي استنباطُها من هنا، هو أنّ الحقائقَ الكبرى وما تَنُمُّ عنه من ممارساتٍ ميدانيةٍ عظيمة، قد تبدأُ بكلمةٍ واحدةٍ فقط إذ ما تَطَلَّبَ الأمر. ففي حالِ الالتزامِ بالكلمةِ بصدقٍ وإخلاص، وعدمِ التخلي عن جهودِ توحيدِها مع الحياة؛ يغدو لا ملاذ من تعاظُمِ الحقيقةِ وتقديمِها نفسَها وكأنها انتصارٌ للحياةِ الحرةِ داخل المجتمع. فالمجتمعاتُ ظواهرٌ عطشى للحقيقة، كما التربةُ الظمأى للماء. وبإرواءِ ظَمَأِها ذاك، تتعرفُ المجتمعاتُ على الحياةِ الحرةِ والديمقراطيةِ كما التربةُ المزدهرة.
نجحَت الحداثةُ الرأسماليةُ عن طريقِ مؤسساتِ الجامعةِ المواليةِ للعلمانيةِ في كسرِ شوكةِ السيادةِ الذهنيةِ التي أمسَكَت الكنيسةُ بزمامِها طيلةَ العصورِ الوسطى. وجعلَت الإنجازاتِ العلميةَ والفلسفيةَ والفنيةَ التي أسفرَ عنها عصرُ النهضةِ والإصلاحِ والتنويرِ حِكراً عليها بوساطةِ الاحتكارِ الذي طالَ الجامعاتِ عموماً. وبهذا المعنى، يُعَدُّ القرنُ التاسع عشر قرناً حَسَمَت فيه الرأسماليةُ حاكميتَها على العلمِ والفلسفةِ والفن. وفي أواخرِ القرنِ العشرين، برزَت الأزمةُ وتَبَدّت الحلولُ ضمن هذه الحاكميةِ التي دامَت قرابةَ قرنَين من الزمن، وذلك بما يتماشى مع الأزمةِ والحلولِ الموجودةِ في البنيةِ العامةِ للنظامِ القائم. حيث كانت الفلسفةُ قد فقدَت أهميتَها القديمةَ حيالَ التقنياتِ العلميةِ المُختَبَرة، وتحوَّلَ العلمُ بذاتِ نفسِه إلى تقنياتِ بحوثٍ لا عدَّ لها ولا حصر، في حين خَسِرَ الفنُّ قيمتَه كمدرسةٍ قائمةٍ بذاتِها بعدَ العصرِ الكلاسيكيّ، فاختُزِلَ إلى سلعةٍ فظةٍ متجسدةٍ في هيئةِ صناعةٍ متكدسة. وفي المحصلة، فجميعُها كانت قد تحوَّلَت إلى أدواتٍ منفعيةٍ بسيطةٍ بِيَدِ الرأسماليةِ والدولتيةِ القوميةِ والصناعوية. وهكذا كانت فقدَت جميعُها مهاراتِها في البحثِ عن الحقيقةِ والتعبيرِ عنها من حيث كونِها تُشَكِّلُ وظيفتَها الأساسية. والمقصودُ من أزمةِ العلمِ والفلسفةِ والفنّ، كان خسارةَ تلك المهاراتِ في البحثِ عن الحقيقةِ والتعبيرِ عنها.
كانت منطقةُ الشرقِ الأوسطِ قد شهدَت سياقاً مماثلاً خلال القرنِ الثاني عشر، عندما بسطَت دوغمائيةُ المدرسةِ الإسلاميةِ نفوذَها في وجهِ الفلسفةِ والعلمِ والفنّ. والأزمةُ التي تغلغلَت داخلَ العلمِ والفلسفةِ والفنِّ في أوروبا، قد وجدَت معناها مع تردّي مكانةِ الاستشراقيةِ وتراجُعِ شأنِها في الشرقِ الأوسط. وكان هذا تطوراً إيجابياً بجانبِه هذا، إلا إنه كان يحتوي على المخاطر، لعجزِه عن إنجازِ ثورةٍ ذهنيةٍ بديلة. حيث لَم تُعَشْ ثورةٌ ذهنيةٌ جذريةٌ في المنطقة، بالرغمِ من ظهورِ بعضِ التطوراتِ المحدودةِ إزاء ذهنيةِ الغربِ المهيمنةِ وطرازِه في الفنِّ والحياة. بل استمرّت الأزمةُ في هذه الساحةِ أيضاً، مثلما الحالُ في بقيةِ الساحات. كان بإمكانِ الشرقِ الأوسطِ تحويلُ المخاطرِ الناجمةِ عن تلك الأزمةِ إلى فرصةٍ سانحة. وفي سبيلِ ذلك، كان بمقدورِه إنجازُ الثورةِ الفلسفيةِ والعلميةِ والفنيةِ المنسجمةِ مع أسسِه التاريخيةِ والثقافية، والتي تُشَكِّلُ مصدرَ إلهامٍ وتوجيهٍ لمقوماتِ العصرانيةِ الديمقراطية، أي للأمةِ الديمقراطيةِ واقتصادِ السوقِ الكموموناليِّ والصناعةِ الأيكولوجية. وبمعنى آخر، كان بوسعِه تحقيقُ وإحياءُ عصورِ النهضةِ والإصلاحِ والتنويرِ بمنوالٍ متداخلٍ وكثيف، وبطرازٍ ثوريّ. ولا داعي البتة لتقليدِ الغربِ أو محاكاتِه في هذا المضمار. فإلى جانبِ مشاطرتِه المكاسبَ العالمية، إلا إنّ المهمَّ هنا هو عرضُ خلاّقيتِه المكانيةِ والتاريخية، وإنجازُ ثورتِه الذاتية.
ولِحُسنِ حظِّ الثورةِ الكردستانيةِ المُطَوَّرةِ بما يتلاءمُ مع نظريةِ ومصطلحاتِ العصرانيةِ الديمقراطية، هو كونُها تتحققُ في عهدِ الأزمةِ التي تعاني منها الحداثةُ الرأسماليةُ في الذهنيةِ وطرازِ الحياة. فالقِسمُ الأكبرُ من ثوراتِ القرنَين التاسع عشر والعشرين، وعلى رأسِها الثورتان الفرنسيةُ والروسية، كانت ثوراتٍ عاجزةً عن تخطي ذهنيةِ الحداثةِ الرأسماليةِ وطرازِ حياتِها. وكانت نجاحاتُها محدودة، رغمَ جهودِها الدؤوبةِ والأصيلةِ وطموحاتِها في أنْ تَكُونَ البديل. ما من ريبٍ في أنها كانت تركَت وراءها إرثاً زخماً ومكاسب ذهنيةً نصيبُها من الحقيقةِ عالٍ ولا تزالُ تنضحُ بالحياة، وقِيَمَ حياةٍ أخلاقيةٍ وجمالية. وعليه، بمقدورِ الثورةِ الكردستانيةِ الاستفادةُ من حُسنِ طالِعِها هذا على أكملِ وجه، بتوحيدِها كلَّ هذه المنجَزاتِ الذهنيةِ والحياتيةِ الثمينة، ومُلاحَمتِها في ممارستِها العمليةِ الخاصةِ بها. كما وباستطاعتِها إحياءُ الفردِ الديمقراطيِّ والاشتراكيّ، الذي سوف يُنجَزُ بتحويلِ الإنشاءِ المتداخلِ لكلٍّ من الأمةِ الديمقراطيةِ والاقتصادِ الكوموناليِّ والصناعةِ الأيكولوجيةِ إلى طرازِ حياةٍ اجتماعية؛ وذلك حيالَ فرديةِ الحداثةِ الرأسماليةِ المشحونةِ بالمصائدِ والأفخاخ، والتي صارَت وحشاً استهلاكياً طائشاً يَبتلعُ الحقيقة؛ وكذلك حيالَ عناصرِها المتمثلةِ في نزعاتِ الربحِ الأعظميِّ والدولتيةِ القوميةِ والصناعوية، والتي تُوَلِّدُ الفرديةَ وتنتجُها. وبوسعِها تعميقُ ثورتِها الذهنيةِ والأخلاقيةِ والجماليةِ بكلِّ ما أُوتِيَت من طاقة، بحيث تجعلُها مُلكاً للفرد، وتعمِّمُها بذلك على شعوبِ الشرقِ الأوسطِ قاطبة. هذا وبإمكانِها عبرَ ثورتِها الخاصةِ بها تقديمُ الإسهاماتِ المهمةَ للثقافةِ التاريخيةِ الشرقِ أوسطيةِ المتميزةِ دائماً بالتكاملِ والكونية، وتقييمُ الحياةِ نفسِها وكلِّ مجالٍ من مجالاتِها على أنه مدرسةٌ ناجعةٌ في سبيلِ إنجازِ ذلك. هذا ويكمنُ حُسنُ طالعِ الشعوبِ والأفرادِ الذين فقدوا كلَّ ما لديهم، في تَمَثُّلِهم القيمَ الثوريةَ والحَيَواتِ العامرةَ بالحريةِ والأخلاقِ والجمال، وفي تَبَنّيهم إياها وكأنهم عطشى لها. فلتَكُنْ الحداثةُ الرأسمالية، ولكنْ بشرطِ ألا تُلَوِّثَنا بقَيئِها وتَفَرُّثِها. ولِحُسنِ الحظِّ أنهم لَم يتلطخوا بها، أو نادراً ما تلطخوا. والأبهى والأروعُ من هذا وذاك، هو تشاطُرُ قِيمِ العصرانيةِ الديمقراطيةِ المتناسبةِ مع طبيعتِنا الاجتماعيةِ وأنشطتِنا الفردية، وتشاطُرُ الأمةِ الديمقراطيةِ وطرازِ الحياةِ الاقتصاديةِ الكوموناليةِ والأيكولوجية، وتشاطُرُ عِلمِها وفلسفتِها وفنِّها بروحٍ مفعمةٍ بالحريةِ والمساواةِ والديمقراطية؛ وجعلُ كلِّ ذلك مُلكاً للمجتمع.