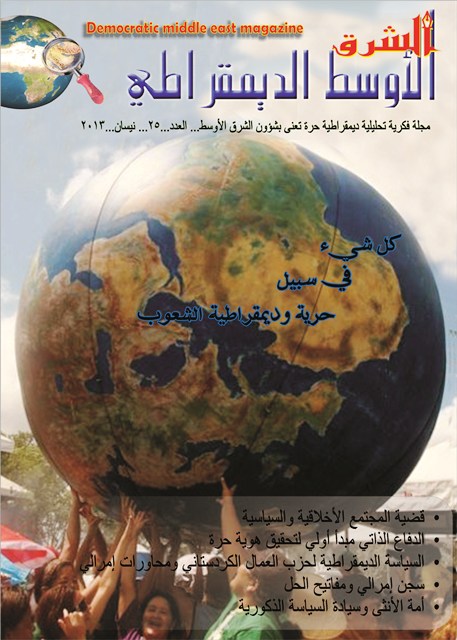المثقف بين سندان التحديات ومطرقة الرغبة في البناء
عبد الرحمن حمادة

عبد الرحمن حمادة
تعتبر الثقافة العصب الناظم لحياتنا والدافع لكلّ تطوير وتقدّم في جميع المجالات الحيوية التي نتطلّع إليها وذلك لارتباط نوع الحياة بمستوى الوعي ومستوى الثقافة والمؤثر الأول الذي يحلّل ويفكّك تلك المشكلات، والمعني بها هو المثقف وهذا الفعل يعدّ جزءاً من مسؤوليته، وبذلك يجدّ المثقف نفسه ملزماً بإعطاء جزء من وقته وجهده للاهتمام بشؤون مجتمعه لفحص المفاهيم ونقدها، وتصحيح ما يمكن تصحيحه، منها بواسطة الكتابة أو التحاور وإيجاد الأفكار والحلول أو المحاولة في إيجادها .
إنّ المثقف ليس مفهوماً علمياً لذلك فإنّ تعريف المثقف يختلف عند الكثير من الناس، وقد يتفق عليه اتفاقاً حيث أنّه مفهوم حديث كانت بدايته في القرن التاسع عشر، ولو كان له في اللغة العربية وجوداً ولكنه لا يحيط بهذا المفهوم من جانب الاصطلاح، فكلمة مثقف باللغة العربية تأتي بمعنى امسك وعلم وثقف متعلم ولامع وهناك تفسير للكلمة بمعنى حاد ومبري وشاطر وكلها تقترب بشكل أو آخر وتعطي كل هذه التفسيرات مساحة كبيرة للتصور ولذلك تمت ترجمته عن الفرنسية انتلكتشون وباللغة الروسية انتلجسيا وهي طبقة من الناس التي تعمل من فكرها وبجهدها في القضايا العامة .
وبدأت هذه الحركة فيما يعرف بقضية الدفاع عن داريغوس 1890م عندما وقع مجموعة من المثقفين بياناً ضد السامية وضد فبركة الأدلة لإدانة داريغوس الضابط اليهودي المتهم بالخيانة ونشر في الصحف بصفتهم مثقفين وليس بصفتهم سياسيين أو غير ذلك .
وهذه الظاهرة الجديدة هي التي تبنت فكرة النقد في السياسة والحياة والمفاهيم العقلية التراثي السائدة في ذلك الوقت كما أنّها قامت بالتنظير للحركات الثورية وتغيير الأنظمة كما حصل في أوروبا، مثال ذلك الثورة الروسية رغم أن ماركس نسب قوى التغيير إلى طبقة الكادحين والعمال ولكن الحقيقة أنهم كانوا أدوات لها وكان المثقفين هم من وقف ورائها وذلك بسبب وجود مجموعات كثيرة من الخريجين الجدد من الجامعات الحديثة والذين لم يجدو لهم عملاً وارتبطوا بذلك بالحركات الثورية المعادية للمجتمع التقليدي الذي حكم عليهم بالبطالة ولم يعطيهم فرص للعمل وليس هناك تعميماً دقيقاً بهذا الخصوص إنما هو ما حصل غالباً ويجب التفريق بين المثقف وبين المختص فالمختص يجب عليه أن يعرف كل شيء عن شيء واحد ولا يشترط بالمثقف ذلك حيث أنه يكتفي أن يعرف عن كل شيء مقدار من المعلومات تؤهله فهمها وخاصة في العلوم الاجتماعية والسياسية والفلسفية والآداب.
كما يجب على المثقف أن تكون لديه قدرة على استشراف المستقبل، وتوقع مجربات الأمور من خلال ربط المقدمات بالنتائج، وبذلك يستطيع التأثير في الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
وتوجيه الرأي العام إلى برّ الأمان والعمل على تقديم المشورة لأصحاب القرار للوصول إلى أفضل النتائج، وهذا المستوى لم نصل إليه إلى اليوم في شرقنا البائس، لأنّ غالبية الأنظمة تتعامل مع المثقف على أساس أنّه عدو لها، وليس جزءاً من النظام الاجتماعي، وفي هذا الاعتبار ظلم للناس وظلم للمثقف الذي يمنع من تقديم رؤيته أو العمل بها، والسبب باعتقادي: “إنّ السياسة في الشرق قاطبة مبنية على فكر ميكيافيلي منتج منذ القرن الرابع عشر من خلال ذلك الكتاب الملعون (الأمير) الذي صدر عام /1532/ ميلادية، والذي أهداه إلى أمير فلورنسا الإيطالية من أسرة آميدشي والذي يحتوي على نظرية (اليد القذرة والقفاز النظيف) ولا تجد إلى اليوم حاكماً ديكتاتوراً في هذا الشرق إلا ويحتفظ بنسخة من هذا الكتاب.
فالمعرفة تكتسب بالخبرة المتراكمة لا بالنفاذ إلى حقيقة خارجية ما، وليس بالكشف الروحاني الصوفي، وجاء بعد ذلك نيوتن الذي قال بنظرية الضوء ووفر الاستعارات القوية في التغيير المقاس بدقة وقد تم في ذلك العصر رفع مستوى الحريات الفكرية لأعلى المستويات .
وازدهر الجدل الحر والتنافس في مجالات العلوم بكل أشكالها من فلك ورياضيات وفيزياء وفلسفة واختراعات، وظل شرقنا في الظل ليكمل ما ينوف عن ألف عام من العلم الكاذب والعناية بالخرافة والتأليف في علوم لا تلزم ولا تمت للتقدم بصلة في ظل تراجع للشعر العربي والعلوم والفلسفة الذين كان آخرهم ابن رشد الذي أحرقت كتبه، وكان مهدداً بالقتل، وهناك الكثير من تم قتلهم أو حرقهم لمجرد الخلاف في النظر بالمسائل العامة والحلاج والسهروردي والجعد بن درهم ومن تم تكفيرهم وإخراجهم من المعادلة مثل المعري وابن سينا وابن الرواندي والقائمة تشير إلى أحداث أثرت ولا تزال تؤثر على نوعية المنتج العقلي العربي والشرقي عموماً (الإسلامي) حيث أنّ طريقة التفكير بقيت ضمن القوالب التقليدية الكلاسيكية في دائرة تبدأ من حيث تنتهي وتنتهي من حيث تبدأ لتعيد إنتاج نفس الأفكار والرؤى بشكل ثابت ضمن زمن متحرك متغير ولم تنمُ إلى الخط العمودي التصاعدي الذي يحتوي المتغيرات الفكرية عبر الزمن، ويتجدّد معها في كل دورة منتجاً آلاف الدورات التي تراكم المعرفة، وتقوم على إنتاج العلوم، وبذلك كان لا بدّ من الاستيراد لعدم وفرة المنتج الفكري المحلّي.
ولأنّ العقل ينمو بالفضول، وطرح الاسئلة الدائمة كان الدور الأول للمثقف الذي يبحث بلا هوادة عن الأجوبة لأسئلة العقل المتعطش للمعرفة والفهم والاستقراء والاستنباط، ولأن هناك ثقافة مختلفة مع الشعوب التي تقدمت بمعارفها صار هذا المثقف يبحث عن المشتركات التي من خلالها التقدم إلى الأمام وقدم في ذلك جهداً لا يستهان به لشرح الفلسفات والنظريات والمراجع المهمة إلا أنّها ظلّت في إطارها المدرسي، ولم تنزل إلى الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وهنا يحضرني قول المفكر والفيلسوف – روجر بيكون الذي عاش بحدود القرن الرابع عشر وأعتقد أنه قريب فرنسيس بيكون المعروف حيث يقول: إنّ للمعرفة موانع، ويجب القضاء عليها للوصول إلى المعرفة ومن هذه الموانع :
1- رواسب الجهل العقل الخرافي
2- قوة العادة وقد أوصى بالابتعاد عن نقد الدين خلال التعامل مه هذه الموانع، إنما شجع بقية العلوم مثل الرياضيات والعلوم الطبيعية حرصاً منه على عدم الاصطدام مع الكنسية التي كانت تحكم الفضاء العام وكسبها بقصد تشكيل قاعدة اجتماعية لمنهجه .
هناك الكتب التي ألّفها المعتزلة بتشجيع من الخليفة المأمون، والكتب التي ألفها أخوان الصفا وخلان الوفا وهم قوم من الفرقة الاسماعيلية، ما تمت ترجمته من اليونانية والسريانية والصابئة، وبعض سكان شعوب الشرق من الحواضر القديمة قام مجموعة من الفقهاء في عهد المتوكل العباسي بإلغائها من المكتبات وطمس معالمها إمّا بالحرق أو بالإتلاف؛ لأنّ الخليفة أمر بوضع منهج جديد يقوم على التشدد وعدم التسامح الديني والفكري.
ليس لأنه متدين، لكن لتوطيد دعائم حكمه بقبضة من حديد تسكت كل العقول وتمتثل لقول الفقهاء ومن أبرزهم الإمام الغزالي والشافعي وتلميذه ابن القيم الجوزية، وكان له ما أراد ولأنّ الحاكم يستطيع فرض رؤيته بالقوة، لذا كان قول الناس على دين ملوكها، وهذه حقيقة لا مراء فيها.
وخير مثال في يومنا الحاضر ما جرى في السعودية من انفتاح اجتماعي، وبعد عن التشدد ونسف بعض المفاهيم التقليديّة، وإلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحبس مجموعة من الدعاة المتشددين.
إنّ دور المثقف في هذه الحالة هو البحث المستمر والإشارة إلى مواطن الخلل وشق تلك الحجب السميكة، وإنتاج قرار قابل للتطبيق، ومزاحمة اليقينيات البائسة، والإيمان بأنّ الإنسان قادر على خلق وصناعة واقعه والعيش بحرية وسلام ورفاهية وعدالة، وأية مفاهيم لا تدخل إلى المختبر، ولا تستطيع تغيير الواقع المأساوي لإنسان هذه المنطقة هي مفاهيم غير فاعلة، لذا يتوجب اعتبارها تراثاً مهملاً، وهذا يضعنا على أول الطريق لتغيير هذا الواقع، والعمل على سد الثغرات التي يعاني منها المجتمع، والتي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين وتطوير التعليم والعمل بكل أشكاله وتحليلاته سياسياً واقتصادياً واجتماعياً أما على المستوى الفردي فيجب عدم التعرض لإيمان الاشخاص مهما كان، فالإنسان حر فيما يعتقد ويؤمن، شرط أن يكون مسالماً وألّا يلزم الآخرين بالقوة والإكراه باعتقاده .
أسباب التراجع الثقافي :
من أهم أسباب التراجع الثقافي في مجتمعاتنا هو :
1- ضعف التعليم الذي يعتبر أحد أهم الوسائل لتنمية العقول، ورفدها بالثقافة والمعرفة، وهو يعاني من مشاكل كبيرة، حيث أن مناهجنا كلاسيكية تعتمد على الحفظ، وليس على الفهم وتعتمد على الاختبار والامتحان وليس على التحدي والإبداع وهذه الطرق تؤدي إلى كره الطالب العلم والدراسة، لأنه مجبر طيلة فترة الدراسة على تكرار الأسلوب ذاته، أضف إلى ذلك أنّ الكثير من الطلاب يتسرّبون من الدراسة في نهاية المرحلة الأساسية، وبداية المرحلة الثانوية لبلوغهم سن المراهقة، والتغييرات التي تطرأ على أجسامهم ونفوسهم، والتي لا تأخذ فيها العملية التعليمية ولا تهتم لأمرها، ومن أكمل منهم وتحصل على شهادة الثانوية والتعليم الجامعي فهو في أحسن الحالات يحصل على عمل متواضع براتب لا يكفيه معيشته، فتجد أن من تعلموا مهنة بسيطة يجنون دخلاً أضعاف دخله فيشعر بالإحباط ويصبح متخبطاً بين حاجاته المادية وتطلعاته الاجتماعية والنفسية ساخطاً ولا أقصد هنا التعميم ولكن أشير إلى النسبة الغالبة .
2- غياب البحث العلمي على مستوى الجامعات، حيث أن اقتصادات العالم الحديث ربطت منذ عشرات السنين بين الاستراتيجيات الاقتصادية والبحث العلمي فبدأت توجه الشركات القادرة على تبنّي مشاريع أبحاث في جميع المجالات الزراعية والصناعية والدوائية والتقنية وعند نجاح هذه الأبحاث يكون لهذه الشركة الداعمة نصيب مستمر من الإنتاج وقد وجدت في بعض المراجع أنّ أهمّ أسباب نجاح بعض الدول مثل اليابان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها أنها تضع خططاً استراتيجية في مجال من المجالات، وتقوم بتوجيه التعليم إلى هذا المجال وتقوم بتغيير المناهج ووضع خطط ضخمة بميزانيات ضخمة لتحقيق هذا الهدف بينما نقوم نحن بوضع مناهج وخطط تنموية استراتيجية عامة تشمل كل شيء زراعة صناعة سياحة ونفشل لأن الجهد غير مركز وغير مدعوم بالطريقة السليمة .
3- سوق العمل والنظرية والتطبيق : الخريج من مدارسنا وجامعاتنا يخرج إلى سوق العمل لا يجد شيئاً مما تعلمه على أرض الواقع، إما لأن المناهج قديمة أو أن هناك فارق في المستوى ويبدأ من جديد بتعلم مهنة المفترض أنه أضاع فيها سنوات من عمره ويجد الفرق واضحاً بين النظرية والتطبيق أضف إلى ذلك عياب المؤتمرات العلمية وورشات البحث والتطوير التي يجب أن ترافق الخريج حتى تقاعده ترفده بكل الدراسات الحديثة والأساليب المبتكرة والبحوث النوعية .
4- التحولات الاجتماعية والسياسية الكبرى :
إنّ التحولات الكبرى التي جرت وتجري من حولنا رغم أنها نتاج طبيعي ولكنها تذهل العقل وتغير وجه العالم حيث أن ايديولوجيات كبيرة قامت وسادت وبادت ونحن في موقعنا ننظر فقط فالرأسمالية والعولمة والليبرالية وما بعد الحداثة في الغرب مفاهيم غيرت مجتمعات كثيرة وكبيرة نتيجة الوعي الثقافي والاجتماعي ولا يزال البحث عن أفكار جديدة لتطوير حياة هذه المجتمعات وتحسينها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً .
رغم ما فيها من آلام ولادة وموت وهذه التحولات تنتج على المدى المتوسط والبعيد تقدماً كبيراً فهي ترتقي بالواقع المعاش إلى نتائج ومستويات جديدة من المعرفة والسعادة، وفي النهاية يجب علينا الاعتراف بأنّ مستقبل الجنس البشريّ هو القضاء على الهويات الفردية الضعيفة والمتخلفة المستقلة، لأن هناك حضارة أكبر لها قوة الصهر والإذابة والواجب علينا المساهمة في هذا التيار المتصاعد كي لا نبقى خارج التاريخ نستهلك ولا ننتج ونقاد ولا نقود، ولسنا قادرين على مقاومة الفعل الحضاري المتقدم .
إنّ تطوير الذات والمجتمعات لا يأتي بالأماني وكلما كان المجتمع غارقاً في المشاكل كان أحوج ما يكون إلى المثقف صاحب الرؤية المبدع الخلاق لأنّه مسؤول عن وعي الناس حيث أنّ المعرفة مسؤولة، وأنّ المعارضة واجب على كل مثقف عندما يرى أن فيها مصلحة لبلده وتتجلى في اتجاهين؛ فالأول رقابي على السلطة ومؤسساتها وتقييم عملها ومساعدتها في تصويب سياساتها، والثاني شعبي تنويري لرفع مستوى التفكير والمعرفة وتحسين الذوق العام إما بنتاجه الفكري أو بسلوكه الاجتماعي وطريقه تعاطيه مع مفردات الحياة بكلّ تفاصيلها فيكون قدوة يتطلع المجتمع لتقليده والاقتراب من سلوكه، وبذلك يحدث التأثير فهو يرفض فقر الناس وبؤسهم ويرفض السكوت عندما يسكت الآخرين. ولا يحق له الملل من المحاولات أو التراجع، لأنه لا يحل محله في حال ذلك إلى الجهل والخوف والقهر وهذا أسوأ ما تعانيه البشرية.
إنّ على أفراد السلطة مهما كان تسميتها أن تقوم بالضبط والإدارة وتقويم كل معوج وهذا دورها الحميد.
كما أنّها يجب أن تخضع لرقابة المجتمع ممثلاً بمؤسساته، وبالمجتمع المدني والهيئات والنخب الثقافية لإعطاهم الفرصة في تصويب سياساتها، ومن واجب هذه الهيئات والأفراد والنخب البحث المتواصل عن مواطن الضعف في الإدارة والإشارة إليها، والعمل المتواصل على إلزامها بالقوانين وممارسة الديمقراطية، وحماية الرأي والمعتقد وحماية الأقليات والفئات الأكثر حاجة، مثل الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الهمم والمساواة بين أفراد المجتمع في الفرص والالتزام بحرية الفرد.
هذه بعض المسؤوليات المناطة بالمثقف وليس تسلية المجتمع عن المصائب والسكوت، وترسيخ حالة التخلف واعتبار ذلك قدراً لا يمكن تغييره، إنّ الطاعة العمياء مذمومة وهي تؤدي إلى عبودية الأفراد والمجتمعات خاصة بأن بعض الأفكار تزين هذه العبودية وتلبسها ثوب المقدس وذلك فقط لمصلحة الحاكم الذي يرى نفسه ظل الله على الأرض ويوظف النصوص الدينية وبعض المشتغلين بها لكسب معيشتهم والإثراء من خلال الدين وتقاسم السلطة معه، والذين يقنعون العامة البسطاء بأنّ هذا الحاكم قدرهم ولا يملك هذا القدر إلى الله، وإنّ هذا الاعتقاد، وإن جاء بلبوس ديني يستسلم له العامة، لذا وجب على المتنورين أن يشقو هذه الحجب ويكشفوا الزيف والافتراء، فنحن شعوب تستحق الحرية وتستحق التقدم ولسنا متخلفون بيولوجياً، وإنّ الزمن في حالة تسارع فما أنتجه الإنسان خلال المائة عام الأخيرة يمثل أكثر مما أنتجته البشرية منذ خلقت وإلى اليوم ويجب علينا الاستفادة من هذه الثورة العلمية والتقنية والاقتصادية بدل التحسر والنظر إلى بقية العالم وهو يشق عباب السماء ويقيم مشاريعه على الكواكب البعيدة ونحن ما زلنا نحلم بالتغيير ولا نستيقظ كي نحقق ما نحلم به .
ولا سبيل لذلك دون المعرفة والثقافة والعلم لا يمكن لمجتمع أن يكون سوياً إذا لم تكن ظروفه سوية أو على الأقل في حالة نمو ولو كان بطيئاً .
الحضارة تصنعها النخبة وهذه النخبة من العقلاء واجبها تعرية المفاهيم الخاطئة والإشارة إليها بإلحاح تمهيداً لتغييرها ويجب على العامة أن تكون رافعة اجتماعية لهذه النخبة تتبنى أفكارها وتأخذ بها وتترجمها إلى أفعال وسلوك وتفرضها من خلال المؤسسات وتحولها إلى قرارات للصالح العام .
لكن المشكلة عندنا بأن التفكير والثقافة والمعرفة ليست أولويات إنما الأولويات عند الغالبية هي الاستهلاك والظرف العام يشجع على هذا السلوك حيث تفتقد للمراكز الثقافية الفاعلة وقاعات الموسيقا والمسارح والصالونات الأدبية وهذه جميعها تعتبر من أهم محركات التقدم والتقدم لا يأتي هبة من السماء فحيث لا يوجد مقدمات لن نرى نتائج والحصول على التقدم الفكري والثقافي والاجتماعي يستلزم زراعة المعرفة التي تكون بذرتها العقل وثمرتها التكنولوجيا والتقدم ولو افترضنا أن ابن خلدون عاد اليوم إلى الحياة في عصرنا هذا لما انبهر في شيئ وكأنه تركنا منذ أيام لأن مفرداتنا العقلية وخلافاتنا وحروبنا هي نفسها منذ أكثر من ألف عام .
بل نحن حريصون أشد الحرص على البقاء نراوح مكاننا ونجلد ذاتنا جلداً مبرحاً إذا رأينا ملمحاً للتقدم والخروج من الدائرة التي تعيد إنتاج نفس المنتج حرفياً، نستبعد المثقف الذي يقوم اجتماعياً مقام الطبيب القادر على تشخيص المرض الاجتماعي ووصف العلاج المناسب له والذي سقط أيضاً من اهتمام المؤسسات السياسية دعمه والاهتمام بما يقول وكل يغني على ليلاه .
صناعة العنف في غياب التنوير :
إننا محكومون بالنجاح رغماً عنا وأن جميع المفردات الحضارية التي يستخدمها العالم من حولنا معطلة وأننا واقعين بين سندان التحديات ومطرقة الرغبة في البناء لذا وجب علينا الاعتراف بمشاكلنا أولاً والتي تمثل مرحلة التشخيص للمرض والبحث عن أفضل طرق العلاج .
وأن لا نخاف من التفكير ونعتبره نوعاً من الوسوسة التي تستلزم العلاج وأن نخاف من جهلنا الذي اعتدنا مفرداته أن الحياة للعمل وليست للراحة ومن أهم ضرورات العمل العلم ومن أهم مفردات وأدوات العلم العقل وأهم منتجات العقل الثقافة.